فى كتابى الجديد “كيف تكتب قصة قصيرة أو رواية.. منهج الكتابة الإبداعية”، أوردت شهادة عن الكتابة تقول:
الكتابةُ، ليس لها دربٌ معبَّدٌ، وكل طُرقِها مسكونةٌ باستغاثات الجنِّ، وسكاكين أبناء القبيلةِ، ونميمتهم، ودسائسهم.
تتطاير فيها الحجارةُ، والأذى.
لكن، حين تصل إلى البستان، فهُناك ستعثر على فاكهة
ليست كأى فاكهة!
صور أولى
انتبهتُ لما حولى، طفل لعائلة متوسطة الحال، مكوّنة من أب وأم وابنة واحدة وثلاثة أولاد. كان ترتيبى الثانى بعد أختى. أعبئ عينى وقلبى بما يحيط بى فى بيت صغير فى أحد أحياء الكويت القديمة “شرق”.
أول الصور حضوراً فى صندوق ذاكرة طفولتى، أتخيلها وشىء من ضباب يكللها، هى صور لعبى مع الأطفال أمام باب البيت، لكن الصور المرسومة بخطوط دقيقة وواضحة، هى خطوات المشى إلى المدرسة، بإلزامٍ لا يحتمل التأجيل أو التملّص عند أبى، حتى فى حالات المرض.
اقرأ أيضاً | مريم الساعدى.. مرآتى أو طريقى الطويل والمكرر إلىَّ
تخفّ خطواتى أثناء عودتى إلى البيت، وتتلاعب أطياف الفرح البرىء فى صدرى، وأنا أتخيل مواعيد اللعب الزاهية التى تنتظرنى وأقرانى للعب فى “البراحة” الترابية المزروعة بأصواتنا ومشاحناتنا، التى تنتهى بمغيب الشمس، واسمرار رقعة السماء، وارتفاع صوت المؤذن.

وركضنا أنا وأخاى: عيسى وهاشم إلى المسجد، فأبى “سيد محمود سيد عيسى الرفاعى” الرجل المتدين وإمام المسجد، ما كان يغفر لنا لحظة ينتهى من صلاة المغرب، ويتلفت فلا يجدنا ضمن المصلين. وتلبس الليلة ثوباً أسود كريهاً حين نتغيب عن الصلاة بسبب لهونا ولعبنا مع الأطفال.
يأتى أبى إلى البيت من المسجد محتقناً بغضبه، فيضربنا، ولا يتورع أن يمسّ شىء من ضربه أمى، إن هى حاولت حمايتنا. وكم دار ببالى السؤال دون أن أجرؤ على قذفه على أبى:
هل تعلّم الصلاة يأتى عبر الضرب؟
متعة مغايرة
طويلة هى أشهر الصيف فى الكويت. تبدأ مع أيام شهر أبريل، وتبلغ الحرارة قمتها مع شهرى يوليو وأغسطس، حين تتعدى درجات الحرارة الـ50 درجة “سيلسيوس” فى مناطق الظل، وتهدأ قليلاً فى شهرى سبتمبر وأكتوبر. ولأن الحى الذى تربّيت فيه يقع فى منطقة “شرق” على ساحل البحر، فلقد كانت السباحة وصيد السمك هى المتعة الأجمل لنا نحن الأطفال، يليها صيد أو “حَبَلَ” الطيور فى مقبرة “هلال”، ولعبة “المقصي” و”صاده ما صاده”، و”الدوامات”، وكرة القدم.
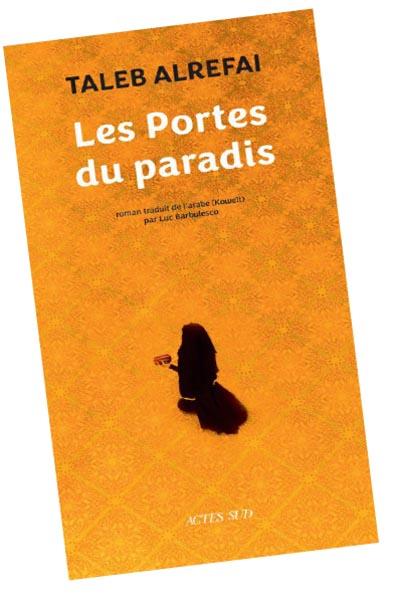
عالم أسرتى ببيتنا الصغير، وطريقى إلى مدرستى ذهاباً وإياباً مشياً على الأقدام مع أبناء الحى، وتوزعى بين لعب الكرة فى البراحة، أو السباحة فى البحر، تلك كانت حدود عالمى المسالم، ولم يكن يدر فى خلدى أن هناك متعاً أخرى، أو عوالم أبعد مسافةً مما نحيا فيه، أنا وأهلى وأصدقائى.
أول لقاء بينى وبين القراءة الأدبية كان من خلال رواية “الأم” لمكسيم جوركى، الصادرة عن دار “التقدم” فى موسكو، ترجمة سامى الدروبى، عام 1972، وقتها كنت فى الصف الرابع المتوسط، بعمر يقارب الثانية عشرة.
ما كنت أظن أن لقائى بالقراءة، سيكون المنعطف الأهم فى حياتى، فكيف لوعى ولد صغير، أن يستوعب أن بمقدرة صفحات كتاب أن تحمل إنساناً وتطير به إلى سماوات لم يكن يحلم يوماً بالوصول إليها. سحرتنى رواية “الأم”، انتزعت منى نبض قلبى. لهوت بها وغبت عن أهلى ومدرستى وأصدقائى ولعبى على شاطئ البحر. احتضنتها إلى صدرى، وخلال يومين أنهيت قراءتها، ولحظتها تفتحت دنيا أخرى أمامى، لاح لى، أنا ابن الثانية عشرة، ما يشبه رسماً لعوالم ملوّنة. ولأول مرة استشعرت متعةً جديدة ومختلفة عن المتع التى أعرف، متعة تندس تحت جلدى فيقشعر لها نبض قلبى.
سرقتنى القراءة من أى لعب أو لهو، حملتنى على بساطها السحرى إلى بقاع ونواح بعيدة، وعرفتنى على حيوات وأناس كثر، لم أكن أحلم بالوصول إليهم، والاطلاع على خبايا وأسرار حيواتهم. وتالياً أدركت تجلى تجربة الشاعر العربى الأبقى، أبا الطيب المتنبى وهو يُنشد:
أعزُّ مكانٍ فى الدنى سرجُ سابحٍ وخيرُ جليسٍ فى الزمانٍ كتابُ

بفضل مجموعة أصدقاء ذوى توجه إنسانى، كانوا يؤمنون بالحرية والديمقراطية والمساواة وحرية المرأة والعدالة والسلام، ويؤمنون أيضاً بقدرة الأدب والفن والمثاقفة على تشكيل وعى الإنسان. وربما لأن أحداً منهم، توسّم فىَّ شيئاً من موهبة، رتّبوا لى قراءات روائية، بدأت بأعلام الرواية الروسية، ثم انتقلوا بى إلى دول أوروبا وتحديداً إنكلترا وفرنسا، وعبروا بى لاحقاً إلى المحيط الأطلسى وصولاً إلى كتّاب قارة أمريكا، ثم عادوا بى لأغطس فى بحر الرواية العربية.
صادقت الكتاب، وصارت قراءة الرواية الكلاسيكية والقصة القصيرة والشعر الحديث والفلسفة هى نافذتى الأوسع على العالم، ودخلت السينما إلى حياتى بوصفها سحر الظلمة الأجمل. كنت أقرأ بمعدل ثمانى ساعات فى اليوم، وفى أيام العطل، يرتفع ذاك المعدل إلى أكثر من ذلك. زرت مدينة “بطرسبورج” مع رواية “الأم”، وتعرفت على إنجلترا بـ”قصة مدينتين”، وسهرت أعانى برد باريس القارس مع “الأب غوريو”، وعايشت حرب الشمال والجنوب الأمريكى مع “عناقيد الغضب”، واكتشفتُ بحراً يختلف عن شاطئ بحرنا الصافى فى رواية “الشيخ والبحر”، وبعد هذا عشت بين ناس القاهرة، واستوطنت بيوتها فى ثلاثية نجيب محفوظ، وعرفت “شرق المتوسط” مع عبدالرحمن منيف، وتعرفت على عوالم الشام بكتابات حنا مينا، ودخلت البيوت العراقية مع فؤاد التكرلى بـ”الرجع البعيد”، ورواية جبرا إبراهيم جبرا “صيادون فى شارع ضيق”، ومن خلال عيون الطيب صالح عرفت “مواسم الهجرة إلى الشمال” وعايشت جنوب البصرة مع رواية إسماعيل فهد إسماعيل “كانت السماء زرقاء”، ورأيت معاناة الفلسطينى بقصص غسان كنفانى.
عام 1976/1977 حصلتُ على شهادة الدراسة الثانوية العامة، بمجموع عالٍ يتيح لى دخول أى كلية فى جامعة الكويت، يومها تهلل وجه والدتى يرحمها الله، قالت وهى تشرقُ بسرورِها، ويندّى دمعُ الفرحِ عينيها: “مبروك يا ولدى”.
بينما ظل أبى، يرحمه الله، بهدوئه، سألنى: “ماذا بعد شهادتك الثانوية؟”
قلت:”سأكمل دراستى الجامعية.”
لسبب ما نظر إلىَّ أبى بنظرة لم أفهمها. هزَّ رأسه ودعا لى بودٍّ ظاهر: “الله يوفقك”.
وكأنه يهجس بأنه سينتقل إلى دار ربه قبل أن أتخرج من الجامعة، بينما دنت أمى منى، وكان فرحٌ أخضر، يشبه زقزقة عصافير شجرة “سدرة” بيتنا، يرسم تقاسيم وجهها المحِب، سألتنى بحنو امرأة أكل تعبُ الانتظارِ رونقَ شبابِها: “هل ستعمل معلم مدرسة؟”.
“كلا يا أمى، سأدرس الهندسة، وأكون مهندساً”.
شعرت بها، ترى أن وظيفة المعلم أهمّ من شغل المهندس. لكنها بحس الأم المرهف، وبتوقع العاشق، لا تريد أن تبدد فرحة ولدها وتكسر بخاطره، قالت: “سأكون أم المهندس”.
طربت روحى لجملتها، بسمتُ لها، فشعّت عيناها بالزغاريد، قلت لها: “نعم، ستكونين أم المهندس”.
وأوضح لها، وقد انتقل إلىَّ ريحٌ عطرٌ من فرحِها: “وظيفة المهندس جيدة، وراتبه الشهرى أكثر”.
طوّق حنان ولين الرضا وجهها الأحب.
النشر الأول.. طُعم الغواية
بتاريخ 17 يناير عام 1978، نشرت أول قصة قصيرة فى جريدة “الوطن” الكويتية، بعنوان “إن شاء الله سليمة”، نشر تلك القصة كان بمنزلة طُعم الغواية الذى انسقت وراءه.
طُعمٌ مغرٍ يصوّر لروح كاتب شاب الحلم الأجمل بامتلاك الشهرة وإعجاب الفتيات والقدرة على تغيير العالم. بقيت منساقاً وراء ذلك الحلم الوردى حتى العام 1992، حين نشرت فى بيروت مجموعتى القصصية الأولى “أبو عجاج طال عمرك”، وما بين نشر القصة الأولى، ونشر المجموعة الأولى، بقيت مسكوناً بحلم كتابة نصٍ/ قصة قصيرة يفصح عن بعض ما فى القلب، وتكون لكلماته القدرة على مقاربة ملمس اللحظة الإنسانية الراعفة، وأن يأتى ذلك بثوب فنى، يحمل من السحر ما يجعل القارئ يتعلقه ويعلق به.
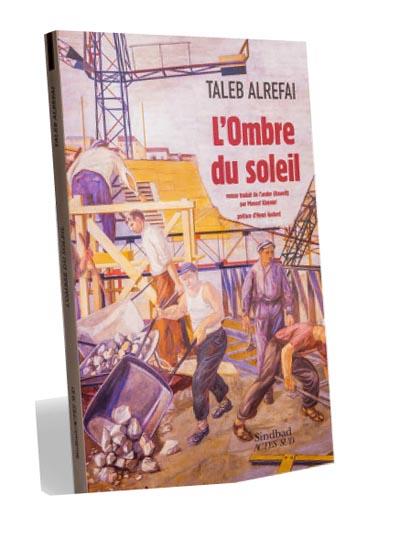
بالنظر إلى طبيعة وانفتاح المجتمع الكويتى، فلقد نشأتُ وتربيت فى بيئة اجتماعية وإنسانية متنوعة ومتسامحة يتجاور فيها الكويتى مع العربى مع الأجنبى، السنى مع الشيعى مع المسيحى. درست فى المراحل الدراسية على يد مدرسين عرب وكويتيين، وفى الجامعة قابلت وصادقت مدرسين أجانب من مختلف دول العالم، وربما اختيارى لدراسة الهندسة المدنية، ومن ثم عملى فى المواقع الإنشائية وسط جيش من العمال العرب والأجانب بألوان سحنهم ورطاناتهم، قد كرّسا قبولى ومحبتى وتشربى بحضور الآخر إلى جانبى، وارتباط مصيرى بمصيره.
واظبت على كتابة القصة، حتى نشرت فى القاهرة روايتى الأولى «ظل الشمس» عام 1998، وكانت انعطافة كبيرة على درب ولعى بالكتابة. فـ”ظل الشمس” وعلى لسان راويها، تقدم تجربتى الحية والمؤلمة مع العمل والعمال فى المشاريع الإنشائية، وتعرى حياة وشقاء العمالة الوافدة، العربية والأجنبية، فى الكويت، وتكشف معاناتها ومواجعها وموتها، وفى جانب موازٍ منها، تلقى بالضوء على شخصية وسيرة طالب الرفاعى باسمه ومسلكه الصريحين، كأحد أبطالها، وفق مدرسة “التخييل الذاتى-Auto Fiction”.
كتابة رواية، خلق لحياة مخبّأة
أرى فى الرواية تجربة حياة مُتخيَّلة تُضاف إلى حياة الكاتب والقارئ. حياة تتيح لكليهما خوض مغامرة دون مخاطرة. فالحياة الواقعية المحكومة بقوانينها القاسية تحتم علينا دفع مقابل لعيش لحظات تجاربها، وأحياناً بأثمان باهظة وقاصمة للظهر والقلب والفكر. ووحده الفن، يهبنا فرصةَ ولذةَ معايشة خبرات حيوات كثيرة دون ثمن، سوى سرقتنا من دوائر بيئاتنا الضيقة، والدخول بنا إلى دهاليز حيوات الآخر، أينما كان، وكيفما كانت تجربة حياته.
إن أعداد العمالة الوافدة، بمختلف مستوياتها العلمية والعملية، العربية والأجنبية فى المجتمع الكويتى، ربما تعادل عدد أفراد الشعب الكويتى، وهذه حالة لا تنطبق على المجتمع الكويتى وحده، ولكنها ظاهرة تسم المجتمعات الخليجية بميسمها، وبنسب متفاوتة. لذا فإن عدداً كبيراً من قصصى القصيرة وأعمالى الروائية كان الآخر/الوافد موضوعاً لها، وكانت هى صوتاً ووجهاً له. ويتجلى ذلك فى رواية “ظل الشمس” التى تحكى قصة مدرّس مصرى جاء إلى الكويت بحلم الغنى، وآل به الحلم إلى السجن.
المبدع العربى
المبدع العربى يعيش يومه مُنسحقاً راكضاً وراء لقمة عيشه وأسرته. فكيف له أن يكتب، وهو مُستنفَذ ما بين الخامسة والخامسة؟ كيف له أن يكتب، وهو مُبعثَر بين حياته فى مستواها الإنسانى، وبين رغبته الجامحة فى أن يكون كاتباً؟ كيف له أن يكتب، وفقاعة الحرية التى تحيط به، لا تكاد تحتمل نفساً؟ كيف له أن يكتب، والسجن والنفى والقتل ينتظره على بعد حرف؟ أى سؤال مربك ذاك: “متى تقرأ؟ ومتى تكتب؟ ومن أين تأتى بلحظة الخلوة؟”.
أى قدرة خارقة يجب أن يتمتع بها الكاتب العربى، كى يقدم فناً إنسانياً مبدعاً، فى ظل ظروف لا إنسانية؟ أى تضحية باهظة الثمن يحتاجها كى يخطّ قصته أو روايته أو ديوان شعره؟ المبدع العربى يعيش معذباً، يحلم بنصٍ يكتبه، ويموت وهو يحلم بذاك النص الممتنع، النص الحلم.
عاشق بين حبيبتين
حين عايشت كتابة الرواية ذاقت روحى حلاوتها، لكن شيئاً ظل يلكز خاصرتى، بعشقى الأول لكتابة القصة القصيرة. وكم زاحمت قصة قصيرة طريق رواية أكتبها، وبشوق العاشق، وفى كل مرة، أترك الرواية وأسير فاتحاً ذراعى قلبى للقصة. فالقصة نفخة روح لا تحتمل التأجيل، والرواية عيش حياة تتطلب من صاحبها النظر فيما خلف الفعل الإنسانى. وكم رددت مع نفسى: ما ضرَّ أن أكون عاشق بين حبيبتين، حتى وأنا أدرك مزاجية القصة وعصبيتها وغيرتها القاتلة.
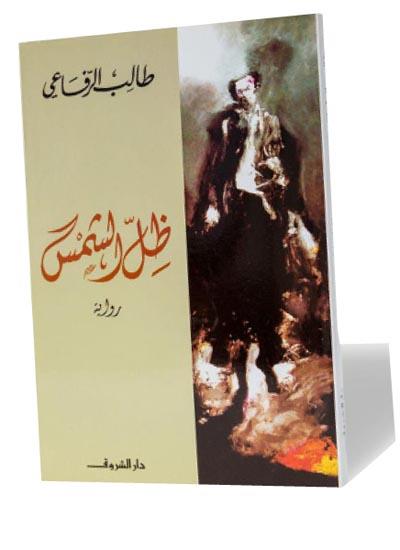
قرأت ما قرأت وكنت ولم أزل مأخوذاً بسر الدهشة. كتبت قصصى القصيرة ورواياتى مسكوناً بسحر الفن. كتبت قصصى القصيرة بمحابات أمى ودموعها، وعذاباتها، وسط وعورة دروب صبرها، وخوفها وكدرها، ولحظات فرحها القليلة. ولهذا فكل أعمالى مسكونة بحضور المرأة وعذاباتها فى مجتمع رجالى قاسٍ وغير عادل. كتبت قصصى ورواياتى بأفراحى وانكساراتى، وكنت هناك، حاضراً فى كل حرفٍ وفاصلةٍ ونقطةٍ وحلم وخيال.
كتبت قصصى ورواياتى مختلساً النظر لوجوه وهمسات وخطو من عبروا على درب عمرى. قارئاً فى حوائط وأبواب وأصوات وروائح الأماكن التى عشتها وعاشتنى. كتبت قصصى ورواياتى وفيها من الواقع بقدر ما فيها من الخيال الفنى.
ماذا أريد من الكتابة، وماذا تريد منى؟:
ماذا أريد من الكتابة؟ وماذا تريد منى؟” سألت نفسى، وها أنا بعد ما يزيد على العقود الأربعة أجيب:
أريد من الكتابة كل شىء ولا شىء”.
وأسمعها تقول بصوت عالٍ: “أريدك كلك حتى آخر رمق فى عمرك”.
أريد من الكتابة أن تمنحنى القدرة على تقبّل ومعايشة وتغيير الواقع الذى أحيا. وأن تخصّنى بلحظة هدوء أتمناها.
أريد من الكتابة أن تقلب هذا العالم القبيح ليصبح كما أشتهى. وأن تقتص من كل ظالم.
أريد من الكتابة أن تنقل صرختى حتى آخر الدنيا. وأن تكون شمساً أخرى ملونة بألوان الطيف، تبسم كل صباح مبشرة بالحب والخير والعدل والسلام.
أريد من الكتابة أن تنتقل بى من كائن يمشى على الأرض، إلى آخر يحلّق واثقاً فوق السحاب.
وفى كل ليلة، وقبل أن أنام أردد بينى وبين نفسى:
الكتابة حيلتى الوحيدة، كى أحيا يومى بأقل الخسائر. وربما وحدها صارت تمكننى من العيش بأمان، فى ظل عالم متوحش، أخشى من مواجهة غده إلا بالكتابة الإنسانية الخيّرة.
















