إسراء النمر
فى أثناء اطلاعى على أوراق بهاء طاهر، من دفاتر ومسودات لمقالات وشذرات كتبها بخط يده، لم تغادرنى العبارة التى وصفه بها يوسف إدريس «كاتب لا يستعير أصابع غيره» فالطريقة التى كان يتعامل بها مع الكتابة من حرصٍ ودقة وتأنٍ، توحى بذلك، فهو لم يكن من الكُتَّاب الذين يقضون حياتهم بأسرها فى الكتابة، لأنها لا تمثل عنده غير رغبة صادقة وحقيقية، ولا يُمكن أن يُخطط لها أو يُتخذ قراراً بالبدء فيها، فقد كانت تمر عليه سنوات طويلة دون أن يكتب فيها حرفًا واحدًا، وقد كان بالطبع يشعر بالأسى حيال ذلك، لكن ما بيده -أو أصابعه- حيلة، فهو لا يعرف كيف يستطيع كاتب أن يكتب شعرً ا أو قصة أو رواية بلا انقطاع أو توقف.
يعترف فى كتابه «السيرة فى المنفى» قائلًا: «إنه من الأمور المستحيلة علىَّ، من كانوا يفعلون هذا هم قلة نادرة فريدة، ولا أظنُّ أنِّى نادر أو فريد. من فعلوا هذا عبقريات قلَّما يجود بمثلها الزمن، دينو بوتزاتى أو يوسف إدريس، أو هیمنجواى مثلًا، أما أمثال دوستويفسكى فى الرواية أو المتنبى فى الشعر، فلا يُمكن أن يُقاس عليهم من الأساس».
لم يكن بهاء طاهر يرى إذن فى الغزارة أية قيمة، إنما فى الصوت المتفرد، والقدرة على قول شىء لا يقوله غيرك، لهذا لم يكن يخجل من أنه كاتب مُقل، ولم يكن يفتخر بذلك فى الوقت نفسه.
نعود للأوراق التى خصَّتنا بها عائلته، والتى كانت أغلبها مقالات كتبها بهاء طاهر على فترات زمنية متباعدة، يتضح ذلك من خطه الذى يختلف من مقالة لأخرى، فهناك مقالات كُتبت بأصابع شابة، لا اعوجاج فى خطها، ولا مفردات مُبهمة، كأنها كُتبت على الآلة الكاتبة، ففى هذه المقالات نادرًا ما كان يُضيف بهاء مفردة أو عبارة، ونادرًا أيضًا ما كان يشطب، أو يُخطئ فى كتابة كلمة أو فى إعرابها، فبدا السرد فى هذه المقالات متدفقًا كالنهر، كأن أحدًا يُملى عليه ما يجب قوله.
كُتبت المقالات فى الغالب دفقة واحدة، فكانت هناك حالة من الثبات فى شكل الخط، وفى نوع القلم المستخدم، وهو القلم الرصاص، إذ لم أواجه أية صعوبة فى القراءة، فالمفردات كلها كُتبت بعناية، كأن بهاء كان يرسم، لا يكتب، أو كأن ذهنه لم يكن قد تعكر بعد، مثل مقالة: «أربعون عامًا من الخطوبة»، الوحيدة التى ذيّلّها بتاريخ كتابتها (يونيو 2004)، والتى يقدم فيها كلمته «عن التاريخ.. عن الأحلام»، ويوجهها لمن يعنيه أمرهما ليقرأها قبل المجموعة القصصية أو بعدها أو كما يشاء.
أما المقالات الأخرى والتى كُتبت بالقلم الجاف، فقد كتبها بهاء طاهر فى مرحلة متأخرة من عمره، يتجلى ذلك فى الخط المنكسر والمتململ والمكتوب على عجل، كأن هناك من يركض وراءه أو كأنه يئس من الأوضاع التى لا تتغير، مثل المقالة التى عنونها بـ«مجرد شهادة»، ومقالة «سؤال الحرية».
نستطيع من خلال هذه الأوراق أن نتعرف على رؤى بهاء طاهر فى الأدب والسياسة والتاريخ، وأن نتعرف على المناخ الذى تفتح فيه وعيه، وكيف كان يتفاعل ويشتبك معه.
أربعون عامًا من الخطوبة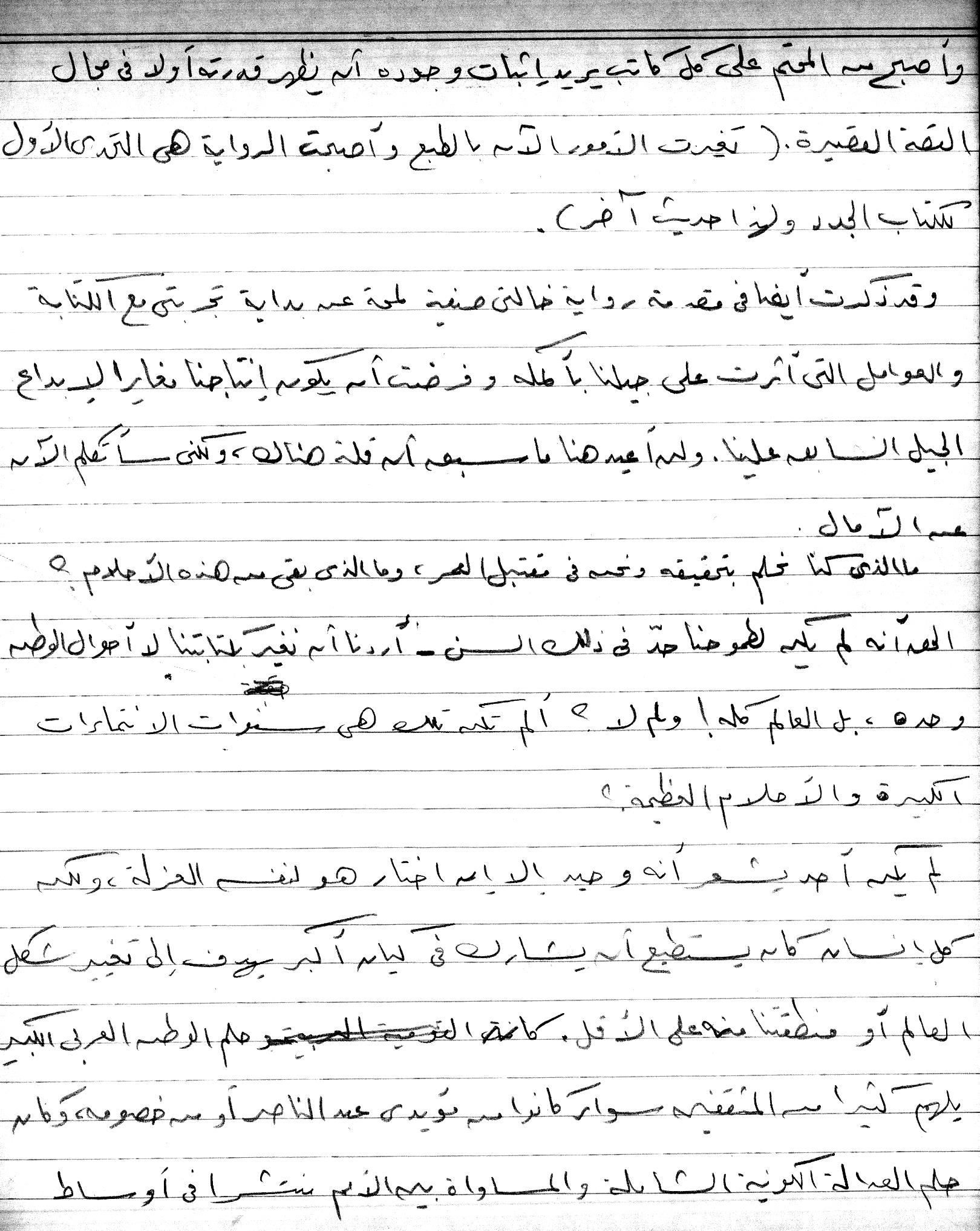
نبدأ بمقالة «أربعون عامًا من الخطوبة»، و«الخطوبة» هى أول عمل قصصى لبهاء طاهر، نُشرت أول قصة منها فى عدد مارس 1964 من مجلة «الكاتب» الشهرية، ثم توالى النشر حسب التواريخ المذيلة بها القصص حتى مطلع السبعينيات، أما المجموعة نفسها فلم تظهر طبعتها الأولى إلا فى عام 1972، وسبق أن ذكر بهاء طاهر فى مقدمة روايته «خالتى صفية والدير» أن نشر قصة قصيرة واحدة كان إنجازًا صعبًا بالنسبة لجيله، فما بالك بنشر كتاب؟ فرغم أن ظروف نشر الكتب ما زالت متعسرة، ولكن على أيامه كانت أشدَّ صعوبة، إذ كانوا محرومين من تعدد دور النشر وتعدد فرصه داخل مصر وخارجها، وكان عليهم فى 90% من الأحوال أن يصارعوا ضد بيروقراطية ورقابة دار النشر الحكومية الوحيدة (دار الكاتب العربى).
على الرغم من هذا، يرى بهاء طاهر أن سنوات الستينيات كانت عصرًا ذهبيًا للقصة القصيرة، وأكبر الفضل فى ذلك يرجع فى رأيه إلى الدفعة الهائلة التى حققها عملاق هذا الفن يوسف إدريس منذ الخمسينيات، والتى جعلت من القصة القصيرة فنًا شعبيًا مقروءًا على نطاق واسع فى الصحف الأدبية والعادية على السواء. فقد أصبح من المحتم وقتها على كل كاتب يريد إثبات وجوده أن يُظهِر قدرته أولًا فى مجال القصة القصيرة.
يتساءل فى مقالته: «ما الذى كنا نحلم بتحقيقه ونحن فى مقتبل العمر، وما الذى بقى من هذه الأحلام؟ الحق أنه لم يكن لطموحنا حد فى هذه السن. أردنا أن نغير بكتابتنا لا أحوال الوطن وحده، بل العالم كله! ولِمَ لا؟ ألم تكن تلك هى سنوات الانتماءات الكبيرة والأحلام العظيمة؟».
ثم يُجيب: «لم يكن أحد يشعر أنه وحيد إلا إن اختار هو لنفسه العزلة، ولكن كل إنسان كان يستطيع أن يشارك فى كيان أكبر يهدف إلى تغيير شكل العالم أو منطقتنا منه على الأقل. كان حلم الوطن العربى الكبير يلهم كثيرًا من المثقفين سواء كانوا من مؤيدى عبد الناصر أو من خصومه، وكان حلم العدالة الكونية الشاملة والمساواة بين الأمم منتشرًا فى أوساط الماركسيين والحركات اليسارية القوية فى تلك الفترة. بل إن الفكر الوجودى عالى الصوت فى الخمسينيات والستينيات كان ينادى -رغم توجهه للفرد- بالالتزام بقيم إنسانية عامة فى مواجهة القهر والظلم (ألم يكن سارتر عرَّاب هذه الفلسفة يقود المظاهرات فى باريس ضد احتلال وطنه للجزائر؟)».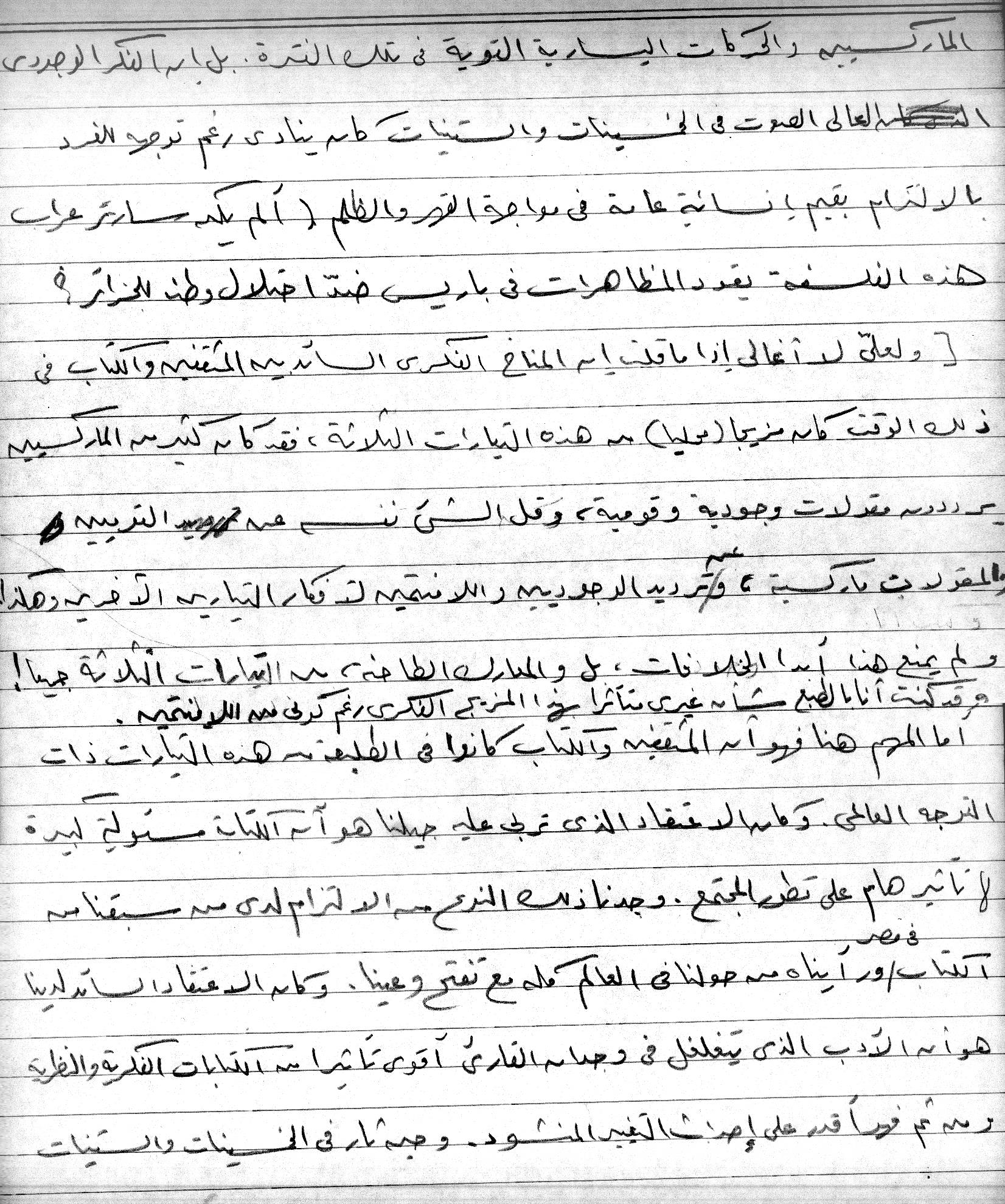
كان المناخ الفكرى السائد بين المثقفين والكُتَّاب فى ذلك الوقت مزيجًا محليًا من هذه التيارات الثلاثة، فقد كان كثير من الماركسيين يرددون مقولات وجودية وقومية، وكان بهاء طاهر شأن غيره متأثرًا بهذا المزيج الفكرى رغم كونه وقتها –حسب اعترافه- من اللامنتمين، فقد كان الاعتقاد الذى تربَّى عليه جيل الستينيات هو أن الكتابة مسئولية كبيرة لها تأثير مهم على تطور المجتمع، وأن الأدب الذى يتغلغل فى وجدان القارئ أقوى تأثيرًا من الكتابات الفكرية والنظرية، ومن ثم فهو أقدر على إحداث التغيير المنشود. وحين ثار فى الخمسينيات والستينيات جدل نقدى فى مصر حول فكرة الفن للفن أم الفن للمجتمع، انحازت الغالبية العظمى من المبدعين للخيار الثانى فى هذا الجدل، الذى كان نوعًا من التبسيط البالغ لصراع عميق فى المجتمع حينها بين القوى المحافظة، أو الرجعية، وبين تيار تقدمى كاسح يريد التغيير نحو الأفضل.
يقول بهاء طاهر: «يعرف الجميع ما انتهى إليه ذلك الصراع وكيف تراجع التيار التقدمى من الصدارة إلى الهامش. أما فى سنوات المد التقدمى تلك فقد كان طموحنا هو أن نقدم أدبًا جديدًا ومختلفًا يسعى إلى التغيير دون أن يسقط فى فخ الدعاية أو الخطابة. ومن هنا، ربما، فقد انصبت معظم القصص على نقد العوائق أمام التقدم والحرية الإنسانية. ومن هنا، ربما، فقد غلَّفها الكثير من الحزن».
الكتابة الجديدة
كانت نقطة البدء فى هذه الكتابة القصصية المغايرة هى اللغة، التى مثلت فى حينها صدمة بالفعل لقراء الأدب ولنقاده على حد سواء. فقد فارقت البلاغة المألوفة فى الكتابات الأدبية من قبيل المحسنات والوصف والاستعارة، وانتهجت على العكس من ذلك أبسط تكوينات لغوية ممكنة فى جمل خبرية قصيرة تكاد تقتصر فى كثير من الأحيان على فعل وفاعل ومفعول به. ولم يكن الأمر سهلًا، فقد كان هذا الجيل يريد أيضًا ألا تكون هذه اللغة (عادية) كلغة الصحافة مثلًا، بل لغة أدبية لها جمالياتها وموسيقاها وإيقاعاتها الخاصة. 
لم يكن بهاء طاهر يعى بطبيعة الحال حين بدأ الكتابة مدى صعوبة ابتكار هذه اللغة التى وصفها ابن المقفع قديمًا بأنها اللغة التى إذا قرأها الجاهل ظن أنه يُحسن مثلها لفرط بساطتها. لم يكن يعى فى حينها كم هو صعب فى الكتابة أن تكون سهلًا!
يرى بهاء أن هذه اللغة الجديدة (التى أصبحت بعد ذلك مألوفة فى الكتابة القصصية والروائية لدى أجيال متعاقبة) كانت ضرورة فى سياق هدف تمثَّل فى إشراك القارئ (أو توريطه إن صح التعبير) لاكتشاف تناقضات الواقع ودلالات الأحداث دون أن يأخذ الكاتب بيده ليشرح أو يُفسر بشكل مباشر أو غير مباشر. وكان من المفترض أن تُفضى هذه المشاركة إلى تغيير وعى القارئ ومواقفه من الحياة.
أحدثت هذه الكتابة الجديدة صدمة. كان من علاماتها الترحيب والحفاوة من جانب من استطاعوا رؤية نقلة إيجابية تحمسوا لها، والهجوم الضارى ممن اعتبروا هذه الكتابة نكسة أدبية ودليلًا على العجز عن الإتيان بمثل ما كان يأتى به السابقون من اللغة التقليدية الفخمة والبلاغة الموروثة.
ولا أدل على ذلك من المقدمة القصيرة التى كتبها يوسف إدريس لقصة «المظاهرة» حين نشرها فى مجلة (الكاتب)، وهى المقدمة التى كان يعتز بها بهاء طاهر غاية الاعتزاز، إذ اعتاد فى أكثر من مقابلة صحفية أو إذاعية أن يشير إلى هذا التقديم، وقد جاء فيها:
«.. استطاع (الكاتب) أن يدلف إلى قصر القصة المسحور وأن يعثر فى سراديبه المظلمة على الخيط الأساسى لقصته هكذا بسهولة ومن أول ضربة أو أول قصة. إن ما أعجبنى فى هذا العمل أنه بهائى طاهرى إلى درجة كبيرة، وإذا استطاع الكاتب أن يكون نفسه الحقيقية تمامًا فى أى عمل يزاوله، فإنه بهذه الاستطاعة يكون قد وصل إلى مرتبة الفن، وأصبح كل ما يلمسه أو يكتبه كالأسطورة الإغريقية المشهورة ذهبًا فنيًا. وإذ أقدم هذه القصة لقراء الكاتب فإنى أقدمها فى الحقيقة أولاً لكُتّاب القصة، إذ أخذت أسرة التحرير على عاتقها ألا تنشر القصة لشهرة كاتبها أو لاسمه أو لتاريخه، وإنما فقط لكونها نموذجًا جديدًا.. ونحن نفعل هذا لمصلحة فن القصة، فهو وكل فن لا يزدهر إلا بالتجارب الخصبة الجديدة..».
إلى هذا الحد إذن كان الاهتمام بقصة واحدة جديدة لكاتب جديد فى تلك السنوات المثيرة الملأى بالتناقضات. ليس هذا فحسب بل إنه لم يكن غريبًا أن تجد ناقدًا أو محررًا صحفيًا يخصص ركنه فى الصحافة اليومية للحديث عن قصة قصيرة استوقفته. وقد ذكر بهاء طاهر أن كاتبًا لا يعرفه ولم يلتق به، وهو الصحفى الراحل عاشور عليش قد كرَّس بابه فى صحيفة (الجمهورية) للتعليق على قصة «المظاهرة» فور صدورها. ولم يخلُ الأمر من اختلافات ومعارك حول قصة واحدة مثلما حدث بالنسبة لقصة «الخطوبة»، فقد دارت المعركة حولها أولًا فى مجلة «جاليرى 68»، ثم انتقلت إلى الملحق الأدبى لصحيفة المساء لتصبح أكثر حدة وسخونة.
الغريب أن تلك المجموعة التى ثار الجدل والاهتمام حول قصصها فرادى، ظلت حبيسة تنتظر دورها للنشر فى دار (الكاتب المصرى)، إلى أن نُشرت بعد ذلك فى سلسلة «مطبوعات الجديد» الصادرة عن الدار، والتى كان يشرف عليها الدكتور الراحل رشاد رشدى. وبمجرد نشرها انهال على بهاء طاهر الاتهام بأنه قد انحاز لليمين الذى كان يمثله الدكتور رشدى، وبعد أقل من سنتين تم إبعاده عن عمله فى الإذاعة على أساس أنه منحاز لليسار!
يقول فى مقالته «أربعون عامًا من الخطوبة»: «يمين أو يسار لا يهم، إنما المهم أن المجموعة قد صدرت بعد الانقلاب الثقافى الذى حدث فى مطلع السبعينيات والذى تلخَّص فى الاستغناء عن الثقافة وعن المثقفين كما قلت فى كتابى «أبناء رفاعة». ومن هنا فإن المجموعة بعد نشرها قوبلت بالصمت ولم تُثر من الكتابات والتعليقات ما كانت تحظى به قصة واحدة من قصصها فى الزمن السعيد».
سافر بهاء طاهر بعد ذلك إلى الخارج ليبحث عن عمل إلى أن استقر به المقام فى الأمم المتحدة فى جنيف، وظل ممنوعًا من العمل ومن النشر فى مصر قرابة عشر سنين. وعندما رُفع عنه الحظر (بالنسبة للنشر وحده وليس بالنسبة للعمل) أعاد نشر مجموعة «الخطوبة» فى دار شهدى فى عام 1984، ليُذكِّر أجياًلا جديدة من القراء بأنه لم يهبط على عالم الأدب بالمظلة كما ظن البعض. وقد طلب وقتها من صديقه الأديب إدوار الخراط أن يكتب مقدمة للمجموعة ففعل وكتب مقدمة تحليلية للقصص جمع فيها بين خبرته كمبدع وكناقد كبير.
سؤال الحرية
كان طبيعيًا أن يظل بهاء طاهر مشغولًا طوال عمره بسؤال الحرية، هو الذى اُنتزع كانتزاع الزرع من الغيطان عندما غادر مصر، ففى منتصف السبعينيات، فى عز حملة الدولة على الشيوعيين، وفى ضربة مباغته، قرر يوسف السباعى الذى كان وقتها وزيرًا للثقافة تطهير الإذاعة من الشيوعيين، ولم يجدوا غير بهاء طاهر لكى يستبعدوه أو بالأحرى يرفدوه.
وقد حكى بهاء عن هذه الواقعة فى كتابه «السيرة فى المنفى» قائلًا: «الغريب هو استبعاد اسمى فقط من الإذاعة، غريب فى وقتها، لأن الشيوعيين كانوا يملأون أروقة الإذاعة، وعندما أُبلغت أنى الوحيد الذى أُهدِر دمه فى الإذاعة، توقفت طويلًا، تأملت هذا الاستنفار العدائى تجاهى بدهشة، لم أكن أعرف أنى شيوعى إلا عن طريق هذا القرار! (...) كان يُمكن أن يصبح الأمر مجرد قرار علىَّ تقبله لو أنى شيوعى بالفعل، لكنى بعدها سألت نفسى: هل أنا شيوعى؟ ثم قلت لنفسى: لعلهم يعرفوننى أكثر مما أعرف نفسى».
أتاحت له تجربة السفر من مصر خبرة جاوزت فكرة الرَّحيل نفسها، حيث لم تقتصر التجربة على كونها تجربة عمل ليس أكثر، بل بلغ تأثيرها حد أنها اختلطت بكتابته، فتداخلت البيئات، فمن الصعيد بتفاصيله الملهمة وحكايات أمه عنه، ثم القاهرة بتأثيراتها الطبقية والفكرية على المجتمع، إلى الرؤية الشاملة، الرؤية التى تخص الإنسان فى عمومه.
كما عايش طبيعة الصراع بين الشرق والغرب من أكثر من زاوية، لعل أهمها زاوية الإنسان فى حد ذاته، الإنسان متجردًا. فى الغربة أدرك بهاء طاهر أنَّ مأساة الإنسان الشرقى لا تختلف كثيرًا عن مأساة الإنسان الغربى، كلاهما له طابع الإنسان الحزين، طابع الإنسان فى العموم. فى الغربة شهد العنصرية سافرة بغير أقنعة زائفة، لعل هذه أكثر ملامح التشابه بين الغرب والشرق التقاء، عنصرية وتعصب بلا حدود.
وفى الأوراق التى عنونها بـ«سؤال الحرية» قدم بهاء طاهر رؤيته التاريخية وإجابته حول عدة أسئلة، من بينها: «هل تصبح مصر قطعة من أوروبا؟»، و«لماذا استطاعت هذه البلاد أن تتقدم وأن تقتحم ميادين لم نقتحمها نحن؟»، و«لماذا استطاعت أن تحافظ على الأصالة وأن تقتحم المعاصرة، إن نحن أصررنا على استخدام هذه الصيغة التى يبدو ألا فكاك منها؟».
بدأ إجابته قائلًا: «يُقال دائمًا إن مدافع نابليون أيقظت الشرق. ولكننى فى أثناء قراءتى فى الجبرتى وجدتُ أيضًا أن شعب القاهرة على الأقل كان متمردًا من قبل مجىء نابليون، كان الكيل قد طفح من بطش الدولة العثمانية وفجور الأمراء المماليك، فأضربت القاهرة كلها عن العمل وخرج الناس إلى الشارع ثائرين، ويحدثنا الجبرتى أن شيوخ الأزهر قادوا الجموع الثائرة حتى قصر الوالى، وأنهم حصلوا على توقيعه على «عريضة» تضمن للناس حدًا أدنى من الأمن والعدل. وبديهى أن هذا «الإعلان الدستورى» المصرى قد انتُهِك بمجرد أن نامت القاهرة الثائرة. ففى الصباح كان الوالى نفسه والمماليك أنفسهم ولم يتغير من الظلم والاستبداد شىء. شهد أناس ينامون فى كهوف العصور الوسطى بعض الألعاب البراقة لمدينة العصر الصناعى: بالونات تطير فى الجو، ومعدات تُغنى عن تسخير البشر، ومطابع تُغنى عن الناسخين، ومعامل كيميائية تدور فيها تفاعلات «تقصر عن فهمها عقول أمثالنا» على قول الجبرتى. ثم بعد الألعاب تأتى الأشياء المقلقة فما لدى هؤلاء الغزاة ليس هو التقدم العلمى وحده، بل إن لديهم نظمًا جديدة لا نعرفها ومفاهيم مختلفة للعدل وللإنسان: أو لم يذهب الجبرتى لأن سليمان الحلبى لم يُقتل على الفور بعد اغتياله كليبر بل حوكم وسُمح له بحق الدفاع قبل أن يوضع فى نهاية الأمر فوق الخازوق على الطريقة البلدية؟
على أية حال فإنه بعد مدافع نابليون تأتى مدافع محمد على (وسياطه أيضًا) ويحدث الطهطاوى الناس لأول مرة ويشرح لهم ما هو الدستور وما هو البرلمان، وكيف أن العالم قد قفز ومضى بعيدًا بينما كنا نحن نغط فى قرون من السبات القاتل. ومن وقتها ونحن نوجه ونواجه سؤالًا وحيدًا قد يبدو فى مظهره مجموعة من الأسئلة، ولكنك لو تجاوزت التفاصيل ستجد أن المسألة لا تخرج عما يلى: هل تصبح مصر قطعة من أوروبا؟».
يواصل بهاء طاهر: «قال البعض نعم، فإن تلك هى الوسيلة الوحيدة لكى نعوِّض ما فاتنا ولكى نعيش العصر الذى نحياه. وقال البعض لا، لأننا بذلك نخسر هويتنا وتقاليدنا وتراثنا الروحى، وماذا يُفيد المرء لو كسب العالم وخسر نفسه؟ وقال فريق ثالث نعم ولا، نأخذ العلوم والمناهج ونحافظ على تراثنا وهويتنا. ثم إنه على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان بذل أصحاب كل من الحلول الثلاثة جهدًا قليلًا لتحقيق ما يدعون إليه ولكنهم بذلوا الجهد كله بحرقة وإخلاص لقتال الفرقتين غير الناجيتين، ومن يدرى؟ ربما نكون محظوظين فيستمر هذا العرض قرنًا آخر، فلا يتخلى أحفادنا عن هذا التراث الذى عضضنا عليه بالنواجذ طوال هذين القرنين، وحين أقول ذلك فأنا لا أمزح ولا أهزل، ذلك أنه ويل لنا حقًا لو نجحت إحدى الطرق فى القضاء على أختيها ثم انفردت بنا لنكون حقلًا لتجاربها. سيقول قائل بطبيعة الحال: ولكن انظر حولنا، هناك بلاد بدأت نهضتها معنا، وفى الأغلب من بعدنا ولكنها استطاعت أن تحقق ما لم نحققه. ها هى اليابان عملاقة العالم الاقتصادى، وها هما الصين والهند قد فجرتا الذرة، وصنعت الهند ثورة خضراء تكفى سكانها قمحًا وتفيض، وأما نحن فلا ذرة فجرنا ولا قمحًا زرعنا، وسيقول هذا القائل أنا لا أعنى قط أن هذه البلاد الثلاثة تخلو من مشكلات بعضها طاحنة، ولكنى أقول إنها أنجزت ما لم ننجزه نحنُ دون أن تفقد شيئًا من هويتها أو تراثها الروحى والدينى، فالهند أكثر بوذية من أى وقت مضى، واليابان ما زالت على ديانتها الشنتوية، والصين ما زالت تحافظ على جوهر فلسفتها العريقة برغم أنها فى الوقت الحالى ترفع لافتة الماركسية».
لا يهدف بهاء طاهر من هذه الأوراق إلى أن يقدم فلسفة أو يطرح برنامجًا، أو ينقد برامج الغير أو يفندها، ولا يزعم أنه وجدها! أو أنه يبشر باليوتوبيا الجديدة، إنه فقط يدعونا إلى التفكير، فقد درس التاريخ فى الجامعة، وظل يقرأ فى كتب التاريخ طوال عمره. أما الاهتمام بالشئون العامة ومن بينها السياسة، فلم يستطع أن يتخلص منها لحظة واحدة، رغم أنه لم يكن سياسيًا نشطًا فى أى وقت من حياته، وكان التنظيم السياسى الوحيد الذى دخله هو الاتحاد الاشتراكى أيام الانضمام أو الضم الإجبارى فى الستينيات، الذى شمله مع ملايين الناس، دون أن يحظوا حتى بالتصعيد إلى التنظيم الطليعى، غير أنه فى تلك الأيام حين كان يكتب قصة أو مقالًا وينشرها فى مجلة محترمة (ولكنها محدودة الانتشار)، كان يشعر أن هذه الكتابة ستغير العالم أكثر من كل الخطب والاجتماعات!
يعترف فى الأوراق التى كتبها تقريبًا فى أواخر تسعينيات القرن الماضى: «أدرك الآن (متأخرًا مع الأسف) كم كنتُ مغرورًا ومخطئًا فى هذا الظن. كنتُ أيامها أعمل فى البرامج الثقافية فى الإذاعة وأنشر فى المجلات الثقافية، على زعم أن العمل الجاد البطىء سيؤثر فى صفوة مفترضة، وأن هذه الصفوة التى يُرفض فكرها باستمرار وتزداد عددًا باطراد هى التى ستقود المجتمع نحو التغييرات الحقيقية التى يحتاجها أيما احتياج. كنتُ وغيرى نعتقد أن الأدب يمكن أن يجعل الناس أكثر حساسية وفهمًا للعالم من حولهم وأننا سنصل فى نهاية الأمر إلى مجتمع أكثر ديمقراطية وعدلًا، زال منه الفقر والاستغلال، وتشيع فيه القيم الإنسانية السامية وتحتل فيه الثقافة التى تثرى روح الإنسان وعقله موضع القلب. قل إنها أوهام الشباب وغروره غير أنى أعترف بسر: أنا لم أتعلم التواضع الكامل بعد!».
دور الأدب
ولكى نفهم المناخ الذى تفتح فيه وعى بهاء طاهر، لا بد من ذكر بعض الحقائق المهمة والتى وثقها فى أوراقه أيضًا، أنه انطلق من واقع مصرى عربى له خصوصيته، يشكل جزءًا من عالم ثالث ما زال يعانى فى معظمه من مشكلتى التبعية والتخلف، وأنه كان يخوض فى نهاية القرن العشرين حربًا متأخرة للتحرير، أصبحت أكثر تعقيدًا مما كانت عليه فى أوائل القرن. ويخوض فى الداخل معركة للتغلب على القهر بمستوياته المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالغرب خصم أساسى فى كثير من هذه المعارك، إذ يرى كثيرون أن الاستعمار لم يرحل عن بلاد العالم الثالث إلا بجنوده، وأن إشكالية العلاقة معه تتمثل فى حتمية الصدام بصورة ما.. وحتمية التعاون بصورة أخرى.
لقد تصور الكاتب المصرى العربى منذ بدء النهضة فى القرن التاسع عشر أن للأدب المكتوب دورًا إيجابيًا فى تشكيل الواقع، وكان هذا غريبًا فى مجتمع أمى فى معظمه. كان الكُتّاب بأعمالهم فى طليعة تحرك أمتهم سواء فى محاولتها المبكرة للنهوض (الثورة العرابية) أو فى محاربتها للاحتلال والاستعمار أو فى تصديها لكارثة غزو فلسطين أو فى صياغة المشروع القومى الذى تبلور فى الخمسينيات والستينيات.
ورغم الأمية الكاسحة فقد استطاعوا عبر وسائل مختلفة أن يصلوا إلى جمهورهم الطبيعى. نادرًا ما تحقق ذلك بصورة مباشرة، مثلما فعل عبد الله النديم المعجز الذى كان خطيب الثورة العرابية وكاتبها الصحفى وشاعرها الشعبى، ومثلما فعل أيضًا كُتَّاب المسرح فى الستينيات، ولكن دور الأدباء كان يتحقق فى الغالب على مرحلتين: عبر وصولهم إلى المثقفين أو قادة الرأى بلغة رجال الإعلام أولًا، ثم مشاركة هؤلاء المثقفين بعد ذلك فى صياغة الرأى العام. ورغم أن فرصة هائلة قد توافرت أمام الكُتَّاب لتحقيق التأثير المباشر مع ظهور وسائل الإعلام الجماهيرية، ولا سيما الراديو والتليفزيون، إلا أن ذلك نادرًا ما تحقق.
وفى الخمسينيات كان الشعراء والروائيون فى طليعة الحركة الوطنية الشاملة، وخلقت أعمالهم المناخ الفكرى الذى تحركت فيه الثورة المصرية نحو صياغة الواقع الجديد وتجسيد حلم التحرر والتقدم «الحرية والاشتراكية والوحدة».
كانت فترة الخمسينيات والستينيات -وهى فى معظمها فترة الحكم الناصرى- من أزهى عصور الثقافة المصرية، فلم يشهد المسرح مثلًا عصرًا كهذا تكاملت فيه المواهب فى التأليف والإخراج والتمثيل، وتوافرت فيه المسارح بظاهرة عكسية لما عرف من قبل: أى تحويل بعض دور العرض السينمائى إلى مسارح. ولم يسبق لكُتّاب القصة والرواية هذا الرواج فى النشر واقتباس أعمالهم للمسرح والسينما والتليفزيون.
يرى بهاء طاهر أن فترة الحكم الناصرى كان لها دور ملتبس من الثقافة والأدب يتصف بالتناقضات نفسها التى صاحبت حركتها التقدمية فى المجتمع، والكُتَّاب هم الطليعة التى مهدت لرفض المجتمع القديم السابق على الثورة ولقبول التغيير. وقد احتضنتهم الثورة وقبلتهم فى هذا النطاق، ولكنها لم تسمح لهم بتجاوز هذا الدور والانتقال إلى المشاركة فى صياغة المجتمع الجديد، تمامًا كما أنها لم تكن تسمح بالمشاركة الشعبية فى اتخاذ القرارات التى رسمت صورة هذا المجتمع. هذه القرارات كانت فى حينها لصالح الشعب وقضاياه فى معظم الحالات، وكانت تلقى تجاوبًا فوريًا وتلقائيًا مثل تأميم القناة، ولكن المشاركة فى صنع القرار لم توجد قط.
الواقعية الاشتراكية
فى سنوات الثورة الأولى، عندنا كانت هذه القرارات تجسد الأحلام القديمة. استمر الكُتَّاب على تجاوبهم مع الحكم الجديد وتمهيد الأرضية الفكرية لتجسيد هذه الرؤى التى بشروا بها من قبل. هكذا كان الحال مع توزيع الأرض على الفلاحين، ومع التأميم، ومع حرب السويس، والخطوات الأخرى من أجل الاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية. وفى تلك الظروف كان من الطبيعى أن يتصف الأدب بالثورية، وكان يكتسح الساحة التيار الواقعى الاشتراكى، ويذكر بهاء طاهر أن أرقى نماذح وقتها فى الرواية عبد الرحمن الشرقاوى ويوسف إدريس، فضلًا عن نجيب محفوظ غزير الإنتاج.
ولكن الواقعية الاشتراكية استنفدت نفسها لسببين رئيسيين فى رأى بهاء طاهر؛ الأول أن المناخ الثورى الحقيقى الذى جعل منها تعبيرًا صادقًا عن الفترة قد شحب وتحوَّلت الثورة إلى نظام، ونظام شديد الوطأة عن ذلك: لا يسمح بالنصح، ناهيك بالاختلاف معه. وأما من أصر من رواد الواقعية الكبار على موقفه كناصح للحاكم والشعب فقد عرف طريقه إلى السجن بمن فى ذلك أكبر المنظرين الفكريين للتيار ونقاده الشعبيين.
والسبب الثانى أنه مع رواج الواقعية الاشتراكية ونجاحها اقتحم ساحتها واقتبس أساليبها عدد كبير من الكُتّاب الرومانسيين المخضرمين (أى السابقين على الثورة) الذين كانت أعمالهم بريئة من الروح الثورية والاشتراكية من قبل (وفيما بعد سيتحول الكثيرون منهم إلى مواقع الثورة المضادة بالبساطة نفسها التى تحولوا بها إلى التبشير بأفكار الثورة). وتحوّلت الواقعية الاشتراكية على أيدى هؤلاء الكُتَّاب الذين افتقروا إلى مواهب الرواد الواقعيين الأوائل وإخلاصهم لفكرهم إلى جلجلة للشعارات والخطب عن الكفاح وأمجاد العرب ورداءة الاستعمار وعظمة إنسان السد العالى، بإمكاننا مراجعة روايات يوسف السباعى وفتحى سلامة إلخ إلخ، وقد احتفى النظام بهؤلاء الكُتّاب واعتبرهم المتحدثين بلسانه.
يقول بهاء طاهر: «من الطبيعى ومن حسن الحظ أن هذه الحركة لم تفرز أدبًا حقيقيًا واحدًا يمكن أن يملأ الساحة أو يعوض غياب رواد الواقعية. (ومع انحسار التيار الواقعى، بل ومن قبل ذلك كان هناك تيار جديد يتشكل، من المؤكد أنه استفاد من إنجازات رواد الواقعية الكبار، رغم أنه ككل حركة جديدة طرح نفسه كخصم لها وكبديل)، ولم يستقر الرأى على وصف لهذه المدرسة واكتُفى فى معظم الحالات بنسبها إلى ذلك العقد، فقيل أدب الستينيات، ووصفت أيضًا بأنها الموجة الجديدة والحساسية الجديدة وأدب العبث، وإذا كان لى أن أغامر بتسمية أخرى من عندى، على الأقل باعتبارى منتسبًا إلى هذا التيار فسوف أسميه واقعية ثورة يوليو أو الواقعية اليوليوية!».
يواصل: «والسبب الأول أن ذلك الأدب هو الابن الشرعى لثورة يوليو، بمعنى أنه ولد فى أحضانها، وكان المعبر الحقيقى عنها رغم أن ذلك لم يعجبها على الإطلاق لأن ما كان يعبر عنه لم يكن ورديًا كله: وهو بالتحديد ذلك الواقع الذى تبلور فى نهاية الخمسينيات وفى حقبة الستينيات».
أدب النذير الاجتماعى
يذكر بهاء طاهر فى أوراقه صفة أخرى قدمها أديب معروف للأدب الجديد أو أدب الستينيات، وهو أنه «أدب النذير الاجتماعى»، بمعنى أنه كان من أهم سمات هذا الأدب أنه يلمح وقع كارثة مقبلة ويحذر منها. هذا الأديب هو أمل دنقل الذى يعد أبرز رواد هذه المدرسة بديوانه «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة»، وهو من هذه الزاوية أدب رفض واحتجاج وبصورة غير مباشرة دعوة إلى التغيير.
انتهت إلى غير رجعة إذن فى الستينيات اللغة الجليلة والصفات والمترادفات البليغة وأصبحت اللغة «وظيفية» إلى أبعد حد، أى تقتصر على التعبير عن الأفعال ووصف الأحوال، وهى اللغة التى كان يحلم بها يحيى حقى، عندما دعا إلى ما أسماه باللغة العلمية.
ويؤكد بهاء طاهر على أن هذه اللغة الوظيفية المحكمة استطاعت أن تخلق شاعريتها وبلاغتها الخاصة، تلك البلاغة المتولدة من الإيجاز وبساطة التعبير، والمقدرة على إطلاق شحنة من الانفعالات من تركيب العبارة لا من ألفاظها، وجِدَّة الرؤية للعلاقات بين المرئيات بعد أن تحررت اللغة من أسر الألفاظ «الأدبية» وتحرر معها خيال الكاتب. يقول: «وإذ أسقطت هذه المدرسة عن اللغة كل الترهل الذى أثقلها عبر عصور من سيطرة الفكر البلاغى، والذى لم ينجُ منه سوى قلة من رواد الواقعية أنفسهم، فقد أعادت إلى اللغة نقاءها الأول الذى نجده فى الشعر الجاهلى مثلًا. اختلفت المفردات بطبيعة الحال ولكن احتفظت الألفاظ ببكارتها».
ورغم أن كُتَّاب هذا الأدب نادرًا ما تعرضوا للسياسة بالشكل المباشر الذى كرسه الواقعيون الاشتراكيون، بل ورغم أن أدبهم قد بدا مغرقًا فى الفردية وكأنه عودة للرومانسية، فإن تلك الكتابات أفزعت النقاد الرجعيين ربما أكثر من الأدب السياسى المباشر، وراحوا يحرضون السلطة على هؤلاء المبدعين المتمردين باعتبارهم وجوديين وشيوعيين ومخربين فى وقت واحد.
يقول بهاء طاهر: «لم يكن مأخذ هؤلاء المدافعين المشبوهين عن الثورة أن هؤلاء الكُتَّاب أقل ثورية مما يجب وإنما العكس تمامًا. فقد كان أدبهم يفضح عناصر الاختلال فى مجتمع الثورة، دون أن يكونوا معادين، ولكن من تناقضات الثورة المصرية أيضًا أنها كانت أكثر إصغاءً لأعدائها منها لأصدقائها، ومن ثم فقد تعرض كل كُتَّاب واقعية يوليو للاضطهاد على يد الثورة نفسها أولًا، ثم على يد من انتفضوا عليها».
رأى الجمهور
ورغم انحياز بهاء طاهر التام للغة الجديدة وما أحدثته من ثورة، إلا أن ذلك لم يمثل له عزاءً كبيرًا، فالرواية والكتابات الأدبية مهما بلغت من النضج والتطور لا تستطيع خلق الثقافة الوطنية، أى أنها لا تستطيع ذلك دون توافر حد أدنى من إمكانية الوصول للجماهير العريضة، وإمكانية المقارنة بينها وبين غيرها. ويرى أن ما يحدث فى بلادنا لا يختلف كثيرًا عما يحدث فى الغرب، رغم اختلاف الظرف، فالاحترام الشكلى للثقافة فى وسائل الإعلام الغربية لا يخفى حقيقة أنها تمثل حلبة ليس لها تأثير فعلى على تكوين الثقافة التحتية أو الشعبية.
ويتساءل: «ماذا تجدى مثلًا البرامج التى تستضيف الأدباء الحقيقيين ليتكلموا عن أعمالهم فى التليفزيون، بينما تبث كل البرامج الأخرى قيمًا هادمة للثقافة تشجع الاستهلاك الترفى، ومن ثم الأنانية الضيقة، وتجرد الإنسان من إنسانيته بتحويله إلى مجرد كائن مستهلك وباحث عن المتعة؟»، ثم يضيف: «انتهت بذلك إذن أكبر قيمة يمكن أن تحققها الثقافة كما أفهمها، وهى أن يخرج الإنسان من ذاته لينفتح على الغير ويتفاعل معهم. ومن هنا مثلًا فإن ذلك الانتشار الواسع النطاق والمدان للعنصرية فى الغرب ليس فيه ما يدهش لأنه وليد تلك الثقافة السائدة التى تروج لها وسائل الإعلام، والتى تشجع كل إنسان على أن يكون أسير جلده ومتعه».
لكن فى موضع آخر من الأوراق، توجد شذرة منفصلة، أعاد بهاء طاهر كتابتها مرتين، تعكس تخوفه من الجمهور، خاصة إذا أقبل هذا الجمهور على الكتابة الرديئة، ومنح كاتبها مكانة لا يستطيع أن يصل إليها الموهوبون والجادون من الكُتَّاب، وهو ما شاع فى العقدين الماضيين وعاصره صاحب «نقطة النور» فى نهاية حياته، يقول بهاء طاهر فى هذه الشذرة:
«لا توجد مع الأسف فى العالم كله محكمة يشكو إليها الإنسان من كاتب ردىء فتمنعه من الكتابة! ففى ظل الديمقراطية فإن المحكمة الوحيدة هى رأى الجمهور بإقباله على كاتب معين فتكون تلك شهادة له بالبقاء، أو أن ينصرف عن آخر فيذوى إلى النسيان، أما فى النظم الديكتاتورية فلا يهم كما رأينا غير رأى قارئ واحد له وحده القول الفصل، وهو الذى يصدر صكوك البقاء والإعدام للأقلام».
ويضيف: «تحدثت فى مقال سابق عن أن الضمانة الوحيدة لحرية الصحافة ومسئوليتها هى أن نترك الانتخاب الطبيعى يعمله عمله، بحيث يظل البقاء للأصلح فى ساحة العلم. ولكن قانون الانتخاب الطبيعى مثل أى قانون علمى آخر يلحق به دائمًا تحفظ يقول (مع افتراض ثبات أو استقرار كل العناصر الأخرى) وبعبارة أخرى فإنه لكى يعمل أى قانون علمى عمله، فلا بد من تماثل أو تطابق الظروف التى تتكرر فيها التجربة أو الحدث العلمى. فقد يندثر أحد الكائنات الحية الأصلح والأقدر على البقاء فى إطار الصراع الطبيعى مع الكائنات المنافسة الأخرى إذا ما أهلكته كارثة طبيعية أو وباء كاسح. هنا يضيع الأقوى ويبقى الأضعف. ويُقال على سبيل المثال أنه فى حالة الانفجار النووى الذى يبيد كل أثر للحياة مع مسار إشعاعاته، لا يستطيع البقاء سوى أدنى أنواع الحشرات قاطبة، أى الصراصير!».
خاتمة
من خلال أوراق بهاء طاهر، وهى تضم أفكاراً ومقالات نشر بعضها فى مجلات مختلفة وتضمنها كتابه «أبناء رفاعة» نستطيع أن نتأكد أن همه الشخصى لم يكن ينفصل عن الهم العام، سواء كان همًا أدبيًا أم سياسيًا أم اجتماعيًا، ففى جلسات المثقفين، كثير ما تدور التساؤلات حول الهوية المصرية، وكيفية تجديد الخطاب الثقافى، وكانت آراء بهاء طاهر صادمة للكثيرين، فقد كان يرى أنه لا يوجد خطاب ثقافى من الأساس، لأن الخطاب يحتاج إلى مُرسل ومستقبِل، والمُرسل أصابه العطب والمستقبِل لم يعد موجودًا.
ودعا بهاء طاهر فى كتابه «السيرة فى المنفى» إلى ضرورة أن ننبذ الأفكار الجامدة من قبيل: «كل شىء على ما يرام.. نتعامل كأننا مثقفون.. كأننا ديمقراطيون.. كأننا لسنا متعصبين ولا عنصريين»، فعلى الإعلام الحقيقى ووزارة التربية والتعليم والمتخصصين والنخبة التحرك حثيثًا لوضع مناهج وأطر فكرية جديدة، وإنقاذ الهوية الثقافية، فقد كانت من أبسط أحلامه التى يتمنى تحقيقها، أن يتغير الخطاب الثقافى برمته، فما زلنا نتعامل مع الثقافة كأنها أمر شرفى، جوائز ومهرجانات واحتفالات ليس أكثر ولا أقل.
وفى إحدى أوراق بهاء طاهر كان هناك اقتراح كثيرًا ما كان يؤكد عليه وهو أن يقرأ المسئولون كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» لطه حسين، وأن ينفذوا أفكاره بحذافيرها، لأنه للأسف لا يوجد برنامج لتغيير ثقافة مصر إلا برنامج طه حسين الذى كُتب عام 1937. ففى رأيه، كتاب طه حسين ثورى، ليس لأنه كتاب عن التعليم فحسب، وإنما عن الديمقراطية الحقيقية.
يقول بهاء طاهر: «لو طبقت أفكار طه حسين لكنا أنقذنا الوطن من براثن التطرف الدينى»، فكان بإمكان هذا الكتاب أن يعلِّم المصريين احترام الاختلاف، وأن الرأى يتم الرد عليه بالرأى وليس بالهمجية والقنبلة والتطرف والتمرد.
ولكن ماذا سنفعل، أفق ضيق وحياة أكثر ضيقًا، كما كان يقول.















