صومعة أو إيريمو
أسعد بالبشر وأعطهم قلبك بسخاء: هذا المنحى ليبرالي، ولكنه ليس أرستقراطيًا. فالقلوب المعطاءة الرستقراطية تعرفها من الستائر المتعددة على النوافذ والمصاريع المغلقة: وهى تُبقى غرفها فارغة، على الأقل أفضلها، وتنتظر الضيوف الذين لا تريد أن ترضيهم وحسب فريدريك نيتشه، شذرات منشورة بعد وفاته، نوفمبر1887.
اقرأ أيضا| نجوى العتيبى تكتب: يوسف رخا على طريقة المتنبى
إذا كان أصل الكلمة هو المعنى الحميم الذى تنم عنه الكلمة، فمما له قيمة فى هذا المضمار اشتراك كلمتين مبتعدتين الواحدة عن الأخرى فى جذر واحد، وهما كلمة «إيروس» اليونانية، التى تعنى العشق والرغبة، والتى تشترك فى الجذر «رام» مع الكلمة اليونانية « إيريموس أو المنسك».
ومعناها الصومعة، ومنها جاء اسم «الناسك المتعبد». فى الماضي، عندما كانت الحقيقة أكثر وضوحًا ويمكن الوصول إليها، كان يُعتقد أن الانعزال لممارسة الحب فى مكان يمكن أن نسميه «عش الغرام» والانعزال عن العالم فى مكان يمكن أن نسميه «الصومعة».
هى أفعال متشابهة. وهكذا اشترك العشاق والنُساك فى رغبة التواجد فى مكان منعزل مع موضوع الحب، الإنسان والإله على التوالي. ولكن ماذا عن المعنى الخفى الذى يكمن فى روح هاتين العائلتين المختلفتين من الكلمات.
وهل هو أن المرء وحيد فى محبسه، سواء كان فى الصومعة أو فى حالة حب؟ فالناسك وحده (ولو كان مع الإله)، والحبيب وحده (ولو كان مع المعشوق). إن غموض أصل الكلمات يسمح لنا، بل يشجعنا على الاعتقاد بأن الجذور المشتركة تحمل بداخلها معنى حميماً، وفى القلب من معانى كلمتى «عش الغرام» و«الصومعة» حقيقة واضحة رغم غموضها، وهى أن المرء دائمًا وحيد.
كما أننى لا أؤمن، كما أقرأ وأسمع كثيرًا، أن كل قصة تثرينا، حتى الأكثر بؤسًا، لأنها تزيل من أنفسنا الإحساس بالعزلة الطبيعية والقاسية؛ وأننا سنعيش ونخوض التجربة حتى ولو فى الوحل. أعتقد أن بعض الأشخاص الغريبة الذين اعتقدت أنى أحبهم هم الذين أكلوا عمرى وذبلت معهم زهرة شبابي. إن معظم النار من مستصغر الشرر، والسوسة التافهة يمكنها أن تسقط أضخم الأشجار.
فى كل مرة نخرج فيها من جمودنا الذاتى - نتخذ خطوة للخروج من الوحدة، ونبدأ علاقة، فنجرى تلك المكالمة الهاتفية، ونرسل كتابًا - تنطلق الطاقة فى مكان ما. تغيرت ظروف الجمود الأولي. لن تكون البداية من الصفر، وإنما من لحظات العلاقة الأولى، أى بدلا من النقطة صفر، النقطة 1، وهو ما تحدده الرياضيات المتغيرة. نحن، بفعلنا أو كلمتنا، متغير تابع ومستقل فى الآن نفسه، فى علاقتنا بالصيرورة.
إن استثمار الطاقات خارج الذات هذا هو إزاحة للسيادة على النفس ومحوها: لم يكن هناك وقت سقطت فيه فى الحب بدون الشعور بانتزاع امتلاكى لنفسي، فيتحول مركز الجاذبية عندى إلى الآخر ( أو تظل فى منتصف الطريق بينى وبينه طبقا لمتوسط رياضي.
ففى بعض الأحيان يظل مركز الجاذبية فى نفسي، وأحيانا أخرى يتدفق بالكامل إلى الآخر). لم أعد أنا، المجال الحصرى لاهتمامي، وهذا يتسبب فى بقاء «الأنا» فارغًا لبضع لحظات، مثل منزل شاغر.
ويمكنك فقط التفكير فى شخص واحد فى كل مرة. كلهم لديهم الكثير من المشاكل! عندما نهتم بشدة بحال واحد من محبينا، يختفى الآخرون بالضرورة من جغرافيتنا العاطفية. إنهم يخلقون نوعا من الفوضى تدفعنا إلى قطع بعض الروابط التى تربطنا بهم، لكى تساعد فيما بينها بشكل مثمر من هو فى أمس الحاجة إلى المساعدة.
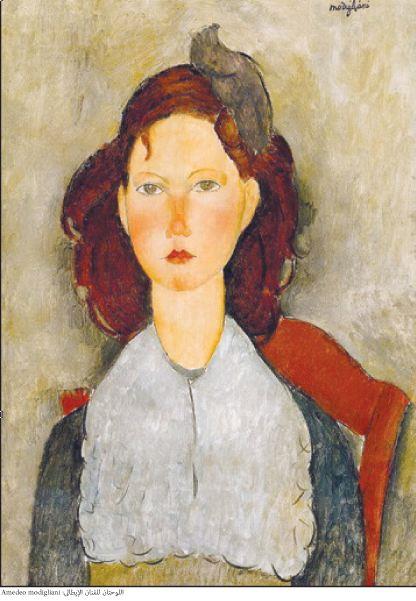
المشكلة أنهم جميعا يظنون أنهم مركز حياتنا، ويطالبون بدوام الانتباه لهم. فى حالات الحب المهووس، كان هذا الإخلاء كاملا تقريبا، فلا يبقى بداخلى سوى أرفف فارغة، شماعات مغطاة بالتراب وبلاطات محطمة.
وأحواض علاها الصدأ. فى بعض الحالات كانت عودتى إلى نفسى تستغرق وقتا طويلا، محاصرة مثل مدينة إيثاكا الأسطورية موطن عوليس: أوديسا استيقظت فيها ذات صباح تحت شجرة زيتون مرتدية زى متسول، متحررة أخيرًا من أعمال السحر.
الثابت الوحيد فى جميع قصص الحب التى عشتها، بخلاف اللحظات الأولى المغيبة، وكذلك المتعة الغامضة (الحقيقة هى حلاوة العشق)، هذا الثابت الوحيد هو الملل. ملل لم أحس به مطلقا وأنا وحيدة.
ولا حتى فى عصارى الأيام الصيفية فى الطفولة، ملل جاف، يصم الآذان كعاصفة رملية، يغشى المواعيد الغراميات ونزهاتها والمكالمات والليالى والأمسيات والصباحات الجافة الخالية من تحية الصباح، وتحويلات القطارات أثناء وجودى بحمامها، وأعياد الميلاد، وحفلات الكريسماس التى أتمنى أن تختصر أو أهرب منها.
وكلها يبتلعها الشعور بالراحة الذى يعقبها. وهو فى النهاية ملل يغشى كل مجالات ما يسمى بالحياة الزوجية، حتى فى الجنس، وفى بعض الأحيان خاصة فى الجنس. صحيح أنه كانت هناك لحظات خالية من الملل، ولكنها مثل صورة نيجاتيف لحالة ثابتة لا مناص منها. هى شذرات منتزعة بطريقة ما من بعض لقاءات العشاء فى مدينة ساحلية.
نزهة فى السابعة مساء على طول الشوارع الضيقة لقرى العصور الوسطى. مشتريات صغيرة من الحلى والملصقات المغناطيسية والبطاقات البريدية وباقات اللافندر الصغيرة، والهدايا التذكارية فى المتاجر؛ ونوافذ القلاع التى زرتها فى القيظ الرمادي، تحت مطر من الغبا، مليئة بالمأكولات الفخمة.
والأسرة العالية والقصيرة، على مقاس أجساد الأجداد، تحت الستائر الزرقاء لسماء مرصعة بالنجوم؛ كانت قبلات قصيرة أمام النوافذ المفتوحة، فى حين أن ضجيج الأوانى جاء عاليا وكاملا من منازل الآخرين؛ وفى بعض الأحيان جاءت من هدايا صغيرة غير متوقعة وأساور رخيصة.
وعبارات بسيطة ولكنها حقيقية على شاكلة «فكرت فيك». أو، على عكس الملل، وأيضا على عكس السكينة والفرح، كانت هناك أسوار عالية مغروس على قممها شظايا من زجاج: انتظار رسالة، غيابات مريبة، وغيرة آكلة للحوم بشر ذاتية. أحسست بالفرح فى تلك الحالات، ولكنها كانت فرحة مخدرة.
كان هناك ساحر قام بخدعة: الأرنب لم يختف، كنت أنا من اعتقدت أنه اختفى. لكن الهوس توقف هو الآخر عن أن يكون طبيعيًا، لأنه لا ينشأ من الداخل، بل يتم تحريضه بواسطة قوى خارجية. كيف كان الحب قديما: هى سيأتى الليلة؟ تحدث مع والديّ.
رأيته أمام المقهى. اتصل بي، لكننى لم أكن بالمنزل. أحضر الحلويات. أعطانى ملصق هولى هوبي. كان فى المقهى قبل قليل. ترك دراجته مستندة على الجدار. غدا أراه. كيف نحب اليوم: لقد قرأ لكنه لا يرد. كان أونلاين الساعة 2 صباحًا.
وضع لايك لفتاة ترتدى المايوه. ظللنا فى تشات طوال المساء. بمجرد وصولى تحت منزله، أرسلت له ماسيج. كخلفية وضع صورتنا عندما كنا فى البحر. عملت له بلوك. حذفت الرسائل. إن 70-80٪ من معاناة الحب اليوم هى تقلص رقمى نعيشه فى عزلة، يستحيل توصيلها فى ظل القصف التقنى المجنون لوسائل التواصل.
وما نسميه نوستالجيا ليس إلا تقلصات ماض رمادى مزدوج. شيء، مثل نركسوس مثال النرجسية فى الأسطورة اليونانية، نراه ولا يجيب علينا: نكرر صداه من خلال مشاهدة كلماته الأخيرة على واتساب لعدة أيام، والتحقق من وقت دخوله على التطبيق آخر مرة. تبدو لنا أن كلمة «أونلاين» تحت اسمه الحبيب كأنها نظرته؛ يبدو لنا أنه ينظر إلينا، الغائب الذى لا نرى منه إلا اتصاله بالإنترنت فقط: نركسوس النرجسي، يظهر شفافا، أخرس ومعجباً بنفسه، على صفحة الماء القاسية للشاشة. قديما كنا نرد على الرسائل فى نهاية اليوم، أو بعد أيام، أو أسابيع.
كان هناك انقطاع زمنى ينبت فيه التفكير فى الآخر. وكان كافكا يعتقد أن الأشباح تتحدث مع بعضها البعض من خلال الورق. والآن نرد على الفور على رسائل البريد الإلكترونى والرسائل النصية.
فهل نتصور أن الأفكار الأولى التى تطرأ على أذهاننا هى الصواب؟ أنها ليست مجرد رد فعل؟ وأيضا: أنها ليست أفكارًا بالمرة، بل ارتداد مجرد ارتداد إدراكي، هرشة دماغ لدغتها بعوضة، التهاب فكرى بعد تأثير صدمة فكر الآخر؟
ولكن حول كل تلك التساؤلات غير المنتظمة، تغطى شمولية الملل الخانق كل علاقة، حتى إذا اعتبره البعض الثمن المدفوع بهدوء مقابل سلعة الحب الراسخ. أظن أن كل المشاعر التى نطرحها، ونوزعها مثلما نوزع أوراق اللعب بيننا وبين الآخر.
هى وسيلة لمقاومة الملل المحتوم؛ أننا نخترع قصة للمشاعر (علاقات متبادلة، الغيرة من أطراف ثالثة، التحليلات المرهقة، التعبير اللفظى عن عدم الرضا، المطالبات، المراسيل، الشكاوى) ونحبط تعليقاتهم المستمرة حتى لا نستسلم للملل الذى سيغطى كل شيء، إذا لم نسمح لأغنام العشق المطروح أن ترعى فى الأراضى الشاسعة والقاحلة التى تفصل بين عشيقين.
أ. أن تعرف
«لأن الإنسان يحب الإنسان ويحترمه مادام غير قادر على الحكم عليه، فالرغبة هى نتاج لمعرفة ناقصة.» توماس مان، الموت فى البندقية.
أ. يطيعني، وهذا ما أريده. ليس لأننى أحب السيطرة على إرادة الآخرين (هذا عمل شاق ومرهق للغاية)؛ على العكس من ذلك، أريده أن يشعر بالثقة فى نفسه والسيطرة عليها بحيث يمكنه أن يطيعنى دون أن يفقد مثقال ذرة من سلطانه على نفسه.
إنه يتفاعل مع طلب أعلى من سلطتى ويتخطى النادلة التى تم تدريبها على التحكم فى الوصول إلى مشاعري، ويتصل مباشرة بالرئيس. إنه لا يعطى أى أهمية للشخصية التى أصر على لعبها، والتى تحارب ضد الحياة ولديها شغف وعدم حب يتكاثر مثل الطحالب على الكتفين. وهو يتكلم قليلا، وينتظر اختفاء جميع الخدم الذين أوكلتهم لحراسة ممتلكاتي، فهو ضيف شريك فى ملكية المنزل.
على سبيل المثال: عندما يكون فى روما أتجنبه. يبدو أننى أحبه أقل وأشعر بأنه أقل حبًا لي. أرش عطره المفضل على الوسادة ( عطر سارتوريال من بناليجون: لافندر معدني، له رائحة الغسيل والقماش الجديد، على نفس الشاكلة التى من الممكن أن تشمها فى ورشة خياطة من آواخر القرن التاسع عشر، ومعها مجموعة من الروائح المختلفة مثل رائحة الخشب المميزة للأرشيف القديم.
وعينات الكتان، وقصاصات الجلود، وألواح الشمع التى يمر عليها خيط النسيج: ومع أنه عرف هذا العطر من خلالى إلا أنه يبدو أنه قد اخترع له) وأنا أبكى من العوز وأبكى من الوفرة، مثلما بكت أم إيروس، وأبوه. إنه لا يجادل فى هذه الحقيقة،
ولا يدخل فى الموضوع من الأساس. يغمغم بالموافقة؛ ثم يتأمل الموضوع لبرهة وهو ينظر ليدى أو لجسدي، أو لساقي، ثم يتضح أنه لم يتأمل فى الشيء فى حد ذاته، ولكن فى الطريقة التى أتحدث بها عنه، أو لماذا أخبره به، أو فى ثوبي. روما هى مكان وحدتى ومكان حبى الذى أغرقته شروخ قاتلة.
أحيانًا يثقله هذا الهوس الجنوني، ويتوقف عن احترامه: يأتى إلى منزلي، فيتصل بي، وينطق باسمى ويقول لى انزلي. أنظر إليه من النافذة خلسة (يرتدى نظارة شمسية عندما يقود السيارة: وفى تلك اللحظة يتحول إل مجرم، لص: على عكس حقيقته؛ وأنا أحبه بنفس القوة، ولكن فى الاتجاه الآخر)، فأقوم بتنشيط مشاهد التعذيب التى بحثت فيها وجربتها باستخدام سكين سويسرى نفساني.
لكى استوعب طلب الحب على أنه اغتصاب. أقول له إننى أستحم، أو أننى لم أضع المكياج، أو لا أريد أن يرانى الناس على هذا الشكل على أى حال (وأستخدم تعبير «على أى حال» كثيرًا) أو أفضل الاتفاق المسبق على مواعيدنا وأماكنها. ثم يزفر دون أن يرفع صوته، بل يخفضه أكثر.
ثم يكرر طلبه أن أنزل، لأنه ينتظرني. من الواضح أن هذا الأمر - أنه ينتظرنى - يغير كل شيء. فى الحقيقة، لم أفكر فى ذلك قبل أن ينبهنى إليه. إن الفرضية القائلة بأننى سأنزل لمجرد أن شخصًا ما ينتظرنى هى فرضية سخيفة للغاية، وغير مقبولة على الإطلاق.
ولكننى فى الوقت الذى أنكرها فيه أجدها تشق طريقها بداخلي. فأقول لنفسى: مادام أخبرنى بذلك فلابد ألا يكون هذا الأمر سيئا للغاية، أو وقحا، قدر ما سيكون عدم نزولى غير منطقي. وبما أن لديه المفتاح، المتمثل فى تجاهل تجهيزاتى الحربية، فإنه يعطلها، وأعترف أن هذا مثير جنسى شديد.
وفى تلك اللحظة تتعملق الرغبة فى أكون ملكا له، وتقضى على جميع تحفظاتي. إذن لم يكن يمزح حين أخبرنى أنه يجب عليه أن يعيد تربيتى من جديد. يبدو الأمر كما لو أنه لم يستمع إلى ما أقوله.
وإنما يستمع إلى شيء آخر يصدر منى أنا أيضا. لقد ضبط نفسه على قناة سرية أو مشفرة أبث منها معلوماتى على تردد لا يسمعه إلا هو فقط. أنا أظن دائما أنه يخطئ ولا يعرفني، وهو يظن أننى لا أعرف نفسي.
بمجرد أن تركته على الهاتف لسبب لا أتذكره، رحت أبكى طيلة فترة الظهيرة. اتصل بى مرة أخرى فى نفس الليلة وتحدث كأن شيئا لم يكن عن سرقة مكتب البريد التى وقعت قبل بضع ساعات، على بعد مائة متر من منزله. سألته عما إذا كان قد فهم ما قلته له فى الصباح وما إذا كان ينوى أن يكون صديقا لي.
فقال: «آه، ذلك الشيء. ولكنه لا شيء ، سترين»، كأن ما قلته له هو أننى أعانى من التهاب جلدى يضايقني. بعد ذلك لم يعد هناك حديث عن ذلك، كأنها زلة لسان لا تذكر، أو كأننى قد تجشأت على العشاء، ولم أقطع علاقتنا: ولا يزال هو القاضي، والمعالج، وهو من يصلح ما تمزق من زماننا.
وهو الذى يغفر لى وقاحتي. فى نهاية الأمر أنزل، هذا طبيعي، مع رجل آخر لم أكن لأنزل، فالأخر ربما أخطأ كلماته، أو صدق كلماتي، أو صدقني، أو ناقشنى فى النزول وعدم النزول، وعدم الاتفاق على المواعيد أو على الحب. أما هو فلم يصدق مطلقا ظاهر قولي.
وكان يراوغ لتفادى كل طلقاتي. يبدو الأمر، وأنا أمامه، كأنه يرى فى الواقع شخصًا آخر غير الشخص الذى اعتدت العيش معه. وكأنه يرى شخصًا أطيعه فيسبب لى الألم أو عدم الراحة أو سوء الفهم. كما لو أنه يرى طيفًا آخر من الألوان يأتى منى أكثر من الألوان التى أتعامل معها بشكل أخرق.
وكما لو كان عليه التعامل مع ناسخ، أو مزور لا يصدق ما يفعله، ولا يمكن تصديقه هو نفسه، ومطلوب استبعاده بسرعة من أجل الوصول إلى الشخص الأصلي. كأنه يسأل نادلتى فى كل مرة تظهر أمامه: «هل السيدة فى المنزل؟».
عندما أنزل، فى نهاية المفاوضات، وهى مفاوضات أحادية من جانبى أنا فقط، ينظر إلى لبضع ثوانٍ دون أن يتكلم، ثم يضع أنفه بالقرب من المنطقة الواقعة بين خدى وشفتي، فى انتظار أن أقبله فى مكان ما. لا يشعر بإهانة، وليس غاضبا، لا عدوانيا ولا سلبيا.
ليس محققا وليس خاضعا لي. إنه ببساطة يبقى حيث يشعر أنه من الصواب أن يبقى. ينقل النقلة الأولى فى السيارة بتعبيرات صافية، ثم فجأة يضبط مجريات الأحداث بإرادة هى بالطبع إرادته، وهى لهذا السبب إرادتى أنا أيضا.
وليست هناك أية مراوغة فى هذا: إنها إرادة اتخذها لنفسه، تعلمها، وهى إرادة ليست لأحد منا، ولكنه ينقلها لى حتى أتوافق معها. ثم يفعل ما يريد أن يفعله معي، وكأن أحدًا منا لم يعترض. فى تلك اللحظات تختفى كل الحواجز بينى وبين العالم.















