الهوّة التى خلقها انعزال نقاد المؤسسة فى أبراجهم، وانشغالهم بأبحاثهم، تركت المجال للهواة من الكُتَّاب الصحفيين الذين يقدّمون عروضًا صحفيّة للنتاجات الإبداعية.
هذه النماذج القرائية، قدمت إضاءات جديدة لنصوص قديمة، فالجمال كما يُقال أصبح دون أدنى شك «فى عين الرائي» لا فى عين الناقد الخبير أو عالم الجمال.
يستنتج الفخرانى من تكرارية النمط فى قصة ضد مجهول، أن محفوظ كان يعى التقنية التى استخدمها عدة مرات.
كان لتجاور اللغتين العربية والفارسيّة دلالة أخرى تتمثّل فى تكاثف الصّور الشّعريّة، وكأن محفوظ يتاخم بنثره المنظوم حدود الشعر.
يتخذ فتحى عبد السميع من فكرة الخيانة التى هى «أسوأ الجرائم» دليلاً قويًّا على حضور المؤثرات المسيحيّة فى نص محفوظ، فالخيانة «فكرة مسيحيّة» بامتياز، وكان ضحيتها السيد المسيح عليه السلام.
ينتهى القمحاوى إلى أن محفوظ أقرب إلى دوستويفسكى منه إلى بلزاك وأى من الكلاسيكيين من زاوية محاولاته الدائبة لتذويب التيارات الفلسفيّة فى تمثيلات روائية.
الناقدة أشارت عبر قراءتها إلى أن واقع المرأة فى المجتمعات الشرقية مرير، وهو ما دفع البعض لتبنّى قيم المستعمِر، وهو ناقوس الخطر الذى تدقه.
«ليس من معنى حقيقى لنص ما»
بول فاليرى
«النص نزهة يقوم فيها المؤلف بوضع الكلمات ليأتى القارئ بالمعنى»
أمبيرتو إيكو
لا خلاف على الأهمية العظمى للنقد مهما حاول الكثيرون - على مرّ العصور- التقليل من قيمته، باعتبار النقد يشوّه الأدب، وأن الناقد لا يَخلق مثل المبدع، أو أنه عالة على الإبداع، فدوره يأتى تـاليًا للإبداع، كما فعل الجاحظ فى رسالته الشهيرة «فصل ما بين العداوة و«الحسد»، إذْ كَالَ الاتهامات للنقاد، فالناقد عنده، ليس إلا شخصًا قليل العلم، أقحم نفسه فى العلماء، فلَبِس لبوسهم، واتسم بسماتهم؛ ولكنه حين أحسّ العجز فى نفسه عن أن يبلغ مبلغهم، امتلأت نفسه حقدًا عليهم، وحسدًا لهم، ثم أخذ هذا الحسد مظهره الخارجى فى صورة النقد لهم.
والانتقاص منهم» (رسائل الجاحظ: تحقيق وتعليق، طه الحاجري، ص 162)، وليس أدل على أهمية النقد - وهو ما يُنافى كلام الجاحظ المتأخّر - مما ذكره سقراط للقضاة عن الأسباب التى جعلته محبوبًا بين الناس، فعندما جاء ذكر الشعراء والحوار الذى دار بينهما قال: «إنى يا ساداتى لفى خجل شديد،إذ أرانى مُكْرَهًا على أن أقصّ عليكم الحقيقة.

ولقد تناولت الأشعار التى ألّفها أصحابها بعناية فائقة (وكان يظن أنهم فى أشعارهم هذه أكثر إدراكًا لما يقولون) ولقد سألت كلاً منهم عمّا عناه بشعره. فلم يكن منهم مَن استطاع الإجابة عن سؤالى هذا. ولقد جمعنى وإياهم مجلس ضمّ كثيرًا من المعجبين بهم وبأشعارهم، فلم يكن بين الحضور رجل إلا وهو أقدر على التحدث عن تلك الأشعار من الشعراء أنفسهم» (لاسل آبر كُرُمبي: قواعد النقد الأدبي، ترجمة: محمد عوض محمد، 1944، ص 1). معنى كلام سقراط أن المقدرة على تذوق الأدب تختلف عن المقدرة على تحليله أى نقده، وفى تعليق كرومبى على ما قاله سقراط.
والذى يوحى بأن النقد نوعٌ خاص من العمل الأدبى ممتاز عن الأنواع الأخرى، يقول «هناك مقدرة ثالثة لا بدّ أن نضيفها إلى هاتين: وهى المقدرة على نقد الأدب، الذى فى أبسط تعاريفه «عبارة عن أسئلة معقولة يسألها المرء، عن كلّ شيء يتعلّق بالأدب ثمّ الإجابة عنها كإجابة عقلية». وقد ذهب البعض إلى أن موقع الأدب فى الثقافة إنما «يتقرّر بوساطة النقد».
لا أُنكر أن أحدَ أسباب العداء الموجه إلى النقد والنُّقاد، هو انحياز النقد - بصفة عامة- إلى ما يكتبه المختصون من الأكاديميين، ومع شيوع الكتابات الناتجة عن المؤسسة الأكاديميّة فى صورة أبحاث رسائل علميّة (ماجستير ودكتوراه)، وأبحاث ترقية، منشورة فى مجلات محكمة، إلا أن الثابت أن وضعية النقد فى حالة هجوم وعداء دائميْن، والسبب كما يقرّ المبدعون يرجع إلى أنّ ثمة فجوة بين ما يصدر من نتاجات إبداعيّة على اختلاف أنواعها (شعر وقصة ورواية ومسرح) فى مقابل شحوب أو صدود من قبل النقاد لمتابعة هذه الأعمال.
الهوّة التى خلقها انعزال نقاد المؤسسة فى أبراجهم، وانشغالهم بأبحاثهم، تركت المجال للهواة من الكُتَّاب الصحفيين الذين يقدّمون عروضًا صحفيّة للنتاجات الإبداعية، إلا أنها مع أهميتها - كترويج للعمل، أى تدخل فى السياسة التسويقية للمنتج - لا ترقى للنقد المتخصص الكاشف لجوهر النص، كما أتاح الفضاء السبرانى الفرصة لدخول أفواج من القرّاء الهواة لممارسة هواياتهم فى تقييم الأعمال على المدونات الشخصيّة.

ومواقع القراءة مثل أبجد وجود ريدز، فصارت منصات القراءة مجالاً مفتوحًا للمتخصصين وغير المتخصصين فى تقييم الأعمال، وهو ما نَتج عنه الإشادة بأعمال ربما هى فى عرف المؤسسة النقدية لا ترقى للأدب لأنها تنتفى عنها صفة «الأدبيّة» التى اتخذتها معيارًا للحكم على جودة العمل، ومن ثمّ تجاهلتها بعدم رصد اتجاهاتها، أو حتى محاولة تقييمها وتجنيسها وفقًا لآلياتها وخصائصها التى راحت تسترعى فئة كبيرة من القراء.
انزواء النقاد الحقيقيين من أبناء المؤسسة الأكاديميّة، والتوسّع المهول فى منصات القراءة، دفعتا الناقد البريطانى رونان ماكدونالد لأن يُعلن موت الناقد (بالمعنى المجازي)، وبالأحرى فقدان الناقد الأكاديمي، وكذلك الصحفي، مكانتهما ودورهما فى الثقافة الأنجلو ساكسونية خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة».
و(موت الناقد: ص 9)، كما يعزى إلى ثورة الطلاب فى أوروبا عام 1968، الدور الكبير فى خلخلة مسار النظرية الأدبية، وإن كانت فشلت فى هز «أركان السلطة السياسية والاجتماعية فى أوروبا وأمريكا»، والتى من أهم نتائجها، حلول القارئ غير المتخصص (العادي) محل القارئ المتخصص الذى يعمل فى المؤسسة الأكاديمية، أو حتى فى الصحافة السيارة.

وفى المقابل شحب دور الناقد وتضاءل حضوره بسبب ابتعاده عن كتابة ما نسميه فى حقل النقد العربى «النقد التنويري» على حدّ تعبير فخرى صالح فى مقدمته الاستهلاليّة للكتاب، والانزواء صاحَبه انغماسه فى دراساته وبحوثه المليئة بلغة الرطانة التى لا تفهمها سوى نُخب متخصصة عالمة باللغة الاصطلاحية والمفاهيم والمنهجيات.
علاقة العداء بين الكُتَّاب والنقد علاقة قديمة وليست جديدة، فتتعدّد الأوصاف التى يصفونهم بها؛ فهم أصحاب العقول الصغيرة، أو السخفاء المحدودون الجهلاء الذين يقطعون الطريق على العبقرية، أو أنصاف العقول الذين يقعون دومًا فى الثرثرة السطحيّة والكلام الفارغ (بروست)، بل وصل الهجوم إلى مقارنة النقاد بالحيوانات، ففلوبار يشبههم بـ«الحيوانات الطفيليّة وبالخنفساء».
وعند سارتر «يتمتعون تمتعًا مطلقًا بالتفوّق الذى نقرّ به للكلاب الحيّة على الأسود الميتة»، أما فاليرى الذى يسخر من النقاد، بقدر ما يتقى شرهم، فيقول: «إن أحقر الكلاب الصغيرة يمكن أن يُحْدث فيكَ جُرْحًا قاتلاً، يكفى لذلك أن يكون مُصابًا بداء الكلب».
ودائمًا يجأر الكُتَّاب بتجاهل النقد لإبداعاتهم، وهذا طبيعى لو قمنا بإحصائيّة تتناول أولاً، عدد الكُتَّاب مقابل عدد النُّقاد، وثانيًّا، المساحات التى تفردها الدوريات والمجلات والصحف للنقد مقابل المساحات التى تُتيحها للإبداع بكافة أشكاله، لوجدنا فرقًا كبيرًا على مستوى الكم.
وثالثًا هناك نقطة فارقة، تتمثّل فى أن معظم النقاد من الأكاديميين مشغولون بأبحاث الترقية داخل سُلّم الترقى الجامعي، ومن ثمّ جهدهم منصب إلى الأبحاث الأكاديميّة وليس المتابعات السيّارة للإبداع ورصد جديده واتجاهاته.
وهذه عوامل مهمة فى قراءة التفاوت بين ما تنتجه المطابع، وما يتابعه النقاد، لذا فالاتهامات بغياب النقد وعدم ملاحقته للإبداع، ليست - فى معظمها - صحيحة، وإن كانت متغافلة كافة السياقات (والمناخات) التى تجمع بين طرفى العملية الإبداعية.
تيمة الهوية
المتابع للكتابات النقدية يجد أنها تنحصر بين ثلاثة أنواع هي: النقد الأكاديمي، والنقد الصحافي، ونقاد الهواة على منصات القراءة، والغريب فى الأمر أن الكُتّاب يحتفون بالنوع الثالث، وإن احتفوا بالنوع الأول فهم فى حقيقة الأمر غير راضين عن محتواه، ولكن الاحتفاء يأتى من باب إضفاء الشرعية على كتاباتهم من قبل نُقاد رسميين.

ويعملون تحت مظلة المؤسسة الأكاديميّة. أما النقد الصحافي، فهو بمثابة ترويج - ليس أكثر - لأعمالهم. وفى ضوء هذا تفاقمت مشكلة النقد، وزادت الاتهامات بعلو كعبه على الإبداع، لكن هل هذا يعنى أن النقد فى أزمة حقيقية؟ فى ظنى أن الاعتراف بوجود أزمة هو أول طريق لحل المشكلة، وهو ما يسعى إليه المتخصصون بإقامة الندوات والموائد المستديرة والمؤتمرات لتجسير الفجوة بين النقد والإبداع.
من خلال متابعتى لتعامل النقاد والكتاب مع النصوص لفت نظرى أن ثمة اتجاهًا جديدًا، يبعد عن كتابات نقاد المؤسسة الأكاديميّة، يعمد إلى قراءة النّصوص الإبداعيّة قراءة تأويليّة، من زوايا مختلفة وجديدة، تعتبر النص وفقًا للمنهج الفينومينولوجى / الظاهراتى «يعمل كمنظومة هادية إلى القراءة (وبالتالى إلى المعنى).
ولكنها فى الآن ذاته منظومة لا نهائية، مفتوحة، وتحتاج إلى استكمال وتجسيد، وحقيقة النص تقع فى العلاقة بين القارئ والعمل، وهى نتاج الوشيجة الجدلية بينهما»؛ فتتجه القراءة إلى هدف البحث عن المعنى المضمر، أو النمط الفريد الذى يشكّل هذه النصوص؛ فهو يعتبر أن المعنى غير محدّد.
وتحديده يتأتى من «تلك الشبكة المعقّدة من العلامات التى اتكأ عليها المؤلف حين كتب النص» (صبحى حديدي: «ما هى القراءة؟ مَن هو القارئ؟ وكيف التعاقد على المعنى؟»، مجلة الكرمل، ع (63) أبريل 1999، ص 131).
يُولى أصحاب هذا الاتجاه اهتمامًا كبيرًا بالجمالى فى النصوص، سواء أكان فى المضامين أو فى الرؤى أو فى الأشكال، متوسدين بـ«تيمة الهوية» كما هى عند (نورمان هولاند) التى تعنى «أننا عندما نقرأ نصًّا نُمارِس معه عملية تتوافق مع «تيمة الهوية» التى تميزنا.
ونستخدم العمل على نحو يرمز إلينا ويكرّر نفسياتنا فى النهاية، ونعيد صياغته لنكتشف استراتيجياتنا المميزة الخاصّة» (نورمان هولاند: «النقد بصفته تعاملاً»، ضمن كتاب: «ما هو النقد»، إعداد وتقديم بول هيرنادي، ترجمة: سلافة حجّاوي، 1989، ص 242).
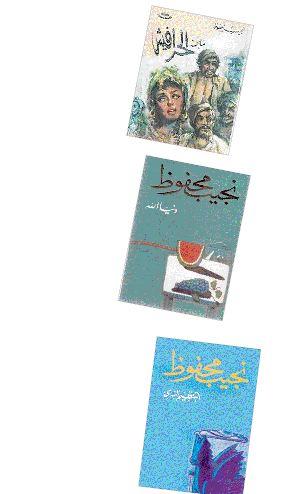
وهو ما يشير إلى العامل الذاتى الداخلى فى تفسير النصوص وتحليلها، وهو الاتجاه الذى أهمله النقد الأكاديمي، وانصرف إلى تحليل شبكة العلاقات اللغوية (أو الألعاب الشكلانيّة بتعبير تودوروف) داخل النصوص.
هذه القراءات التأويليّة التى يعمد فيها القارئ إلى ملء الفراغات (أو المسافة الجماليّة بتعبير ياوس) التى يتركها المبدع فى النص تتأسّس على أن العمل الأدبى كما يقول ياوس: «ليس موضوعًا ينهض بذاته عارضًا الوجه نفسه لكلّ قارئ فى كل فترة تاريخيّة، فهو ليس أثرًا من الآثار التى تكشف عن جوهرها اللازمنى فى نجوى ذاتية».
(رامان سلدن: «النظرية الأدبية المعاصرة»، ص 213)، بمعنى أن النص ليس ثابتَ المعنى، بل هو مفتوح لكل القرّاء فى أى عصر من العصور، وهو ما أكّده أمبيرتو إيكو فى كتابه «القارئ فى الحكاية» (1979)، بقوله إن «بعض النصوص مفتوحة، تتطلب مشاركة القرّاء فى إنتاج المعنى».
وهو نفس المعنى يتكرّر عند فولفجانج آيزر، فى إشارته إلى «أن النصوص الأدبيّة تحتوى دائمًا على (فراغات) لا يملؤها إلا القارئ»، لكن المشار إليه بالقارئ هنا، ليس القارئ العادي، وإنما القارئ النموذجى (بارت، وآيزر) أو القارئ الأعظم (ريفاتير) أو القارئ المفكّك ( إيكو) الذى يمتلك تجربة فى القراءة أو «مخزون التجربة» (بتعبير سلدن).
أو «المقدرة الأدبيّة» (بتعبير ريفاتير) التى تعتبر «مركزية العملية الأدبية»، ومن ثمّ تتحصّل لديه رؤية جديدة، حيث يأخذ القرّاء «النّص إلى وعيهم محولين إيّاه إلى تجربة خاصّة بهم، بما يقومون به من التوفيق بين تناقضات وجهات النظر المتباينة التى تظهر فى النص من ناحية، أو ما يقومون به - بطرائق متباينة - من ملء للثغرات بين وجهات النظر من ناحية ثانية» (رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، ص 210)، دون أن ننسى ما يضعه النص من القواعد، أو بمعنى أدق الإشارات التى يُحقّق القارئ المعنى على أساسها كما يقول سلدن.
وأهم سمة فى هذا الاتجاه القرائي، بما أن القراءة - بتعبير آيزر- «تمنحنا الفرصة لصياغة ما ليس مصوغًا»، هى كسر علمية النقد، أى النّظام الذى كان هوس النُّقاد لإضفاء طابع علمى على ممارستهم النقديّة منذ محاولات «نورث روب فراي» فى «تشريح النقد» (1957)، الذى أسقط القارئ مِن حساباته تمامًا ومحوِّلاً الأدب إلى «عمل طقسى يشبه دورة الفصول، فالأنواع البدئية تتوّزع على فصول السنة.
وكأنها تتطابق مع الطبيعة نفسها» (فخرى صالح: مقدمة «موت الناقد»، ص 11)، كما أنها من ناحية الأسلوب بعيدة - كل البعد- عن التعقيد والغموض الذى كان نقطة الخلاف فى كتابات نقاد المؤسسة الأكاديمية، وفى الوقت ذاته بعيدة عن التسطيح والتبسيط الذى هو أساس الكتابات الصحافية.
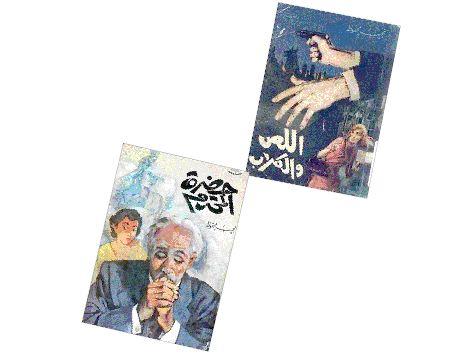
والتى يُمارسها أفراد من غير الاختصاص، أو تلك التى يُمارسها القرّاء العاديون (من غير ذوى الخبرة أو المخزون القرائي) على منصات القراءة كجود ريدز وأبجد وغيرهما، وهى مغايرة - كذلك- للسائد من كتابات المتخصصين أيضًا، فهى تتوسّد العمق مع بساطة التناول، فمعظم الدراسات التى سوف أعرض لها بعد قليل، تتسم بهذا الجانب؛ عمق التحليل مع بساطة الأسلوب البعيد عن المصطلحات النقدية الغربية، ثمّة نديّة للنصوص (بما تمتلكه من وعى ومخزون فى القراءة أو تجربة كبيرة).
وهذه النديّة تعمل على خلخلة وتفكيك النصوص، ثم العمل على إعادة تركيبها فى ضوء الرؤية الجديدة المنبثقة من رؤية العمل الكُليّة، وهى رؤية تقترب إلى حدٍّ ما من معنى النص الكليّ. كل هذه السمات والخصائص عمدت بشكل غير مباشر إلى تقريب القارئ من النصوص.
وإعادة تأويلها من جديد وفق سياقات القراءة الجديدة، بمعنى أنها كانت حافزًا لإعادة قراءتها بصورة ربما تختلف عن رؤية المؤلف، وهو ما يجعل النص منفتحًا (وقابلاً) على تأويلات جديدة ومتعدّدة.
النمط الفريد
سأتوقف عند خمسة نماذج من هذه الكتابات النقديّة، التى كشفت عن قدرات القارئ النموذجى فى تفاعله مع النص، بحثًا عن المعنى الذى - كما يقول جيل دولوز فى تعريفه - «ليس صورة ولا ماهية، وإنما نسق من العلاقات، ولكنه نسق تتغيّر عناصره، وتتعدّد مراكزه.
وتكثر انزياحاته، مما يعنى أن الشيء الذى يعني، لا يعنى بذاته، بل بموقعه ونسبه واختلافه»(عبد العزيز حمودة: «المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك» 1997، ص 242)، وهو ما أدركته هذه النماذج القرائية، فقدمت إضاءات جديدة لنصوص قديمة، فالجمال كما يُقال أصبح دون أدنى شك «فى عين الرائي».
ولا فى عين الناقد الخبير أو عالم الجمال، وهذه القراءات على اختلاف أصحابها على المستوى الجندرى (ذكر - أنثى)، وعلى مستوى المرجعيات : أكاديمى وباحث مقارن (هبة شريف) وأكاديمى لغوى ( داليا سُعودي)، وروائى وصحفى (عزت القمحاوي) وشاعر وباحث فى التراث (فتحى عبد السميع)، وروائى (أحمد الفخراني).
والقراءات حسب الترتيب الأبجدى لأصحابها كالتالي:
• أحمد الفخراني: «تحليل قصة» ضد مجهول «لنجيب محفوظ» وهى منشورة على موقع مدى مصر بتاريخ 19 نوفمبر 2021.
• داليا سُعودى: «قراءة قى رواية «الحرافيش» لنجيب محفوظ، على موقع جريدة الشروق المصرية، بتاريخ 7 أبريل 2022 .
• فتحى عبد السميع: قراءة لرواية «اللص والكلاب» بعنوان «العشاء الأخير فى لص نجيب محفوظ وكلابه»، على موقع باب مصر، بتاريخ 2 نوفمير 2021.
• عزت القمحاوى: تحليل رواية «حضرة المحترم» لنجيب محفوظ، جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ 12 ديسمبر 2021.
• هبة شريف: تحليل رواية «يوم غائم فى البر الغربي» ضمن كتاب «ن. النسوية» (2018) منشورات الربيع.
أحمد الفخراني: والبحث عن النمط الفريد
قدّم الفخرانى تحليلاً لسبع قصص لكُتّاب مختلفين، كالتالي: «رشق السكين» محمد المخزنجي، و«لغة الأى أي»، و«النداهة» يوسف إدريس، و«دنيا الله»، و«ممر البستان».
و «ضد مجهول» لنجيب محفوظ، و«بحيرة المساء» إبراهيم أصلان، لكن من مجموع هذه القصص سأتوقف فقط عند تحليله لقصة «ضد مجهول» لنجيب محفوظ.
و جاءت دراسة الفخرانى بعد قراءته لكتاب جورج سوندرز (A swim in a pond in the rain) عن فن القصة القصيرة، والكتاب فى أصله محاضرات حلّل فيها سبع قصص لأربعة كتاب روس كبار هم: تشيكوف، تولستوي، تورجنيف، جوجول، الكتاب فى مضمونه كما يقول الفخراني.
ويتحدث فى أغلب مقالاته عن قواعد إن اتبعها صاحبها، سينتج رواية أو قصة، لكن فى رأيه (أى الفخراني) أن هذه القواعد، تتغافل أهم قاعدة أساسيّة فى كتابة الفن، ألا وهى مناقشة فكرة الكتابة، ملامسة الجوهر، فاتباع القواعد - حسب قوله - «حوّل هذا الفن إلى مارسون مهرجين وبائعى سلع»، فمثل هذه الروايات المنتَجة ووفقًا لهذه الآليات لا تعين «قارئها على اكتشاف حقيقة، بل تعيد تكرار ما سبق وأن عرفه».

وهذا هو جوهر المقالات، ومن ثمّ سيكون منهجه القرائى البحث عن النمط الفريد لكلّ قصة قرأها على حِدة، وهذا سيتطلب منه اعتماد آليتين فى صيغة سؤالين:
لما فشلت تلك القصة أن تكون جيدة، ولمَ نجحت أخرى أن تكون عبقرية أو ممتازة؟ ومن ثم يتخذ من القاعدة التى أرساها جورج سوندرز فى كتابه A swim in apond in the rain بأن سرد القصص خطوة من جزأين، إثارة التوقع وتلقى الاستجابة.
ومن بين الطرق المستخدمة لحدوث هذا هو أن تسن القصة نمطًا متكررًا (pattern story) آلية له فى القراءة؛ حيث تتكرّر نفس الوحدة لعدد من المرات بطريقة تبدو متشابهة، لكن عبر هذا التكرار ومن خلال تصعيدات دقيقة، يولد معنى مختلفًا عمّا بدأنا به القصة.
الشاهد من المثال الذى يضربه قبل الولوج إلى تحليل قصة ضد مجهول، هو لعبة التلقى والاستجابة، وإن كان يقترب بنا من نظرية التلقى وأفق انتظار القارئ، إلا أنه لا يعمد إلى تغريب نصه بمصطلحات نقدية.
وهو ما يعود بنا إلى سؤال بديهى عن كيف نقرأ النص، بعيدًا عن تلك التعقيدات التى تفرضها النظرية النقدية، على غرار ما فعل رولان بارت فى كتابه «مدخل إلى التحليل البنيوى للقصص»، هنا تغوى أحمد الفخرانى لعبة الفهم والتأويل، فَهم المعنى الذى تبرزه شبكة العلاقات داخل النص، ثم إعادة التأويل فى ضوء فكّ شبكة العلاقات.
وصدى هذا على المخزون القرائى والتجربة، والتأويل يعمد إلى السؤال، وهى آلية اعتمدها عبد الفتاح كيليطو فى قراءة النصوص التراثية، فيعمد دومًا إلى الأسئلة لاستكمال ثغرات النص، من أجل توليد المعنى «الجديد» للنص، على نحو ما حدث فى دراسته «الحكاية والتأويل: دراسات فى السرد العربي».
فحوى قصة «ضد مجهول» يدور حول جريمة قتل يقوم بها قاتل متسلسل؛ سبع جرائم متتالية دون أثر للقاتل المجهول ولا دوافع القتل معلومة، يتعقبه محقّق استثنائى يقرأ الشعر الصوفي.

ويكون فى الأخير هو الضحية السابعة للقاتل. تتجاوز بنية القصة البنية البوليسيّة التشوقيّة، إلى بنية أبعد من العثور على القاتل، إلى التفكير فى معنى الموت الذى يصيب سهمه الجميع.
التيمة التكراريّة التى يعتمدها محفوظ فى النّص عبر سبع حالات يتركها القاتل المجهول، تتمثّل فى أن الجريمة تتم بذات الأدوات التى حدثت بها الجريمة الأولى، وكذلك تقع دون فَهم الباعث، والأهم دون الوصول إلى القاتل.
ويعمد الفخرانى لاستجلاء دوافع كل جريمة على حده (لا توجد أسباب مادية كالسرقة مثلاً)، والضحايا، والآلة المستخدمة فى القتل (الحبل الدقيق)، وخطوات المحقّق فى الكشف عن القاتل (سؤال ذويه وجيرانه والشهود)، ثم نتيجة هذا التحقيق التى تساوى صفرًا، وأثر الجريمة على المجتمع (الفزع والقلق)، ثمّ نهاية الوحدة بإغلاق القضية وتقييدها ضدّ مجهول، تتكرّر جرائم القتل لشخصيات مختلفة (مدرس على المعاش (طبقة وسطى)، لواء متقاعد (ثري)، شابة فى الثلاثين زوجة لمقاول صغير، شحاذ شبه عار (مهمّش)، أفندي، طفلة بالمدرسة الابتدائية، ثم الضابط نفسه» وبالمثل يختفى واعز القتل فى كل الحالات، إضافة إلى أن القاتل ما زال مجهولاً، الشيء الوحيد الذى يختلف من جريمة إلى أخرى.

وهو مكان القتل، الذى يتنوّع ما بين أماكن ضيقة وأماكن واسعة (شقة فى شارع فرعي/ ثم شقة فى شارع عمومي، بيت متوسط بين الجناين، ثم عطفة ملاصقة للقسم (فى دلالة لاقترابه من السلطة)، عربة ترام، ثم حمام إحدى المدارس الابتدائية، وأخيرًا قسم الشرطة (الاقتراب أكثر من السلطة التى توازى القوة) وكأن الموت لا يهاب القوة.
هكذا تتعدّد أماكن الجرائم وتتوزّع على شخصيات مختلفة من حيث الجندر (ذكور / وإناث) ومن حيث الطبقة (طبقة مهمّشة (الشحاذ، والطفلة) وطبقة متوَّسِطة (المدرس والفتاة والأفندي) وطبقة ثرية (اللواء المتقاعد ثم المحقّق محسن عبد الباري).
وهو ما يفتح دلالة أوسع لفهم دوافع القتل غير المعلنة، فالخطر الداهم - كما يقول الراوي- «لم يفرّق بين شيخ وشاب، وغنى وفقير، رجل وامرأة، صحيح ومريض، فى بيت أو الترام،أو فى الطريق.».
وهو الأمر الذى يُقرّب فعل القتل من فعل الموت العادى كما تصوّر الفخراني، هذا التكرار لا يعنى - بأى حال من الأحوال- توحّد الدلالة بل تتبُّع أثر المعنى المتوّلد من التكرارية / النمطية التى لا تخفى تصاعد ما يبرز مع هذه التكراية فى الأحداث.
وهو ما انعكس أثره على الناس بعد الحادثة الثانية، فمثلما ازداد قلق المحقّق، ازداد قلق الناس والمجتمع، المفيد أيضًا هو الأثر الذى يتركه الفعل، ففعل القتل يتحوّل إلى فعل الموت العادى والمألوف، وهو ما تَرمى إليه القصة، فكما يقول الفخرانى «الموت نفسه هو الجريمة».
وهو ما أكده الراوى بقوله «المجرم موجود ، ولعله أقرب إلينا مما نتصوّر» (دنيا الله: ص 98)، والذى لم يعد عاديًّا أو مألوفًا «بل تنزع القصة عنه البداهة ويتضخم أثره الفاجع حقًا»، كما يتخذ من دلالة الحبل الدقيق المستخدم فى عملية القتل، دليلاً على اقتران القتل بالموت «لأن الخنق هو أقرب الطرق لوصف ذلك الموت لا القتل: إزهاق الروح»، واقتراب الموت من السلطة (تارة جريمة بالقرب من قسم الشرطة، وأخرى داخل قسم الشرطة، ولأحد رجال السلطة نفسها) يمثّل تحديًّا لأى قوة تسعى إلى مجابهته.
يأتى موت المحقّق مخنوقًا فى مكتبه، إشارة للتوقف عن التفكير فى القاتل، وأن يتحوّل اهتمامنا إلى مغزى آخر، وهو المعنى المستَشف من غياب الفاعل، وبقاء أثره على أرض الواقع ملموسًا فى صورة الجثث المختلفة، وكما يقول الفخراني، عندئذ « تتحوّل القصة من قصة تشويق عن قاتل متسلسل.

ومن خلال نمط منظم، عبر تعقُّب العلاقات والاختلافات بين الجرائم إلى قصة عن الموت الطبيعي، تنزع عنه الألفة والاعتيادية عبر التذكير بأن الموت فى الأصل جريمة قتل» وهو المعنى الذى يثير استجابة لدى المتلقي، ليتغير منحى تفكيره من السؤال عن الموت إلى مواجهته، ففشل المحقّق فى العثور على القاتل، بمثابة الدافع إلى تجاوز من؟ إلى كيف علينا أن نحيا بكل ما أوتينا بقوة، وألا نتوقف عن مواجهة عدونا الأزلى، مرتكب الجريمة اليومية بكل الطرق: تجاهله ومكافحته عبر العلم والتشبث بكل معنى فى الحياة».
يستنتج الفخرانى من تكرارية النمط فى قصة ضد مجهول، أن محفوظ كان يعى التقنية التى استخدمها عدة مرات، ومع تحفظ الفخرانى على وجود خطة مسبقة قبل الكتابة، لأنها لا تصنع فنًّا جيدًا.
وعنده أن رحلة كتابة عمل فنى «هى أن نمتلك فكرة أو جملة، ثم نعمل على تحسينها مرة تلو أخرى، ومسوّدة تلو أخرى»، ويقرُّ فى النهاية أن محفوظًا لم يبلغ «إتقانه الذى يشبه ميزان الذهب، إلا عبر إدراكه الواعى لشرط الكتابة» وهو: «القدرة على كتابة نص أكثر من مرة، والتحسين المستمر،دون أن يملّ».
هكذا عبر ملاحظة تردد تكرار النمط داخل القصة، ثمّ تتبّع أثره فى تغير المعنى الأولى الذى تتركه القصة فى ذهن المتلقى عبر القراءة الأولى، وتوليد معانى جديدة بردِّ الدوال إلى مدلولاتها، والربط بين الدوال ومحاولة سدّ الثغرات التى تركها الراوي، أعاد الفخرانى قراءة قصة محفوظ، قراءة جديدة، أبعدها عن المعنى الذى استهلكها (أو حشرها) فيه النقد، وهو نمط القصة البوليسيّة، إلى قصة فلسفيّة ذات معانٍ مضمرة تتجاوز فكرة البحث عن القاتل، الذى لم يكن هو هدف القصة من الأساس، معتمدًا على التلقى والاستجابة.
وتتبُّع الدوال المتمثِّلة فى تكرارية النمط، وملاحظة درجة ثباتها وتغيّرها، وأثر هذا التغير فى استنتاج معنى أبعد من المعنى المباشر، عبر التأويل، لكن المهم جدًا أنه توصّل فى النهاية إلى الصنعة، وكيفية الكتابة، فإن كان فى الشق الأول بحثَ عن كيف نقرأ؟ فالنتجة آلتْ به إلى الوصول إلى كيف نكتب.

وهو ما استدركه مع نهاية التأويل الجديد، الذى صاغ به معنى القصة، أو ما تودّ أن تقوله القصة بالمعنى الدقيق، وهنا صار القارئ / المتلقى وفقًا لما تقول نظرية استجابة القارئ، مشاركًا فى كتابة النص، بعد صياغته برؤيته الخاصة التى كانت إيجابية.
داليا سُعودى والبحث عن أناشيد والروح فى ملحمة الحرافيش.
قدمت داليا سُعودى على مدار ثلاث حلقات فى جريدة الشروق المصرية بدءًا من تاريخ 4 أبريل 2022 إلى 2 مايو 2022، قراءة جديدة لرواية الحرافيش لنجيب محفوظ، القراءة الأولى كانت بعنوان « قراءات فى ملحمة الحرافيش القراءة الأولى ... خواطر ليلة بيضاء»، والثانية بعنوان «قراءات فى ملحمة الحرافيش القراءة الثانية.
فى جماليات التكرار»، أما الثالثة والأخيرة، فهى بعنوان «قراءات فى ملحمة الحرافيش القراءة الثالثة: أناشيد الروح»، تشترك العناوين الثلاثة فى أنها ترجّح مفردة «قراءات» بصيغة الجمع، وهو ما يعنى تعدّد الدلالات للنص الواحد، أما الاختلاف فيكمن فى نهج القراءة، فالقراءة الأولى أقرب إلى القراءة الانطباعية.
وتحكى ملابسات تأثير الرواية عليها، منذ بداية التعرُّف عليها، أما المقالة (القراءة) الثانية، فهى تميل إلى القراءة الأسلوبيّة، حيث تتبعت تكرار أنماط أسلوبية داخل الرواية، وعبر هذه الأنماط تنتهى إلى الدلالة الكاشفة لجوهر النص.
والتى تبرز بصورة واضحة فى القراءة الثالثة «أناشيد الروح» ومن العنوان، نستشف أنها قراءة أقرب إلى الروح الصوفيّة التى أغرق بها محفوظ المتن الروائى عبر الأشعار الفارسية.
وفى قراءتها الأسلوبية، تُلمّح إلى صنعة محفوظ المتقنة؛ حيث دقته المتناهية فى اختيار الأسماء التى تأتى اسمًا وفعلاً معكوسًا لرواية «أولاد حارتنا»، واستعارة أولاد حارتنا ليس اعتباطًا، وإنما له دلالته التى ترنو إليها من هذه القراءة المتأنية والفاحصة لكل عبارة وجملة ومفردة داخل نص الحرافيش.
تسرد فى المقالة الأولى علاقتها بالرواية، وسبب تأخّر قراءتها، لأنها فضّلت عليها أعمال أخرى لنجيب محفوظ كانت تظنها أَوْلى بالاهتمام، وتذكر منها الثلاثية (الاجتماعية) التى تراها أشبه بـ «حائط الصدّ الذى قد يتعثر أمامه القادم المتسرع الملول الذى تجاوز فى قراءاته الرواية الواقعيّة.
وظن مغترًا أنها رواية محضّ واقعية»، ومن هذه الأعمال تذكر -أيضًا- «أولاد حارتنا» (1959) والتى تصفها بأنها «الرواية المحرّمة جلّابة الصّخب وذريعة السكين»، ثم «اللص والكلاب» (1961)، هكذا جاء تأخر قراءتها للحرافيش (1977) لحساب أعمال أخرى، حتى قبضت عليها فى ليلة حالكة السواد وحولتها إلى ليلة بيضاء.
ولا أرق فيها ولا تسهيد، بل متعة خالصة وسفر فى المكان والزمان إلى حيثما التقطير الصافى لرحيق الحكمة الأبدية»، هكذا تكشف لنا عن تلقيها الرواية، وتأثير هذا التلقي، ثم الاستجابة لفعل الرواية بعد أن فرغت من قراءتها، حيث كما تقول «جلستُ بعد إشراق الشمس، أرسم شجرة عائلة عاشور الناجى وأتأمل الأسماء والمصائر»، (ملحوظة: الشجرة مرفقة بخط اليد فى المقالة).
فعل الاستجابة عندها يتحوّل إلى خلق أو تأويل جديد لكل ما يرد فى النص، فلا تأخذ الأسماء بدلالتها الظاهرية (المباشرة) كما هى فى النص، وإنما تقدِّم تأويلات جديدة للأسماء، تعيد بها تأويل معانى الأسماء وفق سياق بنية نص (الحرافيش)، مقارنة بالنص الأكبر (أولاد حارتنا).
ومن هذه الأسماء اسم «عفرة» الذى تراه مقلوبًا لاسم «عرفة» فى «أولاد حارتنا»، وهذا القلب أعطى للاسم دلالة جديدة، فتقول فى تفسير سيميائى لدلالة الاسم: «لا يشير اسمه فحسب إلى التراب الذى خُلق منه آدم شبيه عاشور، لكن اسمه يذكّرنا بعرفة فى أولاد حارتنا، إلا أن الشخصيتيْن على النقيض تمامًا، فعرفة عاشور كبير العائلة إذ يجسد «عرفة» الموصوف مرارًا بأنه «حاد البصر» المعرفة العقلية الخالصة.
وينتهى علمه كأداة رخيصة فى يد السلطة الغاشمة لاستذلال أهل الحارة»، وعلى النقيض يجسّد الشيخ «عفرة» الكفيف فكرة إحلال البصيرة محل البصر. ثم تستكمل فكّ الدلالة اللُّغوية للأسماء «ما أشدّ التنائى بين «عرفة» و«عفرة».
ولعله سرّ الجناس المبثوث بين اسميهما»، هكذا تستمر فى تأويل جديد للأسماء: عاشور، شمس الدين، سليمان، بكر وخضر، وحيد الأعور، وآخرين، ومع كل اسم تقدم دلالته وأثره فى فهم سياق النص.
تتعدّد أشكال التكرار داخل النص، والذى يأتى فى صورة كلمة تتكرّر داخل الفقرة الواحدة، لتجعلها أكثر ترابطًا على مستوى بنيوى مصغّر، فمثلاً كلمة همسة تكررت 7 مرات داخل إحدى الفقرات. وهناك نوع من التكرار.
وهو ما تقول عنه إنه الأقل شيوعًا، وإن كان أبدى محفوظ براعة كبرى فى استغلاله، وهو تكرار الكلمة / الدلالة ذاتها على مستوى بنيوى كبير، قد يمتد ليشمل الرواية بأسرها، على نحو ما صنع باستخدام مفردة (كلا) حرف الزجر والردع والاستنكار، فمحفوظ يستخدمها لتأتى منفردة مدوّية، مشحونة بالغضب كقذيفة صوتيّة من الرفض البات فى حوارات عديدة، إذْ تقوم الملحمة فيما تقوم.
وعلى صراع الأهواء المتعارضة والمصالح المتضادة، وكأن (كلا) التى ترد فى مواضع الصدام ما هى إلا «محاكاة صوتيّة لصراع نبابيت متخيّلة، أو هى القنبلة التى تتفجر فى الحوار المحتدّ المحتدم»، ثم تُعدّد مواضع صدورها داخل النص.
ومن أشكال التكرار التى ترصدها القارئة / الناقدة تكرار العبارة، فكما ذكرتْ من قبل أن الرواية بالغة التكثيف، ومع هذا فثمة تكرار لبعض العبارات، إلا أنها تستنتج من تكرارية العبارات أنها تُستخدم كدلالة بلاغيّة ونفسيّة؛ فهى «بلاغيًّا أداة موسيقيّة تشيع فى النص الشاعرى جرسًا صوتيًّا يشبه ذلك الذى تؤدّيه اللازمة اللحنيّة بين مقاطع الأغنية، أو لعله القرار الموحّد المصاحب لجواب متغيّر.
ويشيع دعمًا إيقاعيًّا توافقيًّا». ومن الناحية النفسيّة، يشى التكرار بالصّراع الداخلى الذى تعيشه الشخصية «سليمان لن يتغير»، كرّرها الراوى على لسان الفتوة سليمان خمس مرات.
الشكل الأخير الذى ترصده من أشكال التكرار فى الرواية هو تكرار الحرف، فالسّجع البادى فى عبارات محفوظ تنفى أن يكون له علاقة «بسجع الكهان وكتبة التراث»، هنا السجع المحفوظى يُفارِق التكلّف الظاهر الناتج عن السجع، ويقترب من الفاصلة القرآنيّة.
وقدرتها على ربط المبنى بالمعنى، بما تحمله من شحنتيْن متلازمتيْن: شحنة من الواقع الموسيقي، وشحنة من المعنى المتمم للفكرة العامة، وهذا ما تستدله من تكرار حرف الراء. على الرغم من توقّف القارئة / الناقدة عند البنية الشكلية للرواية، سواء على مستوى دلالة الألفاظ، ثم أشكال / أنماط التكرار داخل المتن، إلا أن هذا التناول لم يكن بغرض استعراض حرفية الكاتب.
وهو ما لا مراء فيه - وصنعته المتقنة، التى تضع كل كلمة فى موضعها، بقدر ما كانت تروم إلى استنباط المعانى الداخلية / المضمرة من وراء هذا اللعب اللغوى الذى يرمى إلى دلالات بعيدة، لم تقترب منها الدراسات التى تناولت رواية الحرافيش، ثم يكون هذا اللعب اللغوى مقدمة لاستكشاف الجماليات الداخلية المتمثّلة فى المعنى العام للرواية.
وهو ما جاء فى المقالة الثالثة المعنونة بـ «أناشيد الروح»، حيث تسعى من خلال تفكيك شيفرات الأناشيد التى ترددت داخل الرواية، للوصول إلى الدلالة، خاصة أن الأناشيد جاءت بلغة أعجميّة (الفارسية) وهو ما يُسبّب غرابة للقارئ، بل يهدم طموح محفوظ نفسه، فحسب داليا سعودى أن «نجيب محفوظ» كان يسعى إلى أن يكون للغة العربية ملحمتها على غرار اللغة الأكدية (ملحمة جلجامش)، واليونانية (الإلياذة والأوديسا)، والدليل عندها على رغبة محفوظ (غير المعلنة) أنه آثر اللغة الفصحى فى ملحمته، بما فى ذلك الحوار.
لم يأتِ الإعجام الذى تخلّل النص الفصيح ضرب عشواء، وإنما له دلالته الكامنة والكاشفة، فهو كما تقول القارئة / الناقدة «يحيط شاعرية النص بحالة من الغموض والإبهام الذى يحفّز على التفكير فى أسرار الغيب وأسئلة الماورائيات»، ومن ثم يحوّل «واقع الحارة إلى واقع أسطوري، لا تصل إلينا سرديته بصورة مباشرة فجّة.
وإنما من خلال غلالة صوفية جمالية»، وثانيًا: كان لتجاور اللغتين العربية والفارسيّة دلالة أخرى تتمثّل فى تكاثف الصّور الشّعريّة، وكأن محفوظ يتاخم بنثره المنظوم حدود الشعر، بل المعنى الأبعد الذى تستشفه القارئة / الناقدة، أن هذا التجاور يمنح اللغة من سلطة الفصل، أى بمثابة السور الفاصل بين التكيّة والحارة، فيجعل لغة أهل التكيّة هى الشعر، وبالأحرى الشعر الفارسى الصوفي.
ومقابل لغة أهل الحارة العربية وإن كانت فصيحة، فيكون أشبه بسور فاصل بين الحارة المنغمسة فى مادية الحياة، مقابل التكية الغارقة فى «فضاءات الروح».
ترى الناقدة أن محفوظ الذى حمّل نصه بالإيحاءات والإشارات والرموز، لا ينتظر قارئًا عاديًّا، وإنما قارئًا نشيطًا يسعى هو إلى استقبال النص بوعى يفكّك من خلاله الغموض ويردّ الرموز إلى دوالها، لفهم معنى النص فهمًا عميقًا أو قريبًا من المعنى الذى ضمّنه المؤلف لنصه، فالدلالة المستشَّفة من هذا التجاور كما تقول.
وكأننا بصدد كورال مسرحى يُعلّق على الأحداث كما هو الحال فى المسرح الإغريقي، ثمّ تربط بين دلالة الشعر الذى يتردد فى التكيّة، وما يحدث من أحداث خارج التكيّة / فى الحارة، فكلّ نص شعرى مرتبط بسياق حادثة معينة وظرفها.
وهو ما ينطبق عليه تأويلها السابق بأن الأشعار بمثابة الكورال الذى يُعلّق على الأحداث، وهو يعنى أن ثمة ترابطًا بين الشعر الصوفى الذى جاء بلغة مغايرة لغة النص، واللغة الفصيحة المكتوب بها النص، وكأن كلاهما بنية متضافرة، لا يستقيم المعنى لأحدهما إلا بحضور الثاني.
دراسة الدكتورة داليا سُعودي، على الرغم أن الناقد يستشف منها اتكاءً منهجيًّا على مناهج سياقية / نصيّة كالأسلوبيّة والسيمائيّة والتأويليّة، لكن وعى الكاتبة بأن جمهور الجريدة (المنشورة فيها المقالات)، هو ضمن شريحة القارئ العادي، وليس المتخصص.
وفلم تبرز تفوقًا واستعلاءً باتكائها على مصطلحات هذه المناهج، وإن كانت حاضرة بقوة فى التحليل، لكن الأهم أنها استفادت مما تقدمه هذه المناهج من كشف وتحليل للنص، أكثر من استفادتها من ترديد مصطلحات غامضة.
ولاتعنى - من قريب أو بعيد - القارئ العادي، وهو لا يقلّل من أهمية التحليل أو يوحى ببساطته، بل على العكس فهو من العمق ما أتاح إبراز الجوانب الخفيّة فى النص، وهذه البساطة فى التناول مع العمق فى استبصار المعانى قدرة لا تتأتى للكثيرين.
فتحى عبد السميع واستنباط والمؤثرات المسيحيّة
على خلاف جميع النقاد الذين تناولوا رواية نجيب محفوظ «اللص والكلاب» (1961)، والذين ردوها مباشرة إلى قصة السفاح الشهير محمود أمين سليمان، والذى لقى مصرعه فى مواجهة مع الشرطة عام 1960، جاءت قراءة الشاعر فتحى عبد السميع للرواية، حيث ربط بين الرواية والمؤثرات المسيحيّة.
وهو الأمر الذى لم يلتفت إليه الباحثون والنقاد كما ذكر، وإزاء غياب مثل هذه الدراسات انبرى هو بإظهار هذه المؤثرات فى أعمال محفوظ، وتحديدًا على روايته «اللص والكلاب».
ولأن محفوظ لا يريد محاكاة الحياة الفعليّة للسفاح، كما يقول فتحى عبد السميع، اختار محفوظ شخصية نور، التى لا تنتمى إلى حياة السّفاح، وإنما هى شخصية متخيّلة، قام الكاتب برسمها لتلعب دورًا فنيًّا معينًا يخدم رؤيته، وهى رؤية البطل الحقيقى لا الحياة الفعليّة للسفاح.
استعرض فتحى عبد السميع لجوهر فكرته عبر ثلاث مقالات نُشرت على موقع «باب مصر»، المقالة الأولى بتاريخ 2 نوفمبر 2021، بعنوان «العشاء الأخير فى لص نجيب محفوظ وكلابه»، والثانية بتاريخ: 9 نوفمبر 2021 بعنوان «نجيب محفوظ وفتنة اللعب بيهوذا الإسخريوطي»، والثالثة والأخيرة جاءت بتاريخ: 16 نوفمبر 2021، بعنوان «مريم المجدلية وبطرس الرسول فى اللص والكلاب».
ومن عناوين المقالات الثلاث، نكتشف هدفه وهو البحث عن المؤثرات المسيحيّة المضمرة داخل الرواية، فيقول إن محفوظًا اعتمد على قصة المسيح عليه السلام، كما وردت فى الأناجيل المعتمدة من الكنيسة، فقام باستحضار شخصية السيد المسيح.
وشخصية يهوذا الإسخريوطي، ومريم المجدلية، وبطرس الرسول وتحديدًا فى قصة العشاء الأخير»، وبناء على هذا الافتراض، يسعى إلى تأكيده من خلال تأويل الحكاية وفقًا لهذه الرؤية، وإن كان يؤكد على «أن المؤثرات المسيحية لم تعتمد على الإشارات الصريحة، بل جاءت ذائبة فى كيان الرواية».
تبرز الاختلافات بين شخصية السفاح الحقيقية والمتخيّلة كدواعٍ فنيّة لجأ إليها المؤلف (وهو ما ينفى عكس الواقع كما سعى البعض لتأكيد هذا فى قراءته للنص) جاء ليمرّر رؤية خاصّة به، أبعد من حكاية الانتقام من الخونة التى ردّدها النُّقاد، فالسفاح فى الحكاية الحقيقيّة بعد أن هرب من السجن.
وبعدها ذهب إلى شقة شرطي، وسرق بدلته الرسميّة، ليقوم بالدور الذى خطّط له. أما فى الحكاية المتخيّلة، فالسفاح خرج بطريق مشروع، وهو العفو بمناسبة عيد الثورة، كما أنه قام بحياكة البدلة بنفسه، فكما يقول فتحي «لقد تعلّم فى السجن كيف يكون ضابطًا».
وإضافة إلى أن جريمة السّفاح فى الواقع كانت أقل شأنًا من الحكاية المتخيّلة، فالقتل فى المرة الأولى كان عن طريق الخطأ، أما فى الحكاية المتخيّلة، فكان عمدًا، فقتله شعبان حسين الساكن الجديد، كان يقصد به قتل عليش سدرة.
يتخذ فتحى عبد السميع من فكرة الخيانة التى هى «أسوأ الجرائم» دليلاً قويًّا على حضور المؤثرات المسيحيّة فى نص محفوظ، فالخيانة «فكرة مسيحيّة» بامتياز، وكان ضحيتها السيد المسيح عليه السلام، والأبشع أنها جاءت من أقرب أصدقائه (يهوذا الإسخريوطي).
وهو ما يتكرّر عند محفوظ فالخيانة جاءت من صديقه (عليش سدرة) وزوجته (نور)، كما أن العلاقة الملتبسة بين الأنا والآخر تظهر بجلاء فى «سيرة السيد المسيح مع تلاميذه». استدعاء محفوظ لنموذج يهوذا الإسخريوطى كنموذج للمجرم فى الثقافة المسيحيّة، فهو التلميذ المقرّب، وأمين صندوقه الذى خانه.
وقام بتسليمه إلى اليهود، لم يعكسه محفوظ بصورة مباشرة (آلية) على شخصية السّفاح، وإنما تمّ استدعاؤه من «أجل الآخرين الذين تسكنهم روح الشرير النموذجي، ويعيشون بلاد مطاردة»، بمعنى أنه تمّ استدعاؤه «كمرآة تكشف البراءة الكامنة خلف قناع الجريمة، والشر الحقيقى المتخفّى خلف قناع البراءة».
محاولة الراوى أن يُقرّب أوجه الشبه بين اللص ويهوذا، والتى ظهرت فى الحلم، ما هى إلا حيلة فنيّة لإخفاء الروابط المباشرة بين الرواية والمؤثرات المسيحيّة، ومع هذا فلا يستعير محفوظ من التراث المسيحى فكرة الخيانة وفقط، بل يتكرّر استحضارات التراث المسيحى بصيغ متعدّدة مثل «فكرة العباءة» حيث المسيح كان يعرف ما فى نفس يهوذا.
وأنه كشف أمره لبعض المقربين ولم يفضحه أمام الجميع، وهذه الفكرة حاضرة عند الصحفى (رؤوف علوان) الذى اكتشف سرقته ولم يبلغ عنه الشرطة وتركه يمضي، وكانت هذه انتهازية ميكافيلية لاستغلال سعيد مهران لأغراضه فيما بعد.
وهو ما يتكرّر مع شخصية نور تلك الفتاة العاهرة التى فرّت من الصعيد وهربت إلى القاهرة حيث الأضواء والمساحيق الكاذبة. ومع أنها غيّرت حياتها تمامًا، كنوع من الانشقاق والانفصال عن كل الصلات التى تربطها بتاريخها، لذا نرى نجيب يعمد إلى حيلة ذكية بإعطائها اسمًا جديدًا بدون لقب.
وكتأكيد على هذا الانفصال وقطع الصلات مع واقعها / الحقيقي، الذى تخلت عنه، ولا نعرف أسباب هذا التخلّي، فالروابط بين شخصية نور وشخصية مريم المجدلية متحققة أكثر فى اللغة كما يقول فتحى عبد السميع.
وهناك «البدلة» التى تركها سعيد مهران فى الشقة وتحركت الشرطة إليه عبر أنوف الكلاب، شبيه بالكفن الذى تركه المسيح فى القبر قبل صعوده، والكفن كشف اختفاء المسيح، وبطرس الرسول تماثل مع إنكار الطفلة ثناء لأبيها.
من المؤثرات التى جاءت غير مباشرة بين نص محفوظ والتراث المسيحي، شخصية نور التى تتوازى مع مريم المجدلية، فنور هى الفتاة الهاربة من الصعيد إلى القاهرة، وهناك غاصت فى حياة الليل، المملوءة بالدعارة والمساحيق الكاذبة، تتقاطع مع شخصية مريم المجدلية التى عرفتها المسيحية بوصفها العاهرة التائبة.
فمريم لا يعرف لها صلات عائلية وبالمثل نور، ومريم كانت تتبع المسيح، وأيقنت أنه «نورها الذى لا ظلمة فيه البتة»، ونور كانت عاشقة لسعيد مهران، واعتبرته المخلّص الذى منحها «فرصة ذهبية لتبدأ حياة جديدة، فربطت حياتها بخدمته حتى لحظاته الأخيرة».
المؤثر المهم الذى يربط بين نص محفوظ والتراث المسيحي، هو اللغة؛ فمحفوظ استخدم ذات اللغة التى ترددت على لسان مريم المجدلية، والسيد المسيح، وبطرس الرسول، فيشير فتحى إلى كلام نور، ويقول: «إن مَن يدقق فيه وفى رأسه صورة مريم المجدلية سوف يشعر بحضورها القوى فى كلام نور وهى تتحدث».
وبالمثل مَن يقرأ الرواية وفى مخيلته صورة المسيح، يستشعر بحضوره القوى فى كلام سعيد مهران وهو يتحدث عن نفسه، ومن ثم تتراجع صورة المجرم أمام صورة النبي، ومن هذا: «إن من يقتلنى إنما يقتل الملايين، أنا الحلم والأمل وفدية الجبناء.
وأنا المثل والعزاء والدمع الذى يفضح صاحبه» (اللص والكلاب ص: 148)، ويتكرر استحضار السياق اللغوى فى كلام سناء ابنة عليش سدرة التى تنكر أبيها، كموازاة لكلام بطرس الرسول الذى أنكر السيد المسيح. النمط الأخير من حضور المؤثرات المسيحيّة فى رواية محفوظ كما يشير فتحى عبد السميع، يتجلى فى نمط تكرار عبارة «أنكرتنى البنت» التى رددها عليش سدرة، وجاءت بصيغ متعدد: أنكرتنى ابنتي، المقابلة التى أنكرتنى فيها ابنتي، واسألى البنت التى أنكرتني، المحبوبة رغم إنكارها لي، كما أنكرتنى ابنتي» ، فتكرار الحدث عدة مرات بامتداد الرواية يستشف منه فتحى عبد السميع.
أنه «يعمل كدعامة خفية تربط البطل بالمسيح، لكن السارد يحرص أن يكون الربط خفيفًا، وخفيًّا بدرجة كبيرة السارد يستخدم من تاج الشوك شوكة واحدة فقط كى يضفى على بطله قدْرا من الجلال، ويحرره من قناع الشرير الأسطوري».
ينتهى عبد السميع إلى التأكيد بأن «الفارق بعيد جد بين موقف بطرس الرسول وموقف الطفلة. والحرص الفنى المتكرر على نفى أو استبعاد التطابق، يعبر عن رؤية لا ترغب فى جعل سعيد مهران مساويا للمسيح وإن قاربت بينهما، ربما بسبب فشل فكرة الخلاص الفردي.
ولكن التداخل بين الشخصيّات والرموز المسيحية ساهم بنجاح فى تحرير البطل من صورة الشرير الأسطورى التى رسمتها له الآلة الإعلامية، وقدّم دعمًا فنيًّا قويًّا للرواية وهى تسعى إلى تحرير المجتمع من أقنعة أخرى».
عزت القمحاوى ونظرة جديدة لحضرة المحترم
النصوص عند الكاتب الروائى عزت القمحاوى أشبه بطبقات، وكلما أعدت القراءة اكتشفت جديدًا مخبئًا تحت الطبقة، وإن كان ثمة علامات تحيل إليه، فى مقالة له بعنوان لماذا نقرأ نجيب محفوظ الآن؟ نُشرت بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 12 ديسمبر 2021.
أعاد قراءة رواية «حضرة المحترم»، كإجابة عن سؤاله الذى عنون به المقالة، وكان سياقه مختلفًا، حيث التنافس بين دور النشر للفوز بنشر أعماله، فى تأكيد على تزايد مقروئية الرجل من أجيال مختلفة.
وبعد مقدمة قصيرة يستعرض أجواء التنافس بين دور النشر (الشروق، ديوان، مؤسسة هنداوي) على الحصول على حق نشر أعماله، يطرح السؤال مباشرة: لماذا نقرأ نجيب محقوظ الآن؟ على غرار سؤال كالفينو لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟ فنجيب محفوظ يعد بالنسبة للأجيال الجديدة كلاسيكيّا بالمعنى الذى قصده كلفينو.
ومع هذا فثمة مقروئية كبيرة له (وغير متوقعة) بين أبناء هذا الجيل المختلِف التكوين الثقافى والذائقة الجماليّة، ويكمن الجواب فى أن «المخفى فى روايات وقصص نجيب محفوظ كثير، تفاجئنا طبقاته من قراءة إلى أخرى.
ولا يقتصر الأمر على رواياته الكبيرة، بل يشمل جميع رواياته حتى تلك التى طالما نظر إليها النقد بوصفها من الروايات البسيطة»، ثمّ يضرب مثالاً برواية حضرة المحترم التى كتبها محفوظ عام 1975.
يقدّم عزت القمحاوى قراءة مغايرة للرواية؛ قراءة مُدقِّقة متأمّلة، تتجاوز النظرة السطحيّة (التى تعامل بها النقاد) وكذلك تنجو من التأثّر بنظرة النقاد لها، قراءة بعين الرائى الذى يبحث عن الجمال المخبوء بين طيات النص، ومن ثمّ لا يتعامل مع النص تعاملاً سطحيًّا على نحو ما تعامل النقاد؛ الذين رأوا الرواية ليست من الروايات المحفوظيّة المهمّة.
والبنية الظاهرية للنص التى قدمت بطلاً قطع عمرًا مديدًا فى درجات سُلم الترقى الوظيفى من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الأولى، موظف يسعى باجتهاده الشخصى وقدرته على التعامل مع البيروقراطية الوظيفيّة، كى يحقق أعلى طموح له، متناسيًّا فى سبيل ذلك حياته الشخصيّة.
وأين تكمن السعادة؛ توحى بتلك المعانى (المباشرة) التى استخلصها النقاد فى قراءتهم للنص، لكن القمحاوى يرى عكس ذلك، ربما من واقع خبرته كروائي، لا يقدم نصًّا مجانيًّا للقارئ، وربما بحكم موقعه كقارئ محترف ينأى بنفسه من الوقوع فى فخ القراءة البسيطة والسطحيّة.
وإنما يبحث عن رسالة عميقة، من بين ثنايا الأسلوب السّهل والمباشر الذى بُنيت عليه الرواية، فاستجابته كمتلق تجاوزت البساطة إلى النظرة العميقة، وربما لوعيه بإمكانات محفوظ نفسه البنائية فى تشكيل النص - بناء على قراءاته المتكرّرة لمعظم أعماله.
وأيضًا فلسفته التى لا تنظر إلى الأشياء بتلك النظرة السطحية، وإنما وراء البنية السهلة والشخصيات الواضحة عوالم خفيّة، وأسرار غير متناهية، قد تبرز فى جملة أو موقف، وبناء على هذا كله فعنده هى رواية «مخادعة.
والرواية تبدو سهلة بهذا المعنى الأولى للقراءة غير الناظرة للبعد الفلسفى الذى يرمى إليه محفوظ، عبر رحلة صعود هذا الموظف، وتخليه عن إحساسه بكيف تُعاش الحياة، وتُدْرَك لذتها، وهى فكرة لها أصل فلسفى عند الفيلسوف الفرنسى ميشيل دو مونتينى فى كتابه «المقالات»، فكما يقول القمحاوى إن الرواية يقع «على سطحها كل التفاصيل الدرامية التى تعشقها السينما والدراما التليفزيونية؛ فهناك الكفاح الملحمى لشاب من قاع المجتمع.
ووصولية ونفاق الموظف، وقصص الحب والعلاقات الغرامية!»، لكن هذا هو سطح الرواية أما جملتها الأساسية، أو رسالتها المبطنة فى شكلها الظاهر، فهى غير ذلك تمامًا.
هكذا يضرب القارئ / القمحاوى بالقراءات السابقة عرض الحائط، وإن كان لا يخطئها، أو يقلل من قيمتها، فكما يقول كل هذا صحيح، لكن نظرته تأخذ منحى آخر، بحثًا عن البُعْد الفلسفى فى رسالة الرواية، المتمثّل فى ضرورة اختبار المذهب الإنسانى فى الفلسفة الذى يتفرع لاتجاهات مختلفة تشترك فى أصل عريض ولد فى إطار الثورة على تغول الكنيسة، جاعلاً من الإنسان مركزاً للكون، ومن الكفاءة طريقاً للتحقّق، ومن الاستدلال العلمى طريقًا للحقيقة.
فيتخذ من دلالة اللغة المشفرة (سبق أن اختبرت هذا داليا سعودى، وكذلك فتحى عبد السميع هذه البنية فى قراءتيهما للحرافيش واللص والكلاب) التى يتعامل بها محفوظ مع نصوصه دليلاً على ما تخفيه من معانٍ مضمرة، ينبهنا القمحاوى عند قراءة محفوظ وبالأحرى عندما نكون فى حضرة المقام المحفوظى (إن جاز لى القول) إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار بأساسيات مهمة تضيء القراءة.
ومنها الاستهلال الذى يفتتح به محفوظ مروياته، فهو أشبه بالمفاتيح للصناديق المخفيّة بالداخل، فكما يقول: «من الجملة الأولى فى هذه «النوفيلا» نستشعر مجازًا مختفيًّا فى اللغة يجعل من غرفة المدير أمثولة للحياة كلها.
ومن المدير شخصاً كلى القدرة: فينفتح المشهد هكذا «انفتح الباب فتراءت الحجرة متنامية لا نهائية. تراءت دنيا من المعانى والمثيرات لا مكاناً محدوداً منطوياً فى شتى التفاصيل. آمن بأنها تلتهم القادمين وتذيبهم».
كان وراء رحلة صعود الموظف النموذجي، هدفًا أسمى من الترقى إلى الدرجة الأولى؛ هدفًا مضمرًا، يكمن فى تحقيق «الألوهية على الأرض»، وهو ما كشف عنه فى حواره مع رئيسه حمزة السيوفى فى مناقشة عابرة. هذا الهدف الذى أعلن عنه عثمان بيومي، أى تحقيق الألوهية على الأرض، كما يقول عزت القمحاوى هو هدف الإنسانيون.
وعلى الفور يستدعى تردده عند دوستويفسكي، ويقول: «لقد اختبره فى الجريمة والعقاب، عبر عبادة القوى الغاشمة، فى حين محفوظ فى «حضرة المحترم» يختبره «عبر المهارة والصبر والحيلة، تمصيرًا لطموح الإنسان السوبر مان» (كما هو عند نيتشه). حيث «يتناغم سعى بطل محفوظ مع ثقافة بيروقراطية مصرية تبدأ من الفراعنة».
هنا يكشف القمحاوى عبر هذا التحليل فلسفة محفوظ الحياتية، بل يربطها بفلسفة دوستويفسكى وإن كان يفرق بينهما فى مظانها الأساسية، فنجيب محفوظ يعود إلى ميراثه الفرعونى والتقاليد الفرعونية فكما يقول عثمان بيومى وهو يتحدث إلى نفسه «الوظيفة فى تاريخ مصر مؤسسة مقدّسة كالمعبد.
والموظف المصرى أقدم موظف فى تاريخ الحضارة، إن لم يكن المثل الأعلى فى البلدان الأخرى محاربًا أو سياسيًا أو تاجراً أو رجل صناعة أو بحاراً فهو فى مصر الموظف»، فى حين عند دوستويفسكى تعود جذورها إلى قوة نابليون فـ «عندما توجّه لقتل المرابية، حيث يحق للمميزين القتل، مِن أجل أن يحققوا الانعطافات التاريخيّة الكبرى».
لا يتوقف القارئ/ الناقد أمام الحكاية، وهو ما رأيناه فى كل القراءات السابقة، وإنما يتوجه دائما إلى البحث عن جملة الرواية، أو فلسفتها ورسالتها المضمرة، فالقمحاوى لا يعيد تلخيص أحداث الرواية، أو حتى يقدم صراع البطل من أجل صعوده إلى مجده.
وإنما يلتقط فلسفة المؤلف التى يمرّرها على لسان شخصياته، فمثلا يتوقف عند رأى عثمان بيومى عن مأساة الإنسانية، فى كونها «تبدأ من الطين وعليها أن تحتل مكانتها بعد ذلك بين النجوم» هذه الفلسفة التى اختبرها البطل فى رحلة صعوده.
ويردها القارئ / الناقد إلى الفلسفة الذرائعية والنفعية، «فغاية قطع درجات سُلم الترقى الوظيفى هى الهدف الذى ينظر من خلاله عثمان إلى كل شيء، بما فى ذلك الحب والزواج والأسرة» فعلى حد تعبير عثمان بيومي: «العروس الجميلة إما أن تكون هدية مجد مبكر أو ذريعة إلى المجد المستعصي».
ينتهى القمحاوى إلى أن محفوظ أقرب إلى دوستويفسكى منه إلى بلزاك وأى من الكلاسيكيين من زاوية محاولاته الدائبة لتذويب التيارات الفلسفيّة فى تمثيلات روائية، وفى النظرة الدينيّة إلى الألم والحزن باعتبارهما ضرورة من ضرورات فهم الحياة».
وهذا الملمح البارز فى كتابات محفوظ سيعود له عزت القمحاوى فى قراءته لرواية «السراب»، عبر ظاهرة الخجل، ويشير فيها إلى أسبقية محفوظ فى اعتبار الخجل ظاهرة مرضية فى تلك الرواية تبدَّت معرفة نجيب محفوظ بالفلسفة وعِلم النفس، موغلاً إلى أعمق المشاعر التى لا يبوح بها البشر حتى لأنفسهم، مشخصًا مثل محلّل نفسى بارع أحاسيس الندم والإذلال التى يشعر بها الخجول عقب كل إخفاق فى مواجهة الحياة.
هبة شريف ويوم غائم فى البر الغربى
هبة شريف أستاذة أدب مقارن فى الجامعة، لكنها معنية بالنقد الثقافى بصفة خاصة، قدمت ثلاثة من الأعمال المهمة هي: «دينى ودين الناس» (2017)، و«ن النسوية» (2018)، و«ليست كل طاعة فضيلة» (2022)، فى كتابها «ن النسوية».
وهو كتاب منشغل بالنقد الثقافي، تناولت فيه قضايا المرأة عبر أسئلة جوهرية: من قبيل؛ هل فعلاً المرأة حرّة حرية مطلقة فى اختياراتها؟ وهل تحرّرت المرأة عندما تبنّت مفاهيم وأفكار المساواة والتحرّر؟ وما القيود التى على المرأة أن تتحرّر منها؟.
وما مدى صدق الشعارات التى رفعتها حركات التحرّر النسويّة على مدار تاريخها على الواقع؟ فاشتبكت عبر فصول الكتاب مع كثير من هذه الأفكار وحاولت تقويض الكثير منها فى ضوء المنتجات الثقافية (السينما، والتليفزيون، والأعمال الروائية).
التى كشفت عن عوار فى تطبيق هذه الأطروحات التى تشدق بها أنصار حركات تحرر المرأة، والمدافعين عن حقوقها الاجتماعية، متغافلين حقوقها السياسية والاقتصادية والأهم حقوقها النفسية!
اللافت أن الناقدة / القارئة لم تجعل من الأطروحات الغربيّة الخاصّة بالحركات النسائيّة المدافعة عن تحرُّر المرأة، نموذجًا إيجابيًّا وفعّالاً، بل على العكس قدمت صورًا ونماذج تكشف عن عوارها، فلئن كانت هذه الحركات تعمل على تحرّر المرأة، فإنها فى الوقت ذاته تعمل على إخضاع المرأة لنظام أكثر قسوة.
على نحو ما حدث فى عصر صناعة الجمال، بتسليع أجساد النساء استجابة للموضة والنحافة، وهو ما أدخلها فى نظام رِق (أو عبودية) جديد، خاصة مع ازدياد توحش الرأسماليّة والسوق الحرّ، بأن تمّ استعباد أجساد النساء من أجل أرباح اقتصادية للقائمين على هذه الشركات على حساب كرامة المرأة وحريتها.
وأيضًا لم تكن مثل هذه الحركات تُساند جميع اختيارات المرأة، وأكدت أن النساء فى المجتمعات الحديثة (عبر نماذج أدبيّة، وعروض سينمائيّة، وأطروحات المنظرات النسويات) لا يملكنّ دائمًا الحق فى الاختيار، بين العمل ورعاية العائلة.
وأشارت أيضًا إلى أن فرض الأفكار التحررية للمرأة فى بعض المجتمعات، لم تكن فى أصلها رغبة فى رفع الظلم عنها، وإنما استخدمت المرأة (كواسطة) لتمرير أهداف أخرى، فقد كان غرضها إدخال الأفكار الحداثية لهذه المجتمعات عن طريق النساء، بوصفهن الحاملات الأساسيات للقيم، والقائمات على تربية الأجيال.
من الروايات العربية التى توقفت عندها وفق رؤيتها عن تحرّر المرأة، وموقف المجتمعات الحديثة من الحب، ودور الاستعمار فى تعليم المرأة، روايات: «ميرامار» لنجيب محفوظ 1967، و«نقطة النور» لبهاء طاهر2005، و«يوم غائم فى البر الغربي» لمحمد المنسى قنديل 2009، و«جيمنازيوم» مى خالد 2015، و«بليغ» لطلال فيصل 2017.
سأتوقف عند تحليلها لرواية محمد المنسى قنديل «يوم غائم فى البر الغربي» (2009)، لمحاولة إظهار الرؤية المغايرة التى اتبعتها القارئة / الناقدة فى تلقى العمل، فمعظم القراءات التى تناولت العمل ربطت بينه وبين الشكل التاريخى للرواية.
وهناك من تبنى رؤية أكثر حداثية، وقرأها فى ضوء التاريخانية الجديدة، ومع أن الناقدة لم تغفل السياق التاريخى الذى تدور فيه الرواية، إلا أنها لم تتوقف عند الشكل الروائي، وعلاقة الرواية بالتاريخ، وغيرها من موضوعات اهتم بها نقاد الرواية على اختلاف مرجعياتهم الثقافية، وإنما توقفت عند نقطة مهمة تتعلّق باستغلال المرأة كمحور للصراع.
وخاصّة فى ظل هيمنة الاستعمار وما سعى إلى التبشير به من حداثة ومدنية للمجتمع، ضمن جملة التصوّرات التى راح يُغذّى بها العقول بأنه جاء لتحريرها من العادات الغريبة والوحشية، ومن ثمّ تخليص سكان هذه البلاد من المرض والجهل والفقر والخرافات.
ومن أهم مظاهر الحداثة السعى إلى تحرير المرأة كهدف عمد إلى تكريسه فى الكتابات الاستشراقية، كنوع من التحايل على الصيغة الاستعمارية التى كانت هدفه الأصلى والوحيد.
السؤال الذى كان محور الفكرة التى بحثت عنها القارئة / الناقدة فى رواية «يوم غائم فى البر الغربي».
وغيرها من منتجات ثقافية كفيلم البوسطجى المأخوذ عن رواية يحيى حقي، هو: هل يهتم الاستعمار بمساندة المرأة المهمّشة فى المجتمعات المستعمرَة حقًا؟ فى ظل ما ردّده المستعمِر بأن هدفه هو تخليص أهالى هذه البلاد من العادات الوحشيّة والغريبة، وما رفعته من شعارات بغرض تحقيق مطامعها الاستعمارية بتبنيها الدفاع عن الأفكار النسوية، بأن النساء فى هذه المجتمعات يتعرضن للقهر.
تنتهج القارئة / الناقدة، نهجًا ثقافيًّا بامتياز فى تحليلها للظواهر والنصوص الأدبيّة والمرئيّة، دون أن تضع على مؤشر الكتاب الخارجى مفردة نقد ثقافي، التى يحرص مَن له علاقة بالنقد الثقافى ومن ليس له علاقة على ترديدها، واستعمالها للنقد الثقافى لا يأتى بتعالٍ على القارئ، بل إن القارئ فى حقيقة الأمر لا يستشعر غرابة فى الأسلوب، أو غموضاً فى المصطلحات المستخدمة،
وإنما ثمة سلاسة وإيضاح بضرب الأمثلة عبر الاستشهادات التى تأتى متناغمة مع الفكرة التى تريد توضيحها، كما أن جمهور القراء يستلمح - فى قراءتها - تأثيرات الخطاب ما بعد الكولونيالى (ما بعد الاستعمار)، ودراسات التابع، عبر العلاقة الجدليّة بين المستعمِر والمستعمَر / التابع.
ومحاولة الأول خلخلة مفاهيم الثانى عبر الآليات الناعمة التى يستخدمها فى قضايا بالغة الخطورة كالتحرّر الوطنى والفردي، وتعليم المرأة، والاستلاب، فالقراءة التى تقدمها تسعى إلى تفكيك هذه المفاهيم، وإظهار الأدوار الخطيرة التى يلعبها الاستعمار لتكريس وجوده من ناحية، واستقطاب فئة من المثقفين لتأييد دوره من ناحية ثانية.
فمثلاً تستدعى القارئة / الناقدة كتاب «استعمار مصر» لتيموثى ميتشل، وهى تقرأ الأفكار التى جاءت على لسان اللورد كرومر فى الرواية من تبنيه الأفكار الحداثية للمجتمع المصري، ومنها دعوته إلى تحرّر المرأة وتعليمها، وفى تأكيده بأن «وضع النساء فى مصر هو عقبة قاتلة أمام بلوغ ذلك السمو فى الفكر والأخلاق الذى لا بدّ أن يصاحب إدخال الحضارة الأوروبية».
والغريب أن اللورد كرومر الذى كان يدافع عن المرأة، وأعلن مساندتها فى صورة عائشة بطلة الرواية، هو فى بلده (بريطانيا) نقيض هذه الصورة التى كان عليها فى مصر، فالوجه الآخر له كما تقول «كان من أشدّ أعداء حصول المرأة البريطانية على حق الانتخاب، فكر ومر كان رئيسًا للجمعية التى تُناهض حقّ المرأة فى الانتخاب.
وكان من رأيه أن النساء لا بد أن «يبقين نساءً، والرجال رجالاً، أى محاولة لتغيير الأدوار الطبيعية للجنسين، سوف تُجلب الدمار على إنجلترا والإمبراطورية»، هذا هو الوجه الحقيقى الذى كان عليه اللورد كرومر.
وهو مغاير لتلك الصورة التى ظهرت فى مصر، من حيث إعلانه الدفاع عن المرأة، ومساندتها فى الحصول على التعليم، وهو ما تجلّى بصورة فعلية فى علاقته بعائشة التى اتخذها مساعدة لزوجته، فاعتنى بها، وحرص على تعليمها، فالصورة التى يظهر بها فى الرواية صورة المنقذ والمدافع عن حقوق المرأة فى صورة عائشة.
الرواية كما تقول القارئة / الناقدة قدمت عائشة مُحصنة فى ظل حماية الأجانب، فهى وحيدة تمامًا لا تجد المأوى والحماية لدى عائلتها ولا أبناء بلدها (والمؤسف أنها) لم تجد الأمن والتفهّم إلا عند الأجانب، فالناس الذين هى منهم «أهانوا جسدها وكسروا روحها» فعمها يغتصبها.
ومَن يمدّ يد العون لها هم الأجانب، تنقذها - كما تقول هبة شريف - «المدرسة الأمريكية من مصيرها البائس مع العم، ثم تجد الوظيفة والمأوى لدى اللورد كرومر فيطلب منها أن تقيم عنده حتى ترافق زوجته الليدى كاترين وتسليها».
وعندما أدركت «أنها قد ابتعدت كثيرًا عن عالمها الحقيقي» وأنها لا تنتمى للخواجات، بل إنها تشبه الناس الموجودين خارج قصر اللورد كرومر، لم تثمر محاولتها لاسترداد «تاريخها المنسي» والعودة إلى أصلها إلا الفشل.
تطرح الدكتورة هبة شريف عبر تفكيك العلاقة الضدية بين عائشة وأبناء بلدها / وأقاربها، فى مقابل علاقتها بالمستعمِر، سؤالا إشكاليّا يتعلّق بموقف المثقف التابع (المستعمَر) من المستعمِر، فى مقابل موقف المستعمِر من أهل البلد (المستعمَرين)، فاللورد كرومر - كما جسدت الرواية - لم يستغل عائشة.
وعندما قررتْ ترك الخدمة أعطاها مستحقاتها المالية، إضافة إلى أنه لم يرغمها علاقة معه دون رغبتها على عكس عمها الذى اغتصبها عنوة، وهى صورة نقيضة لحقيقة الاستعمار، ولئن استخدمها فهى مجرد فخ، فحالة اللوذ والاعتماد على المستعمِر فى حالة عائشة كان لها مبررها.
وهو ما أراد محمد المنسى قنديل أن ينبه له، فسياسة الاستعمار الناعمة لمحاولة جذب الأطراف الضعيفة من أجل تحسين صورته، وجدت مردودها عند عائشة لذا انحازت له، فكما تقول هبة شريف: إذا كان الرجال الأجانب فى الرواية كلهم داعمين لـ«عائشة» المصرية، بينما يستغلها الرجال المصريون، أو على أقل تقدير يعجزون عن نصرتها - فلا عجب إذا تبنت عائشة أو أى امرأة مصرية فى ظروف مشابهة- منظر مَن يحترمها ويحميها، وتنفر ممن يعاملها باحتقار واستغلال» (ص 186).
السؤال الصدمة الذى طرحته الرواية، وهو ما تكرره الناقدة، دون إجابة: إذا كانت النخبة المثقفة المصرية، ومنهم الأدباء والكتاب قد اقتنعوا تمام الاقتناع بدور الاستعمار فى مساندة المرأة، دون مساءلة للغرض الأساسى من وراء هذه المساندة؟ فهل كانوا مقتنعين مثلاً أن الغرب هو مركز التمدن، وأن تفوق الأمم الأوروبية يعود إلى تفوقهم «فى مجال الأخلال العالية، وفى ميادين العلوم والفنون المنورة للمدارك» على رأى عبد الرحمن الكواكبي.
هكذا تتخذ الناقدة من حكاية عائشة التى تُعدُّ جزءًا ضمن سياق مروية تتناول التأريخ لفترة عصيبة من تاريخ مصر الحديث، لتطرح فكرة غاية فى الأهمية تعد جوهر الحكاية، ألا وهى موقف المثقف (المستعمَر) من المستعمِر.
ومن ثم نراها تلوذ بأطروحات المفكر فرانز فانون، الذى يشير إلى أن انبهار «المثقف المستعمَر بالقيم الثقافية للمستعمِر، وتبنيه لها ودفاعه عنها أحيانًا»، فالاستعمار يلجأ «إلى معركة خلفية فى ميدان الثقافة والقيم والتكنيك فيعمل على عقد صلات قوية بالنخبة المثقفة المحليّة لتصبح حارسة لقيم المستعمِر فيما بعد».
ولئن اتخذت الناقدة موقف عدم الإدانة للمثقف، إلا أن الحقيقة تقول إن قسمًا من النخبة المثقفة وجد الحل فى المستعمر للنهوض بالبلاد، ولا أدل على هذا من موقف النخبة والأعيان المرحب بجيش نابليون بونابرت عندما جاءت زاعمًا أنه حامل مشاعل التنوير ومصابيح الحضارة.
ما يهمنى هو كيف قرأت الناقدة الرواية، وكيف راحت تقتفى أثر المعنى المختفى بين طيات النص، لتبرز المعنى الذى لم يقله صراحة النص، أو يستتر على ما لا يقوله، وإن كان يقود إلى التفكير لإعادة بنائه واستكشاف ما لم يفكر فيه، ولم يقله (نيتشه).
والشيء الآخر أن الناقدة أشارت عبر قراءتها أن واقع المرأة فى المجتمعات الشرقية مرير، وهو ما دفع البعض لتبنّى قيم المستعمِر، وهو ناقوس الخطر الذى تدقه الناقدة بضرورة الانتباه.
وهو الأمر الذى تستغله المنظمات الحقوقية الآن فى تبنّى قضايا المرأة المهمشة والمظلومة، وجعلها تحتل الصدارة، وتغاضيها عن حقوق أصيلة، فالغرض دومًا هو استغلال المرأة فى تمرير أجندة الغرب غير البريئة.
هذه قراءة اعتنت بالجمل النسقيّة داخل النص، سعت من خلالها إلى البحث عن شيفرة النص للوصول إلى المعنى أو الرسالة التى تودّ الرواية قولها عبر حكايتها التى امتدت على أكثر من 500 صفحة، لم تقف عند قراءة المعنى السطحى للرواية أو محاولة فرض منهج قسرى على النص على عادة الأكاديميين.
تركيب
سعت الدراسة منذ فكرتها إلى إبراز فاعلية القرّاء النموذجيين فى إنتاجية معانى النصوص المقروءة، وهو ما كشف - بالتالى - عن استراتيجية كيف نقرأ النص، دون وضع تصوّرات منهجية مسبقة، كما أن هذه القراءات على اختلاف نوعية القارئ، وتخصصه، ليست قراءات انطباعية، أو قراءات سطحية، وإنما هى قراءات ترتكز على وعى القارئ، وما يمتلكه من مخزون قرائى متعدّد.
كما كشفت عن وعى (حقيقي) بالمناهج النقدية، وقدرة على توظيفها داخل النص، دون محاولة لإقحامها على بنية النص، لابتسار معانٍ قد تكون بعيدة تمامًا عن رؤية المؤلف التى يُحمِّلها النص، وتحتاج إلى مَن يستقبلها. قراءات فى مجملها تشدّد على دور القارئ النموذجى (أو أيًّا كانت صيغته).
ووعيه البنّاء فى إعادة قراءة النص، وسدّ ثغراته، والأهم أنها كشفت عن قِيم جمالية مكتنزة فى بنية النص، لم تتطرق إليها قراءات النقاد المتخصصين، وهو ما يؤكد فى النهاية أن الجمال فى عين القارئ النموذجي.
وأن إدراكه لا يحتاج إلى أكثر من تجربة وخبرة بالنصوص، وقدرة على فك شيفرات النص، وردّ الدال إلى مدلوله، بلغة سهلة بسيطة بعيدة عن اللغة الكهنوتية، المتكئة على فائض لفظى مستمدّ من المصطلحات الغربية والمعجميّة.
وفى الأخير تمثّل هؤلاء القرّاء / النُّقاد لمهمّة النقد كما حدّدها الناقد اليابانى (شيجاهيكو حاسومي) بأنها «إيقاظ علامة نائمة وإحياؤها وذلك بخلخلة هذا العالم من البديهيات» («النقد الأدبي»: فابريس تومريل، 2017، ص 25).
وبالمثل النظر إلى النص - كما يقول بارت - بصفته نقطة تقاطع لأكبر عدد من الأعراف الثقافيّة المرجعية التى نكتشفها ببراعتنا، وأن نعمد إلى تفسير تشابكات ما نكشف من أعراف بأيّة طريقة تعجبنا.














