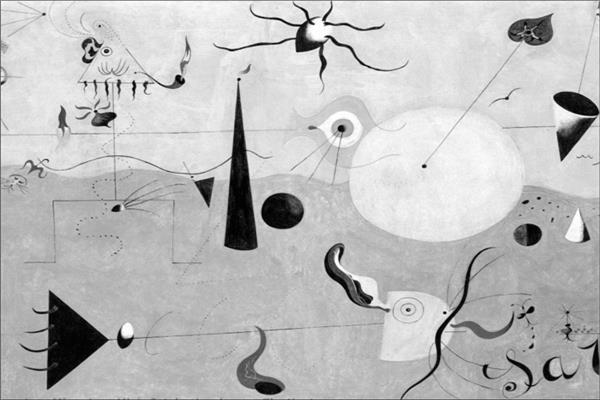شهدت الألفية الثالثة منذ مطلعها تحولات جذرية فى مفاهيم الحياة والكون والبشر والإنسانية، وهو ما أحدث بالتبعية تحولات جذرية فى نظم ومؤسسات ونظريات سياسية واقتصادية وفكرية واجتماعية.. ولو سألنا أنفسنا عن مركز انطلاق الشعلة التى أحدثت كل هذه التحولات، فإننا سنصل إلى تلخيصها فى مفهوم “المعرفة”، وما شهدته من تحول فى وسائطها، وانتقالها إلى الرقمية، واستثمار المعلومات وتسعيرها، مما فرض على العالم الانتقال إلى إعادة صياغة كل شيء ليتوافق مع نموذج المعرفة والتكنولوجيا، حيث تم المزج بين متباعدات عدة لصناعة نموذج هو المتحكم الآن: استثمار المعرفة والمعلومات، والرأسمالية الجديدة، والغزو الفكري، وفلسفات التفكيك والحداثة وما بعد الحداثة، والعولمة، ومجتمع المعرفة، وحروب الجيل الرابع والخامس والسادس، وغيرها من معطيات أوجدتها التكنولوجيا وأسهمت فى منحها مساحات لمن يمتلك القدرة على الاستثمار لصالح تحقيق أهدافه والترويج لهيمنته، وتحقيق مكاسبه السياسية والاقتصادية بمفهوم القوى الناعمة.
وعبر عقدين ويزيد من الزمان (٢٠٠٠- ٢٠٢١م) تعالت أصوات المفكرين فى العالم لقراءة وتحليل ما يحدث والتكهن بمستقبله، فندد البعض بانحراف البشرية عن مسارها، وسقوطها فى فخ الجهل الجديد، والتفاهة والمديوكرية La médiocratie، (كتابات آلان دونو، وتوما دو كونانك).
ونبه البعض لاختلال العالم الفكرى والاقتصادى والمالي، الذى يجر الكوكب إلى اضطرابات يتعذر التكهن بنتائجها، والاختلال المناخى الناتج عن ممارسات طويلة غير مسئولة، والبربرية الحديثة (التى تفوق بربرية العصور القديمة)، والفجوة بين التقدم المادى والأخلاق، وما يؤدى إليه من عنف وفوضى (أطروحات أمين معلوف بالفرنسية، وبعض مفكرى أوروبا).
وحذر البعض من مخاطر السيولة وهيمنة منطق الاستهلاك بمعناه العميق للمكان والقيم والأشياء والعلاقات فى ظل العولمة (أعمال زيجمونت باومان الحداثة السائلة والحياة السائلة والحب السائل... إلخ).
وسعى البعض للكشف عن طبيعة التحولات الرقمية التى طرأت على العالم بفعل التكنولوجيا وما يحدث فى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة عندما نستخدمها، وكيف ترسل إشاراتها للشركات المنتجة، وكيف تتحول كل أشكال حياتنا بفعل استخدامها، واستثمار وتوظيف ذلك كله من قبل الإعلام الجديد (مؤلفات هال آبلسون، وهارى لويس، وكين ليدن، وبرامود كيه نايار، وهربرت شيلر، وليا ليفرو، وبعض أفلام السينما الوثائقية).
وسعى البعض لقراءة الواقع للتكهن بمستقبل العالم فيما بعد العولمة، وبخاصة بعد عودة الرأسمالية الجديدة عقب الأزمة الاقتصادية ٢٠٠٨م (كتابات إريك كازدين وإمرى زيمان، وسمير أمين).
وطرحت كثير من المؤلفات أسئلة من قبيل: هل سيكون القرن الحادى والعشرون دينيا؟ وهل الثقافة لازمة للبقاء؟ وما موقع ومستقبل الأخلاق والقيم الإنسانية من خارطة التطور؟ وما السيناريوهات المتوقعة بعد تكشف خديعة “ديستوبية العولمة”؟ وغيرها من الأسئلة الجوهرية التى تحكم مسار العالم الآن.
وعبر ذلك جميعه تزايد الاهتمام عالميا بمفهومين أساسيين وضعتهما الدول فى مقدمة اهتماماتها لما لهما من أثر جوهرى فى مستقبل الشعوب، وهما “الثقافة”، و”الهوية”، وذلك على الرغم من صعوبة وضع حدود قاطعة لكل منهما، إذ يتداخل كلاهما من جهة، ويتشابك كل منهما مع كل أشكال الحياة ومظاهرها من جهة ثانية.
فما من منتج اليوم سواء أكان ماديا أم فكريا أو معنويا، إلا وله خلفية ثقافية ينطلق منها، وأهداف ثقافية سيحققها من خلال انتشاره وتداوله (إلى جانب عوائده المادية بالطبع)، بدءا من الهواتف المحمولة والشاشات المسطحة والأجهزة والأدوات التى نستخدمها فى حياتنا اليومية، ومرورا بالبرمجيات والتطبيقات، ووسائل السوشيال ميديا، وحتى الألعاب الإلكترونية التى يمارسها الأبناء فى غيبة عن وعى الآباء، وما يحدثه ذلك جميعه من تكوين “اتجاهات” داخلية عميقة تتحكم فى وعى الأفراد، وتؤدى بالضرورة إلى التأثير فى الإدراك والسلوك والفكر والتوجهات والمواقف فى الحياة الواقعية.
وفى كل ذلك أيضا تكون الغلبة لصالح الانتصار لهوية صاحب المنتَج، أى تمرير السمات المميزة لهذه الهوية التى أصدرت هذا المنتج، وهو ما يؤدى بمرور الوقت لفرض هيمنته الثقافية على الشعوب المستهلكة على نحو قد يصل مداه إلى إحداث ما يشبه الاحتلال الفكرى (البديل عن الاحتلال العسكرى بمفهومه القديم)، وهو ما يفسره بدقة شيوع الثقافة الغربية (والأمريكية على وجه الخصوص) فى بلداننا العربية، بدءا من ثقافة الطعام (التيك آواي) بديلا عن التقاليد العربية الأصيلة فى ذلك، ومرورا بخلخلة منظومة العادات والقيم والمرتكزات، وانتهاء بما طرأ على مفهوم الأسرة العربية من تفكك تأثرا بالغرب.
وإذا شئنا أن نقف على مفهوم الهوية فى أبسط معانيه، فهى السمات والمواصفات التى تشكل شخصية الشيء أو الفرد أو الجماعة (الأسرة، الجماعة، الشعب، الأمة)، وتميزهم عن غيرهم، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال رصد عناصر الهوية، وهي: اللغة، والعرق، والمعتقد، والحضارة، والأصول الموروثة من عادات وتقاليد وأعراف وقيم، والأبعاد الثقافية والحضارية (وهو ما يجعل الثقافة ذاتها بمفاهيمها الواسعة والمتعددة جزءا ومكونا من مكونات الهوية).
من هنا يمكن التمييز مثلا بين هوية الأفراد والجماعات فى جنوب مصر (الصعيد)، قياسا إلى دلتا الشمال (الفلاحين)، قياسا إلى الصحراء الغربية (سيوة والخارجة)، قياسا إلى الصحراء الشرقية (سيناء)، وذلك كله من خلال: طريقة استخدام اللغة، والمظاهر الحضارية، والأعراف والتقاليد... إلخ، وهو ما سيشير للنقطة الأهم بشأن الهوية، وهى أنها ليست نمطا واحدا موحدا على مستوى الدولة أو الشعب، وإنما هى مظلة كبرى تحوى أصولا مشتركة بين الجميع، وتحت هذه المظلة تأتى تنويعات متعددة تتميز بهويات فرعية، تثرى المشتركات الكبرى بتنويعات لا حصر لها، وهذا الثراء هو الذى تتميز به الشعوب الآن فى عصرنا الحاضر.
وهذا ما ينقلنا خطوة إلى الأمام فى سياق الحديث عن أشكال التداول المعاصرة لاستثمار عناصر الهوية وتنويعاتها، وتحقيق المكاسب المادية والمعنوية منها، والتى يمكن رصدها في: الميديا والإعلام البديل والسوشيال ميديا المتغلغلة فى كل تفاصيل الحياة، والسينما وما تحويه من تمرير لأفكار وتوجهات (ويكفى مراقبة أفلام نتفليكس التى لا يخلو واحد منها من دمج لموضوعات التعاطف مع اليهود، والمثلية الجنسية، والتشكيك فى مرتكزات الشعوب، وتصوير العرب فى صورة الإرهابي.. إلخ)، وغيرها من أشكال تداول تتطور يوما بعد يوم.
تبين لنا إذاً أن التحولات التى طرأت على البشرية فى السنوات الأخيرة قد أحدثت تغييرات جذرية فى كل أشكال الحياة، بما فيها الآداب والفنون، وما أكثرها، بدءا من التفكيكية (تقويض المرتكزات)، وفكر ما بعد الحداثة (هدم المركزية)، والعولمة (نفى العرقية والاستظلال بهوية عالمية موحدة)، والسيولة (هيمنة منطق السوق)، وما نتج عن ذلك جميعه من سيادة أنماط جديدة تناولتها العديد من الدراسات وبحثت مخاطرها، مثل الجهل الجديد والجهل المركب (توما دو كونانك)، وهيمنة نظام التفاهة والمديوكرية (آلان دونو)، وتحويل كل ما كان يمثل صلابة للبشرية من قيم وتقاليد إلى سيولة مائعة (سلسلة السيولة زيجمونت باومان)، وغيرها مما عمل على تفتيت الهوية فى كل شيء:
• تفتيت هوية البشر والشعوب لصالح قيم العولمة وما بعد الحداثة، على ما فيها من هيمنة سياسية وحروب اقتصادية استعانت بالإعلام البديل والسوشيال ميديا لصالح إقرار رأسمالية احتكارية جديدة.
• تفتيت هوية الأنواع الأدبية والفنون لصالح نظم السوق، التى تبحث عن المكاسب المادية دون أدنى اعتبار لمفهوم القيمة فى حد ذاتها، ولعل ذلك ما يتضح بقوة فى انحرافات الأنواع الأدبية عن مساراتها بدعوى التجريب المتحرر كلية من أدنى متطلبات الأنواع الأدبية، هذه المرة ليسً بأشكال التجريب المتعارف عليها، والتى حدثت على مستوى النوع الواحد (الانتقال بالشعر من الموزون المقفى إلى الشعر المرسل، ثم الشعر التفعيلي، ثم قصيدة النثر)، أو على مستوى الأنواع المتعددة (تداخل الأنواع أولا، ثم امتزاجها بالفنون ثانيا، ثم تداخلها مع حقول معرفية بعيدة ثالثا... إلخ).
غير أن التجريب هذه المرة – بفعل هيمنة السيولة العالمية- ينفلت من كل المتطلبات الأساسية للنوع، وينتج نصوصا لا علاقة لها بالأدب من الأساس (لأنها تخلو من الخيال والمجاز بمفهومه الواسع، وبناء العوالم الممكنة بمفهوم المنطق الصوري... إلخ)، ويمكن فى ذلك مثلا الوقوف على بعض الأعمال الروائية التى لا تتجاوز مجرد كونها حكاية عادية لا تختلف عن الحكى اليومي، وبالتالى لا تحمل أيا من مكونات البناء الروائي.
أما ما يتعلق بتفتيت هوية الشعوب باستخدام الإعلام البديل والسوشيال ميديا، فإنه يمكن ملاحظة أن السيطرة على الإعلام فى عالمنا المعاصر تعد أهم وسائل السيطرة على كل مجالات الحياة، لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية وثقافية وحتى استعمارية بمفهوم الاستعمار الحديث (الاحتلال الفكرى والثقافي)، بما تمتلكه من قدرة على التحكم فى تكوين وتوجيه الرأى العام المحلى والعالمي، وعلى إقرار أنماط وأشكال جديدة للحياة وتحويل البشر إليها، وعلى تمرير سياسات وأفكار وثقافات، وعلى الترويج لأى فكرة أو قضية حتى ولو كانت خادعة أو غير حقيقية، وعلى تشكيل الوعى بكل أبعاده.
وعلى نحو مختصر يمكن القول إن الإعلام الجديد المرتبط بالتكنولوجيا يمتلك القدرة على إعادة صياغة العالم والتحكم به، ولذا شاعت فى العقود الأخيرة مقولة “من يمتلك الإعلام يمتلك الحقيقة”، مع الوضع فى الاعتبار أن الحقيقة هنا لا تعنى على الإطلاق المفهوم المستقر فى الأذهان والمرتبط بالصدق، والمنافى للكذب والخداع وغير الحقيقية، وإنما تعنى إنتاج واستثمار المعرفة التى يحتكرها، ثم توظيفها وتوجيهها لما يخدم مصالح المالك (المحتكر لها)، أى الإعلان عن بعض ما يملك، أو إعادة تكييفه بما يتناسب وتحقيق أهدافه، وبالتالى إخفاء ما يتعارض مع مصالحه حتى لو كان فيه إضرار بمصالح البشرية من حوله، وبث الأفكار وتمريرها بما يخدم مصالحه، وتحقيق أهداف سياسية كانت تحتاج قبل ذلك إلى عدة وعتاد لتنفيذها، لكنها اليوم بفعل هذا المزيج (الإعلام والتكنولوجيا) غدت فى غاية السهولة لصاحب امتياز منتجها.
يستخدم الإعلام الجديد فى ذلك كل الوسائل التى عرفتها البشرية من قبل، ويوسع من مجالها، ويضيف إليها، ويحسن استخدامها، من صوت وصورة وحركة ومشاهد مرئية (مصنوعة أو منقولة من سياق لسياق، أو طبيعية يعرف متى يوظفها)، وعبر ذلك جميعه استطاع الإعلام تحويل المجتمعات كلها، فقيرها وغنيها، إلى مجتمعات مستهلكة سائلة يستطيع التحكم فيها عبر سوق عالمي.
وقد لا يكون من المبالغة القول بأنه لم تعد هناك سبل أمام المستهلكين الآن فى كل شعوب العالم سوى الخضوع لأوامر السوق العالمى وأوامر من يتحكم فيه ويفرض قوانينه وقواعده، ويكفى للتدليل على ذلك مراجعة واقع الاحتكار العالمى فى مجتمع المعرفة، “أربعة وكالات أنباء عالمية فقط معروفة باسم “الأربعة الكبار” هى التى تحتكر نسبة 80% من إجمالى التدفق المعلوماتى العالمي، وأن مائة موقع فقط هى التى تستولى على 80% من إجمالى مستخدمى شبكة الانترنت”، وكل ذلك يخدم الهدف الأساسى لهؤلاء الكبار، وهو: صناعة العقول، وتشكيل الوعي، وصياغة الرأى العام العالمي، وخلق المعتقدات لدى الأفراد، وخلق الجماهير الداعمة لفكرة أو عقيدة ما، يتم تصديرها عن طريق هؤلاء الكبار.
أى أنهم لا يتحكمون فى مسار السوق العالمى فقط، وإنما فى وعى أفكار وثقافات الشعوب ولغاتهم أيضا، ويمكن فى ذلك مراجعة قضايا الصراع العالمى فى هذا الشأن بين الصين هاواوي، وأمريكا جوجول (المملوكة لألفابيت) والاتهامات المتبادلة بينهم فيما يخص استغلال التكنولوجيا والإعلام.
ومن جهة أخرى، فإن هذا الاحتكار فى الإعلام ووسائل الاتصال، يخلق بالضرورة التبعية التكنولوجية فى مجال الإعلام لصالح المحتكر، مما يسمح له بفرض هيمنته الفكرية والسياسية لحسابه أو لحساب الغير (الحرب بالوكالة) ما دامت هناك أرباح ستتحقق، وهو ما يمكن ملاحظته بدقة فى واقعنا العربى فيما يمكن تسميته بخديعة السوشيال ميديا، وبخاصة عند النظر إلى القضايا اليومية الاستهلاكية، التى لا يعلم المروج لها ما مصدرها وما مصداقيتها، لكنها فى نهاية الأمر يتم طرحها بوصفها قضية تستحق النقاش.
ولعله من العجيب أن يقع كثير من المثقفين أصحاب الرأى فى هذه الخديعة، وتتحول كتاباتهم ونضالاتهم إلى وسيط السوشيال ميديا (الفيس بوك والتويتر... إلخ)، لا لإنتاج الجديد أو الإعلان عن صناعته للمحتوى العربى باستثمار هذه التكنولوجيا، وإنما بمنطلق الاستهلاك اليومي، الذى ينتهى فى غضون يومين على أقصى تقدير، لكنه فى الوقت ذاته يؤثر – لحظيا- فى الآلاف من المتابعين (وهو الأمر الذى كان مستحيلا فى القرون السابقة)، وهو ما يمكن النظر إليه ليس بوصفه تطورا طبيعيا للحياة، وإنما بوصفه حلقات من حلقات النظام العالمى الجديد، الذى يسعى لمحو هويات وفرض هويات (باستثمار الثقافة والقوى الناعمة).
من هنا تبرز أهمية دراسة العلاقات فى مفهوم الدولة الحديث وبناء الشعوب، وهو ما أكدت عليه الدراسات الثقافية المعاصرة كما يؤكد سايمون ديورينغ: “لا يمكن فعليا فهم أى شيء من دون النظر إلى موقعه ضمن شبكة من العلاقات المتشعبة، ولهذا فإن الثقافة تدرس العلاقة بين أشكال النصوص والممارسات الثقافية من جهة، وبين كل ما هو غير ثقافى من جهة أخرى، مثل: الاقتصاد، والعلاقات أو الاختلافات الاجتماعية أو الإثنية، والمسائل القومية، وقضايا الهوية والجنوسة والجنس، والمؤسسات الاجتماعية... إلخ”.
وكل ذلك سيحتم علينا فى وعينا العربي، العمل على رصد وبلورة مفاهيم الثقافة والهوية، وتصحيح أفهامنا حولها، والانتقال بها من مجرد التركيز على خطاب واحد، إلى التركيز على “مختلف الخطابات الثقافية التى تنتجها المجموعات البشرية المختلفة والمتنوعة، وعلى مستوى المثاقفة بين تلك الثقافات، وعلى أنواع من الثقافات الخاصة والعامة والهامشية، وبالخصوص الهيمنة الثقافية”.
وأخيرا، فإنه ينبغى التأكيد أن المجال السياسى والاقتصادى لم يعد هو المدخل لفهم حركات التفاعل والصراع بين الشعوب والأمم، وإنما أصبح المجال الثقافى هو الأساس فى فهم الجدل والتفاعل، لأنه يمثل فعل الوعى ذاته، وهو المنتِج لمفاهيم السياسة والاقتصاد والاجتماع والفلسفة، وكم شهد التاريخ على تغير مفاهيم وتحولها لانتقالها من بيئة ثقافتها الحاضنة إلى بيئة ثقافية أخرى.
وهو ما سيحتم علينا تجاوز حدود دراسة الخطاب الثقافى الواحد فى مجتمع واحد، إلى دراسته فى سياق تفاعله مع الخطابات المثيلة له والمتفاعلة معه فى الحاضر، وبخاصة مع ما يشهده العالم من تحكم المعلوماتية والتكنولوجيا فى صياغة مفهوم الثقافة ذاته.
أى أنه يمكن التفريق بين مفهوم الثقافة العام ومفهومها فى الدراسات الثقافية مثلا، إذ كان يتم النظر إليها فى المفهوم العام على أنها “موروثة وإلى حد ما غير قابلة للتبدل، و لكل مجتمع ثقافة واحدة، وكل فرد مجبول كليا على الثقافة التى يرثها”، (وهو ما اعتمد عليه طرح هنتنجتون فى صدام الحضارات).
أما الثقافة فى مفهومها المعاصر، وكما هو متداول فى الدراسات الثقافية فهى “ثقافة متحركة، متقلبة، متعولمة تعتمد المبادرة الفردية ويوجهها السوق”، أى يوجهها الفكر الاستثمارى القادر على تحويلها إلى أشكال قابلة للإنتاج، ولها تأثير فى المجتمعات الإقليمية والعالمية، وفى الوقت ذاته تحمل ملامح وسمات هويتها الفارقة، التى تجعلها متميزة عن غيرها من ثقافات العالم.