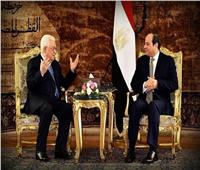الحوار مع هذا الرجل أشبه بالإبحار بين ضفتى بحر، كلما شعرت بالاقتراب من الشاطئ، أغرتك أمواج المعرفة بمزيد من الإبحار.. من الصعب أن تُعرّفه بتوصيف واحد، فهو يمتلك أكثر من رافد من روافد العلم والمعرفة، تخرج فى جامعة القاهرة عام 1977 حيث حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1977، وسرعان ما اجتذبته ـ ككثير من أبناء جيله - موجات الهجرة، فحط الرحال فى الولايات المتحدة، حيث حصل عام 1981 على ماجيستير فى العمارة من معهد مساتشوستس للتكنولوجيا MIT.

إنه الدكتور نزار الصياد، الذى يصعب أن تختصر تجربته تحت تصنيف واحد فقط، فهو معمارى، ومخطط مدن، ومؤرخ عمرانى، وأستاذ جامعى مرموق، وشاعر، ومثقف موسوعى، كما تولى عبر رحلته العلمية الثرية العديد من المناصب الأكاديمية المرموقة بجامعة كاليفورنيا بركلى، لعل أبرزها رئاسته لمركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة لسنوات طويلة، لكن القيمة الحقيقية التى يمثلها الدكتور نزار، لا تكمن فى كل تلك الإنجازات، ولا حتى المؤلفات العلمية العديدة التى حظيت بالتقدير العالمى، لكنه قيمته الحقيقية ـ فى ظنى - تكمن فى قدرته الفريدة على أن يمزج بين ذلك الثراء المعرفى الهائل الذى يمتلكه كأستاذ وباحث أكاديمى، وبين روح المؤرخ المدقق، وحساسية وروح الشاعر المرهف، لذا تخرج أعماله أشبه بسيمفونية متكاملة، تثرى العقل، كما تغذى الروح، وهو فى معظم أعماله شغوف بدراسة مصر، تاريخها وحاضرها، ومهموم بمستقبلها، فلا يكاد يغيب عنها بضعة أشهر حتى يعاوده الحنين، وفى زيارته الأخيرة التقيناه، وتجولنا على مدى ساعات فى رحاب رحلته الثرية متعددة الدروب، التى تشبه تماما شوارع القاهرة القديمة التى لايزال إلى اليوم من عشاقها.
وإلى تفاصيل الحوار...
إذا ما بدأنا بالنشأة.. كيف تأثرت تجربتك العلمية بسنوات النشأة فى مصر؟
الحقيقة أننى كنت محظوظًا لأننى نشأت فى رحاب أسرة ذات تكوين علمى وثقافى رفيع المستوى، فوالدى كان أستاذًا للجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكان رئيسًا لمعهد الدراسات الأفريقية، وكان شاعرًا ومثقفًا كبيرًا وعضوًا بالمجمع اللغوى والمجمع العلمى، كما رأس الجمعية الجغرافية، وهذا أتاح لى بيئة علمية مهمة ساهمت فى تشكيل مستقبلى وتطلعاتى، وعندما كنت طفلًا كان والدى يصطحبنى فى الكثير من اللقاءات العلمية، وكان لوالدى كتب عديدة منها كتاب النيل الخالد، وسيد الأنهار، وربما كان ذلك أحد أسباب عشقى لدراسة النيل.
وكيف جاء قرارك بالهجرة إلى الولايات المتحدة، رغم أنك كنت شابا ناجحا، وتنتمى إلى أسرة ذات مكانة علمية واجتماعية مرموقة؟
ربما أنا مثل الكثير من أبناء جيلى فى تلك الفترة عقب حرب أكتوبر 1973، وقد انتهيت من أداء الخدمة العسكرية عام 1978، وكان الوضع الاقتصادى فى البلاد صعبا، ولم يكن تحقيق أحلامى العلمية فى الداخل سهلا، ولأننى سافرت إلى الولايات المتحدة بصحبة أسرتى حيث عمل والدى كأستاذ زائر بجامعة أوكلاهوما، وكنت أجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة، استطعت الحصول على فرصة لاستكمال دراساتى العليا هناك، واستفدت من وجود برنامج للتعاون بين مصر والولايات المتحدة لدراسة المدن الجديدة، وعملت بالفعل ضمن هذا المشروع، ومن خلاله حصلت على منحة فى معهد MIT، وهو أحد أرقى المؤسسات العلمية فى العالم.
وكيف استطعت أنت تحقيق ذلك على أرض الواقع؟
أضرب لك مثالا بدراستى التى بدأت بها للحصول على الماجيستير، فقد كنت مغرما بدراسة شارع المعز، الذى كان يعرف بـ»قصبة القاهرة»، وكان من الصعب دراسة التاريخ والتصميم العمرانى لهذا الشارع بالغ الأهمية فى القاهرة القديمة وأنا معيد فى مصر، لأن معظم أساتذتى فى تلك الفترة كانوا يدورون فى فلك الحداثة، فمعظمهم درس فى أوروبا، وبالتالى لم يكونوا متحمسين لأن أدرس القاهرة القديمة، لكننى استطعت خلال دراستى فى أمريكا أن أحصل على منحة لدراسة شارع المعز الذى يمتد من باب زويلة إلى باب الفتوح.
مشرعات التطوير
وما أبرز ما يرويه شارع المعز عن تاريخ القاهرة؟
طبعا الشارع لم يكن بتلك الصورة التى عليها اليوم، فقد مر بالكثير من مشرعات التطوير، وكان فى الأصل وخلال حكم الفاطميين مغلقا بالكامل أمام المصريين، فقد كان السكن أو حتى الدخول إليه مقصورا على الفاطميين ومن يخدمونهم، ولابد لأى يشخص يمر من باب زويلة أن يقدم مبررا لدخوله إلى القاهرة الفاطمية، فقد كان الشعب يعيش فى الفسطاط، والفاطميون يعيشون داخل أسوار القاهرة الحالية، وكانوا يتعاملون مع تلك المنطقة معاملة القصور الملكية، وبالفعل كان هناك القصران الشرقى والغربى، وبينهما «الرحبة» وهى ساحة ضخمة مساحتها حوالى 300 متر وعرضها 150 مترا، وتستخدم فى الاحتفالات والعروض العسكرية.
وما هى أهم تلك العوامل التى كشفتها فى كتابك؟
الحقيقة أن هناك الكثير من تلك العوامل، لكن أهمها هو التميز فى استخدام العناصر المعمارية فى مبانى العمارة الإسلامية، فمثلا تجد استخداما مبهرا لعناصر المئذنة والقبة والمدخل، وهذه العناصر يجرى استخدامها بتناسق مدهش فى كل المجموعات الموجودة بالعمارة الإسلامية، وفى شارع المعز تحديدا، بحيث يشعر الزائر أنه أمام عناصر مألوفة ومتكررة، لكنه لو أمعن النظر والدراسة سيكتشف أن كل عصر استخدم نفس العناصر باختلافات تميزه عن غيره، وهذا أحد الأسرار.. والمدهش أكثر أن المعماريين فى تلك العصور كانوا لا يضعون فى اعتبارهم فقط السمات الخاصة بمبانى عصرهم فقط، بل نجد أن بعضهم قد يخرق القاعدة المعتادة ليحقق التناسق فى المنظور الكلى للمنطقة، وهذا أحد أسرار الراحة البصرية التى تجدها بالشارع.. كما أن المعماريين لأبنية شارع المعز أخذوا فى اعتبارهم تغير المنظور من زاوية ومن شارع إلى آخر، بحيث تظهر مآذن وقباب لمن ينظر إلى الشارع من زاوية، بينما تختفى وتظهر أخرى إذا دخلت للشارع من اتجاه مختلف، وهذا يمكن للزائر أن يلاحظه إذا التقط صورا مثلا وهو يسير من باب زويلة باتجاه باب الفتوح، سيرى أشياء، لا يمكن أن يراها لو كان قادما من الإتجاه العكسى، وهذه مسألة متعمدة من مهندسى ذلك العصر وتكشف عبقرية العمران بهذا الشارع، والعجيب أن تجد رمزية معينة وراء بعض الأبنية، فمثلا مئذنة مسجد الناصر محمد ستجدها تظهر بصريا بعد مئذنة مسجد قلاوون وأصغر منها، لأن الناصر محمد هو ابن السلطان قلاوون، وبالتالى يحمل البناء رمزية التبعية للأب وخلافته، رغم أن مئذنة الناصر محمد هى أدق مآذنه فى القاهرة ومن أجمل المآذن الإسلامية على الإطلاق.
جدال طويل
ورغم هذه السمات المميزة، إلا أنك فى كتابك «مدن الخلفاء» ترفض فكرة المدينة الإسلامية.. لماذا؟
لأننا لا نستطيع أن نربط عمرانا لمدينة أو لدولة بدين معين، قد نستطيع أن نربط بين مجتمع ما وبين الدين، لأن المجتمع يتأثر بتقاليد وتعاليم ذلك الدين ويتأثر بطابعه السياسى والثقافى، أما العمران فهو نتاج تأثر بحضارات أخرى وعوامل بيئية وجغرافية عديدة، وحتى المدن التى بنيت فى صدر الإسلام كالبصرة والكوفة كانت عبارة عن معسكرات للجنود ثم تحولت إلى مدن، وقد تأثرت بمتطلبات الجيوش الإسلامية فى المقام الأول، ولم تكن هناك سمات معمارية للإسلام فى تلك الفترة، والحقيقة أننى جادلت المستشرقين والإسلاميين فى مفاهيمهم المغلوطة حول المدينة الإسلامية، لأن كلا منهما كان يحاول إسقاط انحيازاته الأيديولوجية على دراسته للأنماط العمرانية لتخطيط المدن، دون الاستناد إلى أساس علمى.. والحقيقة أن مفهوم المدينة الإسلامية هو مفهوم مختلق ولا أساس علمى له، وقد أثبت ذلك فى كتبى حيث درست العديد من المدن الإسلامية وغير الإسلامية، وهناك العديد من عناصر التشابه بينها، ودخلت فى جدال طويل مع أنصار ذلك المفهوم.
فى رأيك لماذا لم تستطع القاهرة توظيف ما تمتلكه من ثراء حضارى وتاريخى لتكون قبلة سياحية عالمية تجتذب عشرات الملايين من السائحين سنويا، كبعض المدن التى لا تملك ربع ما تمتلكه القاهرة؟
الإجابة ببساطة وبلهجة عامية صريحة، لأننا «مهرجلين» وعندما نقوم بتنفيذ أى فكرة لا تكون هناك دراسة جدوى متأنية لها، ونصمم على تنفيذها رغم عدم دراستها بدقة، وأنا أتذكر أنه فى عام 1981 عقد اليونسكو مؤتمرا كبيرا حول تسجيل الآثار بالقاهرة، وأفضل السبل للحفاظ عليها، وكان هناك الكثير من المشاركين المصريين، واختلفوا حول الأسلوب الأمثل وهل هو تحويل القاهرة القديمة إلى منطقة مغلقة يدخل إليها السائحون بتذاكر، أم تركها منطقة مفتوحة مع تطوير الصناعات الحرفية البسيطة غير الضارة بالآثار، ولم ينته المؤتمر إلى شيء، وأعتقد أن أعظم ما فى القاهرة أنها مدينة حية، ولا يصلح التعامل معها بأسلوب منطقة الأهرامات، أى تحويلها إلى منطقة مغلقة، كما أن أى مشروع للتطوير يجب أن يأخذ فى الاعتبار الطابع التاريخى لتخطيط وتصميم المنطقة، والمشروعات المطروحة حاليا لتطوير القاهرة الفاطمية بها العديد من الأمور العظيمة، لكن بها أيضا نقاط مقلقة، ولابد أن تؤخذ وجهات نظر المعماريين والآثاريين المتخصصين فى الاعتبار، فلا يمكن إضافة مبانٍ لا تتناسب وطبيعة المكان، ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعى مع المتخصصين وتطبيق أفضل الأفكار.. ويجب أيضا أن يكون لدينا فكر استباقى فى التعامل مع المناطق الأثرية، بمعنى ألا يتم الانتظار حتى تتراكم المشكلات وتتعقد، ثم نبحث عن حلول، بل يجب التصدى لتلك المشكلات فى مهدها، ويجب أن يكون هناك تخطيط شامل لتلك المناطق، وليس مجرد إجراءات جزئية.
مواجهة العشوائيات
وكيف تنظر إلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مواجهة العشوائيات؟
الدولة تبذل جهدا عظيما فى هذا الشأن، وأتمنى أن يتم التعامل مع هذا الملف بصورة جذرية، فالقضاء على عشوائية البناء والمناطق غير المخططة يمكن التعامل معه بأكثر من أسلوب، فهناك مناطق لا يصلح معها سوى الإزالة بالفعل، ولكن هناك مناطق أخرى يمكن تحسين الحياة فيها، من خلال خلخلة التكدس الموجود بها وخلق فراغات خضراء لتحسين الصحة العامة، ولدينا العديد من الدراسات التى أشرفت شخصيا على بعضها يمكن أن تفيد فى هذا الشأن، فيمكن هدم بعض العقارات بما يسهم فى رفع كفاءة أحياء بالكامل، دون الحاجة إلى تدخلات كبيرة.. لكن الأهم بالنسبة للمستقبل هو مواجهة أسباب ظهور العشوائيات من الجذور، وفى مقدمتها تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر وتحرير الإيجارات السكنية والتجارية وتنشيط الاستثمار العقارى، وأتمنى أن تتدخل الدولة بحسم فى هذا الملف، كما يتم التعامل حاليا بحسم فى الكثير من الملفات.
وما رأيك فى النشاط العمرانى الكبير الذى تشهده مصر حاليا، خاصة مع إقامة العديد من المدن الجديدة لاستيعاب الكثافة السكانية.. وهل هناك نصيحة معينة يمكن أن تقدمها فى هذا الشأن؟
هذا الموضوع يعيدنى إلى أول ورقة بحثية أصدرتها مع MIT فى سبعينيات القرن الماضى، وكانت تتعلق بالمدن الجديدة، وكانت الدولة قد بدأت بالفعل فى بناء ثلاث مدن ضمن الجيل الأول للمدن الجديدة وهى (العاشر من رمضان - السادات - العامرية أو برج العرب حاليا)، هذه المدن كان من المفترض أن يقطنها حاليا 9 ملايين مواطن وفق التخطيط الذى أعده أساتذتى فى ذلك الوقت، ولكن الدولة اتبعت سياسات متضاربة فى التعامل مع تلك المدن على مدى عقود، وبدلا من أن تتحول تلك المدن إلى مراكز جذب بتوفير فرص العمل بها، صار الناس يقطنون فيها وأعمالهم فى القاهرة، وبالتالى لم يتحقق الهدف منها، ومعظم السكان الذين يفترض أن يعيشوا فى تلك المدن تحولوا إلى بناء عشوائيات داخل القاهرة ليكونوا بالقرب من أعمالهم، وبالتالى علينا أن نستفيد من تلك التجارب عند التخطيط للأجيال الحالية من المدن الجديدة، فلابد أن يكون هناك تخطيط إقليمى لتلك المدن، بحيث تحقق الهدف منها وهو تفكيك الكتلة السكانية، ويقطنها ملايين يعملون بالقرب من وظائفهم، ولابد من بدء تخطيط كل مدينة أن يكون لها أساس اقتصادى تقوم عليه.
ونصيحتى الأخرى أيضا أن يتم عند تخطيط هذه المدن الجديدة مراعاة ثقافة السكان وعدم تجاهل العديد من الأشكال الخاصة بنمط الحياة، فعلى سبيل المثال «التوكتوك» صار اليوم من وسائل الانتقال الأكثر شيوعا فى مصر، وبالتالى ينبغى التعامل معه، وتوفير سبل حضارية لاستخدامه، مثل توفير طرق خاصة به كما تفعل بعض المدن الكبرى بتخصيص حارات للدراجات الهوائية، فلا يمكن تجاهل ثقافة السكان عند تخطيط المدن الجديدة حتى نضمن تيسير انتقال الناس إليها، ومع الوقت يمكن تغيير تلك الثقافة.
قناة جونجلى
باعتبارك من عشاق تاريخ النيل، ولديك كتاب متميز بعنوان «النيل.. مدن وحضارات على ضفاف نهر».. كيف تنظر اليوم إلى محاولة البعض تحويله من وسيلة للتكامل إلى أداة للصراع؟
- بالتأكيد أنا أتفهم القلق المصرى من قضية سد النهضة، لكن حقيقة أرى أن ذلك القلق مبالغ فيه بعض الشيء، وهو يتعلق بمخاوف مستقبلية أكثر منها حالية، وشخصيا فقد زرت جميع دول حوض النيل، وقضيت بها 9 شهور لإجراء دراسات حول النيل، وفى تقديرى أن «النيل هو هبة مصر»، فمصر وخصوصا قدماء المصريين هم الذين منحوا شهرة عالمية لذلك النهر، ولكن المشكلة أن الكثير من القضايا الخاصة بالنيل يجب أن توضع فى إطارها الصحيح، خاصة مع العديد من الدول التى توجد بها منابع النهر، وقد تسببت بعض المشكلات التاريخية، ومنها على سبيل المثال ما حدث بشأن اتفاقية 1959، وتجاهل المطالب الإثيوبية بالدخول فى مفاوضات تلك الاتفاقية فى التأثير على العلاقات المصرية الإثيوبية، وأدى ذلك الموقف مثلا إلى قرار هيلا سلاسى بفصل ارتباط الكنيسة الإثيوبية عن الكرازة المرقسية فى مصر بعد 1600 سنة من الارتباط، وبالتالى أنا أميل إلى الحلول التشاركية، وعدم الاستماع إلى وجهات النظر الداعية إلى الصراع، كما أننى غير قلق من المستقبل، فتاريخيا لم يكن النيل سببا فى الصراع بين الدولة المطلة عليه، صحيح كان هناك قلق، لكنه لم يصل إلى الصراع والمواجهة، ولابد أن تكون هناك أفكار غير تقليدية فى التعاون مع دول حوض النيل، بعض تلك الحلول ثقافى والبعض الآخر اقتصادى وعمرانى، ومن الخطوات الإيجابية جدا التى تقوم بها الدولة حاليا، المشاركة فى إنشاء سد واو فى جنوب السودان، وهذه خطوة ضرورية ومحمودة، وأتمنى أن تتكرر مع مختلف دول حوض النيل.
وإذا أردنا التعامل فى مصر مع مخاوف المستقبل، فينبغى التحرك على ثلاثة مسارات لا غنى عنها، الأول هو ترشيد الاستهلاك، ولابد أن تكون لدينا حملات مكثفة للتوعية بهذه القضية الحيوية، وثانيا استخدام تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات 20 مليون مواطن فى المحافظات المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وثالثا توفير مصادر أخرى للمياه، وهنا أشير إلى مشروعات مهمة ينبغى إعادة الاهتمام بها مثل قناة جونجلى، التى يمكن أن تضاعف مواردنا من مياه النيل الأبيض، وهى مشروع مائى مهم لمصر وقد شهدتُ شخصيا بدايات العمل به وتوقفه نتيجة الصراعات الأهلية فى تلك المنطقة، وعلينا أن نعيد الحديث مع جنوب السودان لإحياء هذا المشروع وأن يكون ذا أولوية استثمارية لنا.