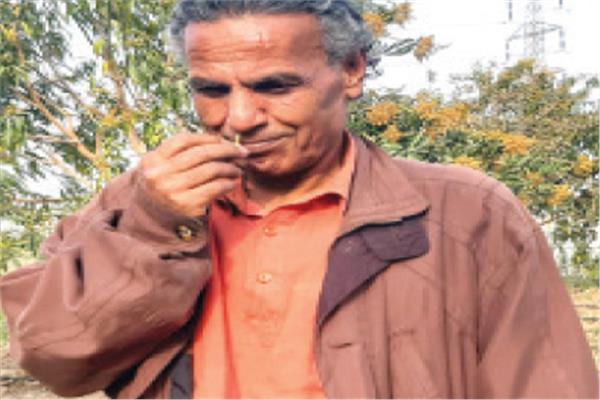محمد سليم شوشة
بدا واضحا من البداية أن المشروع الروائي لحمدي أبو جليل له ما يميزه ويشكل خصوصيته ويمنحه مذاقه الخاص أو المختلف عن السائد، واستمرت هذه الملامح السردية من أول عمل سردى له حتى آخرها وهو رواية «ديك أمى»، الصادرة مؤخرًا عن دار الشروق، ويظهر واضحا كذلك مقدار الارتباط بينها جميعا فيما هو أقرب لأن يشكل سلسلة متصلة من حكاية واحدة لها فصول ومنعطفات وتفاصيل غنية وثرية يشعر أنها بحاجة لأن يتم التركيز عليها أو معاودة سردها وتناولها من منظور معين لم يكن يركز عليه فى المرة السابقة.
وأولى سمات سرد حمدى أبو جليل المهمة التى يمكن أن تكون مجسدة لأحد مظاهر التجديد لديه هى الميل بالخطاب الروائى إلى شكل السيرة الذاتية، والحقيقة أنه لا يكتب على الإطلاق السيرة الذاتية، بل الأكثر دقة أنه يختار عن عمد أن يوحى ويوهم المتلقى أنه يلتزم شكل السيرة الذاتية التزاما حرفيا، وهذا فى الأصل إنما هو مجرد تكنيك سردى يختاره عن قصد للزيادة فى الإيهام القصصى أو إقناع المتلقى وتحقيق التصديق، بالطبع هناك كثير من الحقائق فى كتابته الروائية، بل قل إنها كلها حقائق ولكن ليست أحداثا شخصية منقولة حرفيا، وهناك دائما مساحة كبيرة من التخييل وتفاعل هائل بين نسقى التخييل والحقيقة أو السيرة، ومن يعرف حمدى أبو جليل يدرك هذا تماما، وأتصور أن هذا الأمر يحتاج إلى شهادة تفصيلية من أحد أفراد عائلته الذين لهم صلة بالأدب، فحمدى لا ينقل سيرته الشخصية وسيرة العائلة نقلا حرفيا، وإذا كانت كل هذه الشخصيات لها مرجعياتها ومصادرها الحقيقية التى نقلها عنها فهى ليست هى بالضبط سواء من الإخوة والأقرباء والجيران وإنما كل هذا كما ذكرت هو استراتيجية سردية اختارها عن قصد، ومن الطريف أننا نجد أن هذا الشكل هو نفسه الذى مالت إليه الكاتبة الفرنسية الحائزة قبل عام على جائزة نوبل آنى إرنو، وهو شكل مقدر ومفهوم ومعروف أنه تكنيك سردى واستراتيجية بنائية للخطاب الروائى يعمد الكاتب إليها ليحقق مزيدا من الإيهام والتصديق والإقناع للمتلقى.
السمة الثانية المميزة أو المختلفة تماما عن السائد فى خطاب حمدى أبو جليل هى الشفاهية والحقيقة أن هذه السمة تنتج آثارا معقدة ومركبة فى الخطاب الروائي، حيث لها ميزات وطاقات كبيرة كما لها مخاطرها أو مزالقها أو سلبياتها المحتملة كذلك، فمن جانب يبدو السرد ذى الطابع الشفاهى الذى يتمثل تقاليد حكاوى الجلسات والقعدات والسيرة الشعبية يبدو دافئا وحميميا وبعيدا عن الاصطناع، وكأنه دفق قولى فى أقصى درجات العفوية والصدق، وهنا يتحقق التوارى والاختفاء أو التراجع التام لمظاهر الصنعة والاشتغال التخييلى والدمج التركيب والاختلاق والتمثيل وتحرى المطابقة بين الحياة والخطاب. وفى الوقت نفسه تهيمن على هذا الشكل من الخطاب السردى سمات السرد الخبرى غير المشهدى فى أغلب مساحات السرد ووحداته أو أحداثه وتفاصيله، حيث يهيمن الخبر فى مقابل المشهد، أو لنقل إن المشاهد تبدو حاضرة أو متشكلة عبر الخبر، وهو تكنيك مختلف عن أن يكون الخطاب من البداية منشئا وبانيا لمشاهد أو حياة مشهدية وليس مخبرا أو حاكيا لتفاصيل وتاريخ طويل يكون المتلقى قادرا على استخلاص المشاهد منها، وهكذا يمكن أن نقول إن المساحة المتاحة لمشاركة المتلقى فى استنباط ملامح الخطاب وتفاصيل العالم أوسع فى هذا النوع من السرد الأقرب للشفاهية والأقرب للسير والملاحم الشعبية؛ لأن عقل المتلقى سيعمل على تحويل الخبر إلى مشهد ويكمل أبعاده التصورية والحسية بنفسه فى ضوء ما تم تقديمه له من معطيات.
وهاتان ميزتان لهذا الشكل من السرد، ولكن المخاطر والسلبيات المحتملة قد لا تكون هينة كذلك لأن هذا السرد الشفاهى أو الأقرب للشفاهية والطابع الخبرى قد يستعصى على التنظيم فى بعض الأحيان، ويأخذ شكلا أقرب للارتجال ومن هنا يكون عرضة للترهل والتكرار، والحقيقة أن حمدى أبو جليل كان يتحرك دائما فى هذه المساحة البينية الفاصلة بين الكتابى والشفاهي، فهو من جانب يحافظ على الشفاهية ليستمد منها الدفء والحميمية والقرب وعفوية السرد أو إن شئنا الدقة قلنا عفوية القول، ومن جانب آخر كان واعيا تماما لحدود النوع الأدبى الذى يكتبه وهو الأدب الروائى بما يتطلب من التنظيم والتجديد، وحتى ما كان من التكرار فهو مقصود ويمثل النسبة المعتادة من السرد المكتوب حيث يؤدى دور الربط وتنشيط الذاكرة ودمج التفاصيل ببعضها وأحيانا التأكيد أو التذكير.
بل إن هذا الخطاب الروائى الذى اعتمده حمدى أبو جليل لنفسه من الاشتغال على المساحة الفاصلة بين الكتابية والشفاهية كان فى أغلب أحواله مجددا إلى أقصى نزعات التجديد، ويتحقق ذلك كما أشرت فى توظيف هذا الشكل السيرى والإيهام بالذاتية لإنتاج الصدق، وكذلك ما يعرف بالميتاسرد أو الكتابة وراء الكتابة أو عن الكتابة، فنجده فى كثير من رواياته يشير إلى فكرة الكتابة نفسها ويتحدث عن نفسه بوصفه كاتبا روائيا ويشير إلى رواياته السابقة ويخاطب المروى عليه ويتحدث عن فن الرواية والروائيين السابقين الذين أعجبه أسلوبهم مثل خيرى شلبى أو يشير إلى ماركيز ويذكر بعض قراءاته هو الشخصية بوصفه مؤلفا للعمل، فيما يعرف بكسر الإيهام، والحقيقة أن هذه الإشارات الحقيقية هى بالأساس داعمة للإيهام من حيث كسره وهذا هو التجديد، فهو حين يذكر شيئا حقيقيا يخصه هو باسمه – حمدى أبو جليل - أو بأحد صفاته فإنما يقصد تحقيق فعل الكتابة وتأكيد فكرة النقل الحرفى للواقع والتاريخ، أو بالأحرى الإيهام بأنه ينقل حرفيا كل تفاصيل حياته الشخصية، وهو فى الحقيقة لم يكن يفعل هذا أبدا، فإذا ذكر اسم ابنه أو أخيه فهو يمكن أن يعد ضمن استراتيجيته الشاملة فى الإيهام والإقناع بحقيقة ما ينقل ويجسد ويصور فى عالمه الروائي، وهذا كله تجريب وخروج عن السائد والمعتاد والشكل النمطى المألوف للكتابة الروائية.
ورواية ديك أمى ربما تكون هى خلاصة إبداع حمدى أبو جليل فى شموليتها وعمقها وإذا كانت رواياته السابقة تتصل بها بشكل ما أو تعد رصدا لأبعاد أخرى من الحياة نفسها، فإن هذه الرواية ربما تكون الأهم فى سلسلة إبداع حمدى أبو جليل حيث تخص الأم التى هى مركز هذه الحياة وسر نهضتها وقيامها أو تحولها من الموات والجفاف والانقطاع إلى الحياة والازدهار والنماء والمضى فى تيار الحياة الطبيعية. إنها رواية عن قيام الحياة عموما وعن أسطورة المرأة التى تصبح واهبة للحياة، تعبر عن المرأة المصرية بشكل عام وعن الأم بشكل مطلق وليس عن المرأة البدوية خصيصا، بل عن كل أم وكل امرأة تقاوم الجفاف والموت وتحارب النهايات وتمنح الأغصان الضامرة المعرضة للزوال حياة جديدة وجذورا إضافية تمدها بأسباب العيش. وفى هذه الرواية تتشكل الصورة الحقيقية للأم عموما بوصفها المانح الأول للحياة، المرأة/ الأم التى هى البناء الحقيقى والمشكل الأول لإيقاع أسرتها، تقودهم عبر بوصلة داخلية دقيقة، ومهما تبدلت سياقات العيش تبقى كما هى راغبة فى الحياة مانحة إياها لمن حولها، تتشكل صورة الأم بوصفها ضميرا حيا ونابضا وبوصفها معلما وملهما، تعلمت من الحياة نفسها وتخرجت فى مدرستها وأصبحت مؤهلة لكل شىء ولكل جانب، تكيف الحياة على قدرها وتحاربها وتطوعها وتعاندها وتلينها أو تجبرها على التماشى مع تياراتها، أو لنقل إن هذه هى العلاقة الجدلية بين الأم والحياة حيث تجبر إحداهما الأخرى على مساراتها بما يجعلهما فى النهاية يمضيان معا فى توافق وتناغم وتفاعل يجعل كل شىء ممكنا.
إنها رواية عن الحياة وعن الأم، حيث تصير الأم هى نفسها الحياة، فلا فارق إطلاقا أو مسافات بين الاثنين. كل منهما تشكل الأخرى بإرادتها ورغبتها، وتطبعها بطابعها أو بمساراتها. وهى هكذا رواية مختلفة لأنها تقارب أعماق الحياة المصرية حتى وإن ركزت على فئة بعينها، فهذه الرحلة من النضال للأم التى ربت أبناءها وتكفلت بهم بعد الأب لا تختلف من حيث الجوهر عن أى أم مصرية عاشت الزمن نفسه أو الظروف والسياقات نفسها حتى وإن لم تكن من أصول بدوية فى أقصى جنوب الفيوم، برغم اختلاف الفئة أو العينة المنتقاة لكنها تعبر فى النهاية عن مجمل تجارب الأم المصرية المعاندة العامدة إلى منح كل أسباب الحياة والتفوق والتقدم والإصرار على العيش لأبنائها. الأم بصورتها المناضلة المكافحة فى أدق التفاصيل وأصغرها، المقاومة فى نعومة وتدرج لذكورية المجتمع وعاداته وتقاليده سواء العامة فى مصر كلها أو الخاصة بفئتها أو مجتمعها البدوي، فهى أول امرأة تذهب إلى سوق القرية بمفردها لتباشر مصالحها واحتياجاتها واحتياجات أبنائها اليتامى، وهى أول امرأة تباشر الزرع بنفسها فى هذه البيئة بعد أن أوشكت البيت كله على الزوال والانهيار، فهى مفارقة بيت الموت الذى جاءته فمنحته حياة جديدة وأملا وبقاءً واستمرارا، بل وازدهارا فى التعليم ولو كان أقل من المأمول.
ولهذا فإن أبرز القيم الجمالية التى تشكل نسقا ممتدا فى الرواية من أولها لآخرها هو مفارقة التحول من الموت إلى الحياة، وهذه المفارقة بطابعها المركزى تتمحور حول الأم أو بالأحرى تمثل الأم منبعها أو مصدرها، وهذا هو سر هذه الأم التى حولت بيت الموت إلى بيت حياة، وبعد أن كانت قد قاربت اليأس أو أوشكت على الموت هى الأخرى، دبت فيها الحياة حتى تمنح كل ما حولها حياة جديدة، فكأن بذور المقاومة مغروسة وراسخة بداخلها. إنها رواية عن الحياة المصرية بكل أعماقها وتفاصيلها، عن الزراعة ومواسمها وطقوسها وأفراحها ومخاطرها وخسائرها ومباهجها وأعيادها، حيث تصبح للحياة إيقاعاتها المختلفة تماما عن إيقاع المدينة، إنها حياة أخرى لما موازينها التى تنضبط على حركة الماء والبذور والحرث والحلب وإيقاع الإنسان المزارع المصري، بما للمرأة فى هذه الحياة من أدوار، وبما للرجل من أدوار أخرى، ولما يكون بينهما من التقاطع والتداخل، رواية عن الزواج والطلاق والنجاح والفشل والأطعمة والملابس والتعليم والسفر والاغتراب والعودة والمرض وطقوس التداوى بين الطب الشعبى والطب الحديث وهكذا تمثل تأريخا شاملا وواسعا وعميقا لكل ما يموج فى أعماق حياة الإنسان المصرى عموما.
فى الرواية تجليات حياتية عديدة وتكاد تكون لا نهائية بإشاراتها وعلاماتها، ففى هذه الحياة تتشكل صور العمل والجهل والخرافة والإرادة والوهم والصدق والكذب والخير والشر وغيرها الكثير من القيم الحياتية المتصارعة أو المتناقضة بكل مستوياتها ودرجاتها، بين العطاء والأنانية والحلم والذكاء والغشم والعبط، بين التحضر والجلافة، عن الحب والكراهية والقدرة والعجز، والتحضر والوسطية والرجعية والتخلف، وغيرها الكثير والكثير مما صوره حمدى أبو جليل فى خطابه الروائى بشكل ناعم ومتدرج وهو يغوص مع القارئ فى أعماق هذه الحياة بكل يسر وكأنه يوهمه بأنها محض دردشات عابرة أو فضفضة غير محسوبة، وهى فى الحقيقة عامدة إلى أقصى درجات الطموح إلى الغوص فى أعماق هذه الحياة ورسم ملامحها فيما يشبه أشعة التصوير بالسونار أو الأشعة على المخ ورسم القلب.
وإذا كان الخطاب الروائى فى لغته يميل إلى العامية فى كثير من الأحيان فربما يكون ذلك بدافع تمكين هذه الشفاهية وتغليبها أو تأكيدها وتقويتها، وجعلها نابعة بشكل مباشر من العقل الروائى الذى يريد أن يحافظ على هذه الذهنية الغارقة فى الشفاهية والعامدة على التخلص من آثار التعليم أو مقاومة تبعاته، فيكون الراوى أو صاحب الصوت الرئيس فى السرد محافظا على درجة التصاقه بالبيئة واللغة المحلية وغير متمرد عليها أو خارج عنها بشكل كامل إلى الفصحى التى هى لغة التعليم، فهو أمر يمكن فهمه على أنه ميل إلى ما هو حقيقى أو متحقق بشكل فعلى فى الحياة بعيدا عن أى مظاهر من الاصطناع أو الانتقاء، فهذه اللغة التى هى على طبيعتها هى فى منظور العقل الروائى المادة الخام الحقيقية التى إذا ما دخلت عليها أى تصريفات لتحويلها إلى الفصحى فإن هذا يمثل شكلا من التشويه أو الاصطناع الذى يمكن أن نلمس فى الأعماق رغبة فى مقاومته أو رفضه.
وهكذا تكون لغة الخطاب الروائى قادرة على تمثيل لغة الشخصيات ومنطقهم بل والتماهى التام معهم والتعبير عن لغة المجتمع بشكل كامل فى صورتها الحيوية الحافلة بالأمثال الشعبية والتعبيرات الدارجة التى تصور الحياة فى حركتها وتدفقها، لغة ترتبط بمفردات الزراعة والطعام، لغة الغازين واللصوص المتباهين أو لغة الأقارب بما يموجون به من مشاعر الحب أو الكراهية والتحاسد والنميمة والانتقاد بكل ما ينعكس عليها من حركة شعبية وإيقاع حياتى يومى يتراوح بين الثبات والتغير. حيث يكون هناك ما هو ثابت من الأفعال والأنماط الحركية والأحداث بقدر ما يكون هناك من التغير والاختلاف الناتج عن تغيرات الزمن وأفعاله من الشيخوخة والموت والمرض والنضج والتعليم وغيرها من الأحداث الجديدة التى تتضافر مع الطقوس والعادات والحركة اليومية فى مزج وتداخل بين الثابت والمتحول بما يشكل نسيجا حياتيا ثريا ومتنوعا.