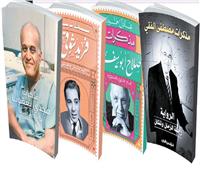فى البداية يروى الأديب سمير الفيل مشاهداته فى مدينة دمياط التى يعيش فيها حتى الآن: فى العيد الكبير، خلال طفولتى شاهدت زفة الجاموس فى شوارع المدينة، وهى مزوقة بالورود الملونة والياسمين. يصيح الرجل: بكرة من ده بكام؟
ـ بجنيه وربع.
ـ عند مين؟
ـ بزوم الجزار.
يسبق الزفة أحيانا طبلة لجمع الأطفال، وفى بيت الشيخة إحسان تستقبل الحارة ذبح عدة عجول، المرأة التى لا تنجب تغمس سبابتها اليمنى فى دم الذبيحة، وترسم عدة أهلة على وجهها، وأحيانا على عنقها.
وقد شاهدت بنفسى « حارة العيد» وهى قرب بيت الكاتب المسرحى الراحل -الذى فقدناه مؤخراً- محمد أبوالعلا السلاموني، وهى تجهز المراجيح، وتستقبل حلقات الذكر، وقرب العصر تمتد الموائد على أبسطة من قصاقيص القماش أو الحصر، وفى العيد الكبير، يذهب الصبية إلى مدينة رأس البر ليسبحوا إذا كان الوقت صيفا، أو يجلسوا قرب اللسان إذا كان شتاء.. فى مقهى شاهين الذى يرفع صور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، يأتى طاهر أبوفاشا ليجالس، وبصورة أقل يزور فاروق شوشة صديقه زكريا الحزاوى رئيس تحرير جريدة « أخبار دمياط»، وهى توزع بالاشتراك، ومقرها حارة النفيس.
فى أغلب القرى المطلة على النيل يقضى الأطفال يومهم فى رحلات دورية على ظهر مراكب تدور بالموتور أو الشراع وتوجد عدة مراسى مجهزة لهذا الغرض.. فى المساء تعرض أفلام الأسود والأبيض منه « الجريدة المصورة»، وفقرة الرقص الشعبى «فدادين خمسة» حول الإصلاح الزراعي.. بينما قالت الأديبة د.رباب كساب: تبدو ذكرى العيد بعيدة جدا، فهو قرين الطفولة لا الكبر، لا أذكر متى انتظرت العيد، وفى حضنى فستانى الجديد، مرت السنوات سريعا وإن بقيت الطفلة التى تلهو وتلعب تسكن فى مكان خاص بداخلي، كان للعيد طقوس خاصة فى بيتنا، فمثلما كنا نرتدى ملابس جديدة، كان البيت أيضا يتزين بالجديد كانت أمى تحرص على أن تكون الفُرش والستائر كلها جديدة، كأن العيد يأتى ليتغير معه وجه الحياة، طقوس انتظار العيد كانت بالنسبة إلى أجمل من العيد ذاته، تنشغل البيوت بعمليات التنظيف التى كنا نشارك فيها بإغراق أنفسنا بالماء ووعد من أمى أن تترك لنا السلم لننظفه، فكنا وأطفال الجيران نحوله إلى مهرجان نتراشق فيه بالماء لأطول فترة ممكنة، وكان حظ طفولتى أن شهدت أعيادى فى الصيف فكان انطلاقنا بلا حد، غير أن صباح العيد كان يحمل بعضا من الحزن فكل الجيران قد هجروا المكان لقراهم لزيارة الأهل أو نحر الأضحية هناك، كنت أشعر فجأة بأن الحى الذى أقطنه قد تحول إلى صحراء بعد سفر الكل بينما جدتى تسكن نفس المدينة وزيارتنا لها كانت منتظمة فلا سفر ولا رحيل، لكن ما إن نذهب إلى هناك ونلتقى فى بيتها بأولاد خالاتى وأخوالى حتى يعود للعيد صخبه.
وفى ختام تقول الأديبة منى العساسي:
الشعب المصرى من الشعوب التى تعرف كيف تحتفل بالأعياد والمناسبات، فتحولها إلى مهرجانات كبيرة، ربما يرجع ذلك لعوامل عديدة منها الجانب الحضارى واعتدال المناخ، لقد حضرت العيد فى عدد من الدول لكنه لا يشبه مصر، فلا أطفال فى الشوارع ولا ملابس زاهية ولا أصوات صواريخ ولا معايدين يلفون الشوارع، ربما تتشابه كل المحافظات فى طقوس الاحتفال بالعيد، لكن أجمل الأعياد قضيتها فى قريتى فى الشرقية، أتذكر كيف كانت جدتى فاطمة -رحمها الله- تضع بنفسها أطباقا ممتلئة باللحوم وتبدأ أمى بتوزيع اللحمة علينا، وزوجات أخوالى يشاركنها فى التوزيع، ومنذ اليوم الأول لملابس العيد فى المنزل والدولاب برمته يفرغ لفستان العيد والجزمة والشنطة، وكل ساعة يجب أن نذهب لنطمئن عليها، وكل زائر من الأقارب يجب أن نجره جرا إلى الدولاب ليرى ملابس العيد، ويوم الوقفة تعمل أمى طوال اليوم غسل وترتب المنزل، وفى الليل نظل مستيقظين منتظرين الصباح، فلا يأتى النوم إلا فى الربع الأخير من الليل، توقظنا أمى بصعوبة بالغة مع أذان الفجر، نرتدى الملابس الجديدة وتضع لنا الفطور وتتركنا نتناوله أمام التلفزيون حيث تكبيرات العيد بالمسجد تنافس صوت صفاء أبو السعود على القناة الأولى «أهلا بالعيد».
فادية البمبى