لم تجد الكاتبة السعودية فاطمة عبد الحميد حلاً لحيرة الإنسان وعجزه - وخوفه بطبيعة الحال - أمام لغز الموت سوى التلصص على دفتر مَلَكه!
فى روايتها الأحدث «الأفق الأعلى» التى وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية جعلت من مَلَك الموت راويا لنتابع حكاياتنا من منظوره؛ كيف ينظر لحيرتنا وقلة حيلتنا، وكيف ومتى يتعاطف معنا، وكيف نبدو فى عينيه وما آخر ما يمر على خاطرنا فى لحظاتنا الأخيرة؟! بل نتابع حيرته هو نفسه أمام ما يعرف أنه قدره الذى لا فكاك منه.
نرى توقيتات سجلها لمواعيد قبض فيها أرواح آخرين.. امرأة طموحة أفنت عمرها فى العمل، وفتاة تفر من خوف مجهول على الطريق، ومريضة كانت تعانى مرضا عضالاً، وأب استقبل لتوه مولوده الجديد بعد طول انتظار، وصيدلى كان جانيا وضحية فى عمليه إغواء مستمرة.
ولكن كلها حكايات عرضية تتقاطع أحيانا مع حكاية سليمان الذى يروى لنا ملاك الموت قصته تفصيليا منذ أن اقتلعته امه من اللعب فى الشارع وزوجته لنبيلة ابنة خالتها التى تكبره ب11 عاما، وحتى الساعة التى قبض فيها روحه فى مباراته الأخيرة بعد أن تجاوز الخمسين، دون أن يستجيب لرجاء زوجته بألا يقبض روحه ليلحق بها إلا بعد 11 عاما، كمحاولة أخيرة لردم تلك الهوة الزمنية التى عذبتها فى تطويع الطفل الذى صار زوجها.

ولكن الحكايات ليست مقبضة كما تبدو فى هذا الإيجاز، وهنا تكمن موهبة الكاتبة التى غزلتها معا وطعمتها بلمحات ساخرة بمقادير محسوبة لتنحى الحزن والخوف الفطرى المصاحب لتلك الأفكار، وتزرع بدلا منهما أفكارا أخرى حول الحب والبيت والأسرة والبحث المضنى عن معنى السعادة، والأهم أنها اقتربت بجرأة من أكبر مخاوفنا لتمنحنا فرصة لنطل من أفق أعلى على ما نخافه، على الفرص المهدرة التى نخلفها وراءنا فى اللهاث المحموم خلف المجهول.
وتقول فاطمة لأخبار الأدب إن كل شيء بدأ بتساؤل فى مناسبة عزاء عائلي: ماذا لو أنه وأمام كل هذا الجهل بالموت، خرج بنفسه، نائبا عنا فى الحديث عن الحياة هذه المرة، ساردا لنا بعضا من سيرته الذاتية.
ومن خلال قصصنا نحن! ألن يكون هذا الحديث هو الصيغة السّحرية البسيطة لفهمه؟ حين نرى كيف يؤوّل لحظاتنا الأخيرة معه، وهو يروى لنا تأثيرنا عليه، والذى لم نكن ندركه، ونحن فى حالة مرتبكة بين الهروب، والتسليم بالأمر الواقع.
ويأتى فى فصل ساخرا من أساطير الخلود التى اعتصمنا بها، وفى آخر ضجرا من مطاردته لبعضنا، أو منبهرا من طاقة المقاومة التى لا تنفذ من بعضنا الآخر، أو ناثرا همومه ووجعه وخوفه من مصيره المحتوم، حين يقبض على آخر روح تدب على هذه الأرض.
والراوى الوحيد فى الرواية هو ملاك الموت.. وبما أنه «ما من شيء أقرب إلى الموت مثل الحب المتحقق»، على حد قول «إيفان كليما»، فقد كانت قصة الحب بين الجد سليمان، والجارة سمر، مدخلا للموت، ليحدثنا هو عن نفسه: تساؤلاته، دهشته، مخاوفه، صبره، وما أثّر به عبر القرون الماضية وما نسيه... والأهم: كيف يرانا نحن العابرين؟!
وهنا تتحدث فاطمة بتفصيل أكبر عن الرواية والكتابة والترشح للبوكر..وكيف تلقيت خبر ترشحك للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية ثم القصيرة بعد ذلك؟ هل كنت تتوقعين ذلك؟
وأعتقد أن الكمال موجود فقط فى لحظات صغيرة وخاطفة كهذه، لحظة تعيد ترتيب العالم فى نظرك وتعطيه فرصة أخرى، كأن تقف على قمة جبل، والسماء تعتم على مهل من حولك، أو أن تغوص فى البحر غير آبه متى تعود لليابسة، أو لحظة كتلك التى تتلقّى فيها خبرا لم يكن متوقعا.
وهذا ما حدث معي فلم أكن أعرف موعد إعلان القائمة الطويلة، وتلقيتُ الخبر بمكالمة من صديق، كانت لحظة فرح صاخبة كنت فيها فى غاية الحدة كشعلة نار. أما فى إعلان القائمة القصيرة فقد كنت أعرف موعدها، وكنت محاطة بزملاء، لذا حضرتْ فى ذهنى بكل هدوء مقولة للشاعر والكاتب الأمريكى رايموند كارفر يقول فيها: «الأحلام، هى ما نصْحو من أجلها».
وقلت فى حوارك مع موقع الجائزة «تمنيت ألا يسلط الضوء علي» هل سيكون الترشح للبوكر فرصة لتغيير وجهة النظر تلك خصوصا إنها إحدى مزايا الجوائز لدى البعض أم إنها قناعة لن تتغير؟ بشكل عام كيف تنظرين للجوائز؟
وبالنسبة لى هذا أمر لن يتغير، لأنه يرجع لطبيعتى الشخصية، وليست ميزة أتباهى بها ولا نقصا يخجلني، لو كان أمر الأضواء وتكريس الحضور يشغلنى لرأيتنى مثابرة فى مواقع التواصل الاجتماعى مثلا، أو أشارك فى كل محفل اُدعى إليه، أنا اعتذر عن معظم الدعوات التى تصلني.
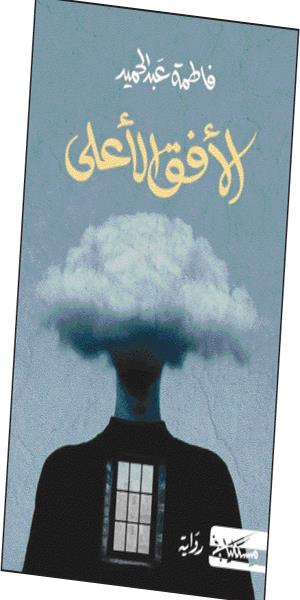
والجوائز لها فضل لا ينكره عقل فى انتشار العمل وترجمته للغات أخرى، لكنها لا تضمن للكاتب نفسه النجاح ولا الاستمرارية، لذا عليه أن يستفيق بسرعة من نشوة الفرح، ويعود إلى ما كان عليه قبل تلك الأضواء، عاكفا على قراءاته ومحاولات الكتابة مع حس مسئولية أكبر هذه المرة.
لنعد للبدايات. متى بدأت علاقتك الفعلية مع الكتابة؟
الكتابة هى صديقتى التى لم أجدها فى الواقع، أجادل نفسى فى الكتابة ولا أكتب عنها، كانت هذه طريقتى للفضفضة وأنا صغيرة. إذ أن أختى رسامة وتغيب عنى لساعات مع كراساتها وألوانها، أحدثها عن زميلة فى المدرسة أو معلمة فلا تلقى لى بالا، فأغضب منها وأتظاهر بالانشغال مثلها بدفاترى ولكنى لا أجيد الرسم، لذا بدأت بالكتابة هكذا فى صورة فضفضة لصديقة متخيلة.
وليست بالضرورة صديقة من لحم ودم، ففى بعض الأحيان كنت أتبادل الحديث مع كراسى طاولة الطعام، وغالبا لأصلح بينها. وفى مرات أخرى كنت أدس ضغائنى فى جوف شجرة ثم أملأ الفتحة بالطين! ربما هذه القدرة على خلق حوارات مع أشياء مختلفة نمّت هذه العلاقة مع الكتابة والوحدة تحديدا.
ثلاثة أعمال فى الفترة من 2010 وحتى 2016 ثم توقف طويل حتى 2022. هل كان هذا مخططا؟ كيف تخططين لنشر أعمالك على أى حال؟
لم يكن توقفا، كنت أكتب «الأفق الأعلى»، واستغرقت فيها وقتا طويلا ليس كله بيدي، فترة كورونا والحجر العالمى جعلتنى انقطع فترة عن الكتابة، لنقل إن الراوى فيها شكل ضغطا إضافيا مع تزايد حالات الوفيات والإصابات فى العالم بتلك الجائحة الغامضة فى حينها، انتقلت لعمل آخر، ذى طبيعة مختلفة تماما، حدث يدور فى ليلة واحدة، فى قاعة عرس.
وكانت فكرة عامة لخير من نوع آخر، ينتصر على الشر لأنه يتسم بالشر أيضا ولكن بشكل أقل، لكننى سرعان ما توقفت عن الكتابة عائدة للأفق الأعلى مجددا. بخصوص نشر الأعمال فى الحقيقة تقودنى دائما المصادفات واقتراحات الأصدقاء فأنا محدودة العلاقات سواء مع الناشرين أو الكُتّاب أنفسهم.
هل تكتبين نصوصك كدفقة واحدة أم يتطلب الأمر تحضيراً ما؟
هناك تحضير ذهنى يسبق الكتابة، وهو طويل بعض الشيء، درجات متفاوتة من اليقين ومشاهد رئيسية واستهلالات وأفكار بعضها يكتمل ذهنيا والبعض الآخر يحتاج للكتابة الفعلية ليكتمل وتتبين أهميته لك وللمشروع الذى تعمل عليه، لكن ما إن أبدأ بالكتابة وتبدأ الشخصيات فى التعاطى مع الحياة داخل النص، لا يعود أمامى إلا أن أخوض فى الخيال والكتابة أكثر، مع زمن صلاحية مفتوح بخصوص موعد النهاية.
هل كان حديث المرايا فى «ة النسوة» هو من أوحى لك بفكرة ملك الموت كراو فى «الأفق الأعلى»؟
فى «ة النسوة» كانت المرآة حرة، لها آراء ساخطة وساخرة وغريبة ضد أحكام أنشأها وطورها المجتمع. إنما فى الأفق الأعلى هذا الملاك كان يتحدث كما تحدث فى التراث الإغريقى والإسلامى من قبل، يقول ما نعرفه كلنا ويحاول أن يسبقنا بخطوة نحو الاستنتاج.

ولم اختلق على لسانه شيئا لم يمر علينا من قبل، لم أصنع له شخصية غير تلك التى تخيفنا وتؤلمنا، أضفت له حسا ساخرا وتلك طريقته فى الدفاع عن نفسه إذ أنه أخذ يكرر كنقار خشب ملح أن الموت له أشكال أخرى لا تتعلق به، الموت قد يكون فى انطفاء علاقة زوجين يجملان الحقيقة بالكذب، الموت قد يكون فى حب من طرف واحد لم يكن إلا انعكاسا لازدراء المرء لذاته، والموت فى حياة لا تعاش إلا كما يرتضى غيرنا! الموت فى عمر يمضى كله بانتظار شيء لا يجيء ولا تزهد النفس انتظاره! هذه بعض أشكال الموت والتى لا تقل قسوة عن الموت الذى نعرف.
تحاولين الحفاظ على خط ساخر فى مقاطع يرويها ملك الموت! بالتأكيد فكرة صعبة ومقلقة، كيف حققت هذه المعادلة؟ وهل خشيت من رد فعل القارئ.. ألا يتقبل هذه الفكرة؟
علينا أن نتذكر أن متعة السخرية هى عزاؤنا الوحيد عندما نتأمل واقعا يخرج عن السيطرة، بالطبع ليست السخرية المؤذية ذات الطابع «التنمري»، إنما سخرية تجعلك تضحك من واقع عام، موقف ثقيل لا يخفف وطأته إلا الضحك، هذا النوع من الضحك يقوى حتى مقاومة الإنسان الطبيعية. ضمير المخاطب الذى يتحدث معك كقارئ بشكل مباشر فى «الأفق الأعلى» بتلك العبارات القاطعة التهكمية مع تشكيل حوارات الموت الداكنة لتغدو أشبه بكتاب تراثي.
وربما تجعل القارئ يقتنع بأن محدثه الساخر هو أيضا محايد ولا يملك ضغينة شخصية ضده! أما بخصوص رد فعل القارئ هناك مثل يقول: «لو حسّب الزراع ما زرع!». أتجنب التفكير فى رد الفعل، وإن كنت فى داخلى مطمئنة، وأثق فى حدسى وفى القارئ ومستوى وعيه، فهو ليس وعياً صنعته القراءات فقط، فبعض الكتب مضللة، ولكنه وعى ربته بعض أفلام السينما وما يعرض فى المنصات مؤخرا والبودكاست والوثائقيات وقنوات أخرى كثيرة... جعلت المتلقى أوسع أفقا مما يظن البعض.
بمناسبة الحديث عن القارئ، هناك وجهتا نظر بشأن التعامل معه حاليا خصوصا بعد أن قربت وسائل التواصل بين الكتاب والقراء، البعض يحرص على أن تظل المسافة موجودة، وفى المقابل البعض الآخر يحب إشراك القراء فى كل مراحل الكتابة والمتابعة معهم حتى بعد طرح العمل. انطباعى يقول إنك تميلين إلى وجهة النظر الأولى. هل هذا صحيح؟
انطباعك صحيح لكن ليس حبا بالمسافات الفاصلة، ولكننى ذات طبيعة تدفعنى للتوحد مع النص الذى اكتبه، أغرق فيه تماما ولا أتحدث عن موضوعه إلا فى مرحلة المسودات النهائية، وليس لأننى من محبى السرية ولكننى أظل أغير وأعدل باستمرار فى عملية لا نهائية من عدم الرضا.
وحتى لتظن أن النسخة الأخيرة من العمل رواية أخرى من حيث استهلال الفصول وتغيير التراكيب والجمل، ولكن تبقى الشخصيات والنهايات كما كتبت أول مرة.
درست علم النفس، ويمكن القول إن المرض أو التأثير النفسى يفسر الكثير من تصرفات أبطالك، تسربين هذا خلال الكتابة لكن دون التركيز على طبيعة المرض نفسه وما يمكن أن يؤدى إليه من تداعيات، وربما لم يظهر التعامل الطبى المباشر سوى فى «حافة الفضة».. بالتأكيد الرواية ليست كتابا علميا، لكن كيف تقاومين الكتابة عن التفسير العلمى لتصرفات أبطالك، بشكل عام كيف أسهم هذا التخصص فى عملك ككاتبة؟
ولو أن أحدهم كتب أن شخصية ما مصابة بالفصام القهرى بسبب طبيعة الكيمياء فى تركيبة فصه الأمامي، هل سيشكل ذلك أى متعة للقارئ، أو إضافة للعمل الذى بين يديه؟ أشك فى ذلك كثيرا... لكن وصف ذاك السلوك القلق والمتشكك فيمن حوله والإحساس بأنه مراقب أو ملاحق هو ما يشكل فرقا فى وعى القارئ بتلك الشخصية المضطربة! هناك لحظة شعورية مهيبة حين تقع وحدك كقارئ على علة فى شخصية تعيش مأساتها ببالغ التعقيد فى الكتاب الذى بين يديك، وتبدأ فى تتبعها وتحليلها وحدك لأنك تتحلى بالجرأة الكافية للتحديق بعيدا عن سلطة الكاتب.
أعتقد أن من ضمن ملامح استثمار علم النفس فى الكتابة هو وجود الشخصية الثانية المخاتلة.. (لجين) فى الرواية الأولى، و (سمر) فى الأخيرة - فأنا أميل لاعتبارها شخصية متخيلة- كأشكال أخرى تعمل كمرآة «ة النسوة» لتحقيق رؤية أوضح. هل هذه القراءة صحيحة؟ وكيف ترين مسألة التأويل بشكل عام؟
برأيى لا وجود لشيء من قبيل هذا صحيح وهذا خاطئ بالعمل الأدبي. لا أحد منا يقف فى جانب الصواب لأنه من المحتم أن تصبح طريقة تفكيرى ونظرتى الحالية بالية بعد جيلين أو أقل، مع هذا التطور السريع الذى يفرض أثره حتى على ما نكتب ويبدو ثابتا لمجرد أننا فرغنا منه، برأيى مقولة الفيلسوف اليونانى هرقليطس « كل الأشياء فى تدفق دائم» تسرى حتى على الكتب الحية فى رفوف المكتبة... حتى على قراءاتنا أو تفسيراتنا المتغيرة لها.
هناك جرأة واضحة لا يمكن تجاهلها فى أعمالك سواء على مستوى تناول الموضوعات أو حتى على مستوى الكتابة نفسها واختيار الكلمات. اللافت إنها سبقت الانفتاح السعودى الحالي. ما تفسير ذلك من وجهة نظرك وكيف ترين استقبال القارئ السعودى والخليجى بشكل عام لكتاباتك؟
قليلة هى الأشياء التى نختارها فى الحياة، وما أكثر ما يفرض علينا، لكن ربما ولادتى فى جدة ودراستى وعملى بها ومخالطتى لكل هذه الثقافات المتمازجة فى مدينة بحرية تحتضن الاختلاف والتنوع أكثر من سواها جعل منى شخصا منفتحا ومتقبلا لأى اختلاف مهما كانت غرابته.
وهذه المرونة تخفف الأغلال عن يديك أثناء الكتابة، تجعلك أكثر تصالحا مع نفسك ومع الآخرين، وهذا هو ميزان الكتابة الفعلي: ألا تكون منحازا، أو حاملا لأى أفكار مسبقة قبل الكتابة، خاصة فيما يتعلق بكتابة الرواية، فالكثير من الأفكار «والجرأة أحيانا» تنمو خلال الكتابة ذاتها.
وأما عن القارئ السعودى فلا يخيفني، فهو نفسه الذى يتهافت على الكتب فى المكتبات ومعارض الكتب، ويحتفل الآن فى المسارح والقاعات وعلى أطراف الصحراء، وهو نفسه الذى يعمل فى البيئات المختلطة بكل رقى ورحابة صدر والكثير من الاستنارة.
منذ أعوام أصبحت بعيدة الآن حدث ما يمكن تسميته ب«الطفرة» فى الكتابة السعودية، أفرزت عدة أسماء شابه حتى لو كانت خلف أسماء مستعارة، لكن اختفى معظمها من الساحة فى ظروف غامضة! ما الذى حدث من وجهة نظرك؟ وكيف تنظرين لوضع الكتابة والقراءة فى السعودية حاليا؟
ربما قل إنتاجهم الكتابى لكنهم لم يختفوا، تجدهم نجوما فى مواقع التواصل الاجتماعي، اختاروا لأنفسهم ما يرونه الأنسب لهم ولما يطرحونه وهذا حقهم، والأمر لا يقتصر على الأسماء الشابة، هناك أيضا أجيال تسبقنا تخلت عن الكتب والمقالات واتخذت «تويتر» مثلا منصة لها.
وهذه السنة نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة معرضين جديدين للكتاب، بالإضافة لمعرض الرياض وجدة، أصبح هناك معرض المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. فعاليات ثقافية تنوعت بين أمسيات أدبية وثقافية وفلسفية مستضيفة مئات الأدباء والمتحدثين من كل أنحاء المملكة.
وتحت رعاية (الشريك الأدبي) وهو مشروع يدعم فكرة أن الثقافة أسلوب حياة، ويروج للأعمال الأدبية بشكل مبتكر. إذاً وضع القراء والقراءة مبشر، والكتب فى ازدياد والكُتّاب لا يملون المحاولة.
تراجعت الموضوعات الاجتماعية كثيرا فى منطقتنا العربية، وصار التعامل الروائى تحديدا يتحرك صوب موضوعات أخرى أكثر رواجا تسيطر عليها السياسة مثلا أو الإغراق فى التاريخ أو الدستوبيا، هل نتوقع تغييرا فى طبيعة أعمالك القادمة؟
ليس بحثا عن الرائج لكن لنقل تحديا أخوضه بحماسة منقطعة، جزء من باب الفضول حول فئة معينة من الناس صانها التاريخ والأعراف لكنها آيلة للزوال، لن استرسل فى الأمر، أنا فى مرحلة التوحد مع الفكرة، والجميل فى العقل البشرى أن الوقت لا يضيع حين تقضيه فى التفكير.
فى السياق نفسه هل تكتبين بمنطق تبنى القضية النسوية؟
أفكر فى الإنسان بمعناه الشمولي، أوجاعه وعثراته، تقلباته وخيباته، هذا المعنى هو الأقرب لنفسى وعقلى لذا أرفض هذه التصنيفات تماما، أسوأ ما قد يفعله كاتب بحق الأدب هو تقسيمه لأدب ذكورى ونسوي، أحب أن أكون ذات طابع حربائيّ متلوّن فى الكتابة.
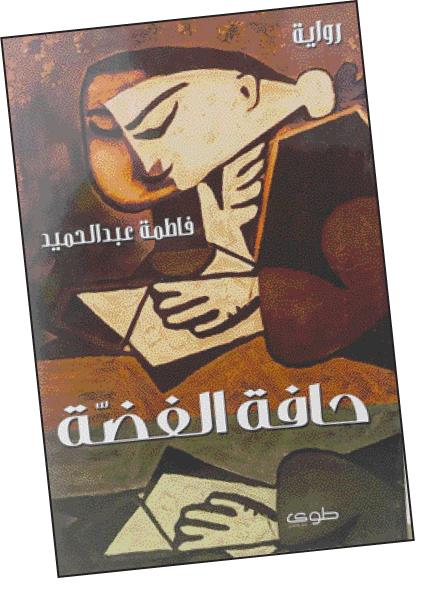
وقد أتنقل بكل حرية من قضية بطلة لقضية بطل، من فوضى فضة فى «حافة الفضة» لطفولة الجد سليمان فى «الأفق الأعلى»، من غواية رنيم فى «ة النسوة» لبؤس زياد فى قصة قرصة النحل فى مجموعة «كطائرة ورقية»، لمَ أحصر نفسى فى قضية المرأة طالما بوسعى أن أقحم قلمى داخل أشد المواضيع الخفية ولمس كل شيء فيها! ثم أن الرواية تفسد متى تحولت منبرا أو قاعة محكمة نتجاذب فيها ثأر الحقوق المسلوبة!
مجموعة قصصية واحدة. هل ستكررين التجربة؟ أم ستظلين مخلصة للرواية؟ ما الذى تطمحين إليه على مستوى النص؟
لم أخن القصة، ومازلت أكتبها وأنشرها متفرقة ما بين مجلات وصحف ومواقع تواصل، لكننى لم أجمعها فى مجموعة بعد. القصة القصيرة شجرة عملاقة، حتى عندما تظن أنك تكبر وأنت تكتب الرواية. يوما ما ستقف بجانبها أنت وكل كتبك اللاحقة فيما بعد، كما يقف عجوز وأحفاده قرب شجرة معمرة، وكل شيء سيبدو ضئيلا قربها مهما كبر.














