ما أقسى أن ترى الأشياء من زاويةٍ واحدة، ولأن الأمرَ كذلك، فإن حياة «مجلى أبو العِلا» من كفر أبو عَيُّوط، تحولت إلى لوحةٍ أشبهَ بالرسوم المُسطَّحة، الخالية من البعد الثالث، رجل له وجه واحد فى زمن تعددت فيه الوجوه.
غريب أن يبقى كذلك وهو الآن يقترب من الأربعين، ولكن مظهره يوحى إليك بأنه تجاوز الستين، يوشك على الانتهاء من مناقشة الدكتوراه التى يزحف إليها بثقة القادر عليها، موظف فى هيئة البحوث الزراعية، كان حلمه وأن ينال الدرجة التى نالها أساتذته.
وكثيراً ما كان يعتقد أن المشرف لا يرغب فى أن يجيزه الدرجة، خشية أن يأخذ مكانه ، فترهل فى رسالته حتى كادت أوراقُها أن تنفلت من تحت إبطه، يكفى أن تقول له: ما عنوان الرسالة يا دكتور مجلي، فيتلو عليك سطرين ولا يعلق بذهنك منها شيئاً غير كلمة تأثير مادة مش عارف إيه على مش عارف إيه فى وقت نضوج نبات مش عارف إيه، حسب طريقة مش عارف مين، هذا ما تركه العنوان فى ذهنى ولا أظنه سوف يقدم جديداً للبشرية، لأن مثل هذه العناوين تجعلك تشك فى جدواها.
ومجلى أبو العلا واضح كالشمس لا تستطيع أن تفتح عينيك فى عينيه، صفاء كصفحة السماء الخالية من الغيوم، وانفعالات نهر يتدفق فى هدوء، لكنه يبعث على الضجر، سليقة بكر، لا تخلو من الفجاجة.
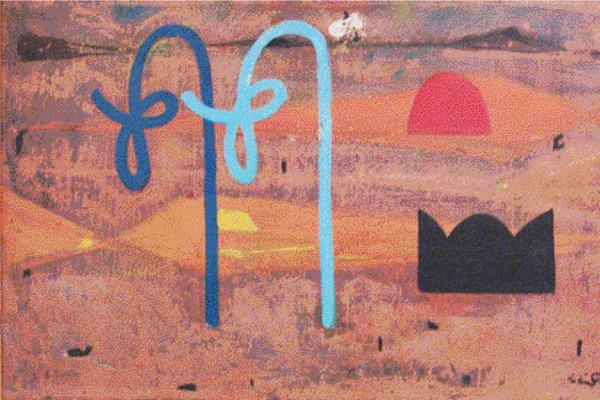
ولكنك لا تستطيع أن تختصم معه، حتى وإن قالها صريحة فى الوجه، نختلف فى الرأى ويبقى على حاله، مجلى المتجلى هكذا كنت أقول له، وكثيراً ما قال لى ولكن الحياة لا تعطى الناس ما يستحقون.
وتزوج من عطيات ابنة عمه، على غير ما أراد، وعمل فى إدارة البحوث الزراعية مساعد باحث، وكان حلمه أن يتدرج فى سلك التدريس، سكن فى بيت أبيه مع أخوته، كل منهم وامرأته فى قاعة، وكان أبو العلا يحلم بفيلا منفرداً.
وفى جميع الأحوال كان يفكر بصوت عال، المصيبة أن يفكر المرء بصوت مسموع، ويطلب من الآخرين أن يكتموا سره!
ولأن الأمر كذلك، كثيراً ما كنت أتبرأ من معرفتى به، إنها حتمية الصدفة التى جمعتنا، كم من البشر نعرفهم فى حياتنا صدفة، يظهرون إلى جوارنا أو نظهر إلى جوارهم فيحسب الآخرون أننا معهم أو أنهم معنا أو أننا نتشابه.
ولقد كان مجلى أبو العلا حريصاً عَلَىّ بقدر أوفر من حرصى عشرات المرات، ولأنه من ذلك النوع الذى لا تجد سبيلاً من الفكاك منه، تحول إلى لزمة فى حياتي، كان يفاجئنى فى طريقى إلى منزلنا فيتلقفنى فى أحضانه معاتباً تقصيرى فى السؤال عنه، وكنت أعتذر له بأعذار شتى.
ويقبل على مضض وهو يقبض على يدي، وعيناه تخترق عيني، أستمع لما كان يقول، وأنا شارد فى مشاغلي، وعندما يفاجئنى بلزمته المعتادة مش كده ولا إيه يا محمود، أقول له كده فعلاً يا مجلي، أتظاهر بالانتباه، وأنا منه براء.
نعم تجاورنا صدفة، جمعتنا قريتنا التى تنام فى أحضان واحة من النخيل، ويقال إن أول من سكنها رجل يدعى عيوط، ويدّعى مجلى أبو العلا أن عيوط هذا هو جده الأعلى، كان يقول لنا ذلك من باب التميز علينا وقت أن كان ذلك مدعاة للتميز.
وكأنه يقول لنا إنكم جميعاً يا أوباش تعيشون فى ضيافة جدي، وكنت لا أبالي، حتى لا يستغرق فى ذلك، صدفة أيضاً كان بيتهم الطينى يقبع تحت كتف منزلنا على الطريق الذى ينتهى إلى الغيطان، ولأن الأمر كذلك، ملأنا طفولتنا لعبا وضحكات.
ركبنا جريد النخيل ودُرنا فى الطرقات المتربة نسابق الريح وهى تتكسر بين سيقاننا الضعيفة، شببنا معاً صبية صغاراً يعفرون الطرقات حيوية.
وكل البسطاء الذين جمعتهم قريتنا تدفقنا فى طرقاتها كما تتدفق المياه فى مجرى النهر الصغير، يجمعنا كُتاب سيدى الشيخ أبو حديد فى الصباح نحفظ القرآن من أعناقنا التى تتمايل بين يدى سيدى الشيخ أبو حديد، وفى المساء نلتقى عند أقدام الجسر، نتبادل الأحاديث والأحلام بحجة الاستذكار.
نجلس على سور الجسر نستقبل نسمات المساء الباردة، وأفواج البهائم وهى عائدة آخر النهار تحت غيمة الغبار، وعندما تختلط أنفاسنا بعبق أريج أشجار الكافور ورائحة الروث نشعر أننا أبناء هذه القرية.
ولأن أحلامنا كانت كأفق الليل ليس لها حدود، كنا نتوشح بدفء الأمنيات نهديها للنجوم المتلألئة فى سماء قريتنا، وعندما يستغرقنا الليل نطلق النكات والضحكات صافية وهى تتصاعد هنا وهناك.
وحتى إذا دخل الليل ندخل فيه، وعند منتصف الليل ننصرف، وكل منا يفرك عينيه، بعد أن نتواعد على اللقاء فى طابور الصباح.. نزحف إليه فى كسل شديد نطلب العلم فى مخلاتنا.
وعندما عبرنا القرية إلى المدينة حملتنا دراجاتنا كل صباح إلى المدرسة التى تقع بين ثلة القرى المتناثرة حول المدينة، نسير متجاورين نداوى وعرة الطريق والسير عكس اتجاه الريح بحديث جديد، وفى المساء يجمعنا الجسر لنكمل الحديث الذى لا ينتهى أبداً.
ولأن الأمر كذلك كان مجلى أبو العلا يحلم أن يكون وزيراً، نعم وزيرًا للاقتصاد.. وأحياناً يزيد ويقول، بل رئيساً للوزراء، هذه رغبة أبي.. كل الوزراء جاءوا من القرى النائية، وقريتنا نائية.
فأكتم ضحكتى وفى خبث فطرى أقول له هيأتُك وزير يا مجلي، هنيئاً لمصر بأمثالك، فينظر إليَّ فى سذاجة طيبة، ويعيد وأعيد حتى كاد أن يصدق كل منا الآخر.. توهم فصدق نفسه وكدت أصدقه، وعندما تمادى فى الحديث.. قال لى الوزير له مستشارون وسوف تكون أحدهم يا محمود، نعم ستكون مستشارى الأول.
عندما بدا وكأنه صدق نفسه، عندها قررت أن أبتعد، نعم أبتعد.. أسلم للمرء أن ينأى بنفسه عندما تشطح الأفكار فلا وكس ولا شطط، وزير ابن أبو العلا الأعور؟
واختلقت معه مشكلة صبيانية عندما نظرت تجاهنا صبية جميلة ذات صباح، فظن أنها تبتسم له، وحاولت أن أقنعه أنها تبتسم لي، فرفض وافترقنا وفى نفس كل منا شيء يحمله للآخر، وعندما تجاوزنا المدرسة للجامعة، ذهب كل منا لحاله، لكنَّ عينيه كانتا معلقتين عليّ، ولكنى لم أستطع أن أنظر تجاهه، وظل يستخبر عني.
وكانت الحياةُ قادرةً على أن تمنحنى رفيقاً جديداً، فعرفت رفقاء كثيرين صدفة ولأن الأمر كذلك انقطعت صلتى به، أو كادت، إلا صدفة، وكلما تشكلت وزارة أتذكر مجلى أبو العلا ولا يتذكره غيري، لكننى أبتسم.
وكنت أتتبع أخباره فى فضول وكأننى أنتظر أن يسطع نجمه ذات يوم، كدت أن أصدقه، حتى التقينا هنا عند رأس الطريق المؤدى إلى الجسر، نظر كل منا للآخر وعندها ألقى بنفسه فى أحضانى وأخذ يجهش بالبكاء، كأنه كان ينتظر قدومى من سنين.
وهو يضمنى فى حميمية، ويهزني، وفى فمه تحشرجت الكلمات، غدت همهمات متداخلة، ظننتها عتاباً، لكنه كان يقول كلاما لم أفهمه، وعندما هدأ وقعد على سور الجسر، أراح رأسه على راحة يده اليمنى، وسند ظهره على سور الجسر الذى أصبح متهالكاً، وقال لي: ما أقسى أن تتبعك الخطوات المجهولة وتتربصك العيون أينما ذهبت، فى الطريق وفى العمل، وفى المسجد، أو عند صديق.. أشعر أن هناك من يراقبنى يا محمود.
ماذا؟ نعم هناك من يشاركنى خطواتى أينما غدوت، فى كل خطوة أخطوها تتبعها خطوة مجهولة كأنها أصفاد تقيد خطواتي، وجوه كثيرة تتبدل وعيون واسعة تبتلعنى كل صباح تغرس أسنانها فى لحمي، وكلما حاولت أن أواجه الرجل المتربص بى لم أجده.
وكان يذوب فى الناس، ثم سرعان ما يظهر من جديد، يلبس قناعا آخر ويعود ليتبعني، وأحيانا أشعر أنه يعيش فى داخلى ... إننى مراقب يا محمود، ورحمة أبوك أنا مراقب ولا أعرف من ولماذا.. يقولها لى فى أسى وعيناه تدمعان ثم يكمل: ظننت أن الأمر مجرد صدفة، لدرجة أننى أقنعت نفسى بأنها لربما تكون صدفة أن تنتظم حياة رجل آخر وفق حياتى اليومية.. يصحو حين أصحو.
يسير فى نفس الطريق الذى أسير فيه.. وعندما أميل بسرعة فى أحد المنحنيات أجده خلفي، وأحيانا يسبقني، وعندما نتحاذى يرمقنى فى ذكاء المنتصر ثم يختفى فى زحمة الناس، وعندما أبحث عنه يظهر ثانية، ويقهقه فى وجهي، وعيناه تقولان لي: لماذا تسير أمامي؟
هذه تهيؤات يا مجلى.
لا ليست تهيؤات يا محمود، سأكمل لك.. وعندما أذهب إلى المسجد يقفز من تحت الأرض رجل آخر يتتبع خطواتى وعندما أهم بدخول المسجد.. يخلع نعليه قبلي.. وأحسه يجلس خلفى مباشرة، وهو يتنحنح، وأشعر أنه يسابقنى فى القراءة فأسابقه فيردنى الصغير والكبير بأعينهم.
وبعد أن أنتهى لأسلم على الحضور، يفر خارجاً من المسجد، وعندما سألت من هذا الرجل أجابنى الجميع.. ربما يكون غريباً سكن مؤخراً فى القرية، ترى هل هو غريب فعلاً يا محمود، أم رجل من إياهم؟
فلم أستطع أن أقول له إلا رجل من إياهم يا مجلي، وزدت محذراً: خلى بالك يا مجلي، أنت شخصية مهمة جداً يا مجلى، قلتها وأنا أنزع يدى من يديه، ولم أنتظر حتى أرى تعابير وجهه ونظراته اللائمة، فقد كنت على عجل من أمري، بينما كان صوته ينادى: اسمع يا محمود.. يا محمود.
اقرأ ايضاً | فهد العتيق يكتب: ظلال غامضة تتبعها
نقلا عن مجلة الادب :
2023-3-11















