لم ينفعنى الاضطجاع فى شيء. بطنى المضطرب واصل تقلصاته وغدا صلبًا مثل وعاء طينى على وشك الكسر. أرسلنى الدكتور إلى المستشفى لليلة واحدة ليعلقوا لى محاليل توقّف التقلصات. كنت أتجهز لأعود إلى البيت فى اليوم التالي، عندما أجبرنى الطبيب المقيم المخول بكتابة الخروج لى على عمل سونار للجنين وبكل فظاظة.
غرقت ساقاى فى بحر من الماء. لقد تمزق الكيس الأمنيوسي وبدلًا من قضاء ليلة واحدة قضيت عشرة أيام جحيمية فى صالة أشارك فيها الأنفاس الساخنة، وأعانى من تجاهل الممرضات واحتقار الأطباء لزميلاتى النساء.
وفى صالة المريضات الحوامل اللاتى يتعرضن للتهديد بالإجهاض. عشرون سريرًا أو أكثر تصطف بمحاذاة الحائط، يفصل بين كل منها كومودينو معدنى فى مساحة مستطيلة بمنتصف البناية، تحت نافذة كبيرة متحركة.
وكثوريين طيبين كما نحب أن نكون، كنا قررنا أنا وسيرخيو أن العيادات الخاصة من أجل البرجوازية. ومستشفى المكسيك الذى اخترناه كان تابعاً للتأمين الصحي. أمرونى بعدم الحركة أبدًا وبجرعة كبيرة من المضاد الحيوى للسيطرة على العدوى. وحقنونى بأدوية لتسريع نمو رئتيّ «المنتَج»، فربما يولد قبل موعده.
كانت إقامتى فى هذا المستشفى قاسية وخبرة أتعلم منها، إذ كنت معتادة على طبيب خاص وغرفة خاصة فى المرات التى اضطررت فيها للاحتجاز فى مستشفى. لقد استأت من معاملتهم للنساء على أننا طفلات سيئات التربية ومتمردات، وأنهم لم يعطونا معلومة ولم يساعدونا بالشكل المناسب.
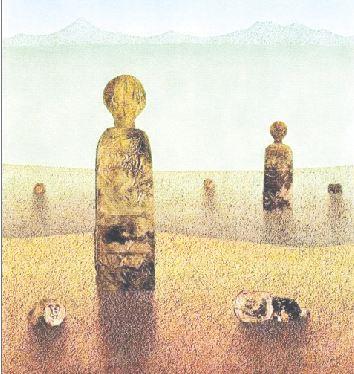
والمرأة الراقدة على السرير المجاور لى اشتكت ذات يوم من أنها لا تشعر بحركة الجنين. فحصها الطبيب وتأكد من غياب نبض الجنين. لقد مات البيبي. بكت المرأة كثيرًا. نقلوها إلى غرفة العمليات ولم نرها مرة أخرى. واستحوذ عليّ وسواس بحركة جنيني.
وكنت أشعر به يثور بداخلى مثل عصفور فى قفص مختوم. حين يهدأ، كنت أوقظه بضربات خفيفة فى البطن، متوسلةً بكل القديسين ألا يكون مصيره مثل مصير ابن جارتى فى السرير، ألا يموت طفلى. قديساى بالذات كانا كاميلو وأرنولدو، صديقاى الميتان. «يا أولاد، من فضلكما، امنحا الحياة لهذا المخلوق. أيًا كان مكانكما، من فضلكما، ساعداني».
وكنت أتحدث لجنيني. طول الوقت كنت أتحدث معه. كنت أحمّسه. كنت أقول له لا تستسلم، عِش من فضلك. وبعد ثمانية أيام طلبوا منى أن أنهض من السرير للفحص فى غرفة أخرى. حالما جلست أغمى عليّ.
ألم تتحركى خلال كل هذه الأيام؟ سألنى الطبيب المناوب عندما أفقت ما يكفي.
بلى، لقد أمرونى بذلك. قالوا ألا أتحرك، وصحت له.
آه يا سيدة، تنهد. هذا ما نقوله لكل النساء فى هذا العنبر حتى يلتزمن الهدوء. ولا أحد يعيرنا انتباهًا بأى شكل.
لو أنكم تمتعتم ببعض الذكاء، سيكون أفضل لكم، قلت له غاضبة.
فى ذاك المساء تناقشت نقاشًا طويلًا مع الطبيب أمام العنبر كله.
اصنع فيّ معروفًا وعاملنى كشخص، قلت له. أنا لست غبية، لقد تعلمت. أعرف جسدي. لا أحتاج إلى أن تبسّط لى كل شيء. تبدو لى إهانة هذه الطريقة التى تعاملون بها النساء هنا.
وانتقل خبر اعتراضى من سرير إلى سرير. وبدأت محادثة بصوت مرتفع بين جميع النساء، لم ينتصر الطبيب ولا الممرضات. قالوا لى معكِ حق.
كان ذلك إهانة. كلهن كن يشكون من معاملتهن كطفلات، سيئات التربية، ولا حتى كانوا يشرحون لهن تطورات حالاتهن، كأنهن غير قادرات على الفهم.
فى ساعة الزيارة المخصصة لنا، كان سيرخيو ينظر إليّ مذهولًا حين حدثته عن عدم كفاءة الطاقم الطبي. لم يكن يصدقني. ظن أنى أبالغ.
وأنها مجرد وساوس برجوازية. أشعرنى أنى أنا المذنبة، الطفلة المدللة. قال إن الأطباء ممتازون. عاملونى بشكل لائق. وإن كان الوضع مقبولًا للنساء الأخريات لماذا لا يكون كذلك بالنسبة إليّ. أحبطنى أن استهان باعتراضي، برغبتى فى معاملة أكثر إنسانية. لم أكن أرغب فى ذلك من أجلي.
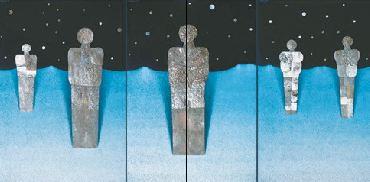
وإنما لكل النساء. لم أتفق معه فى عقيدته –النمطية فى اليسار- بالإيمان بأن الجوهر الثورى مقاسمة الظلم مع الآخرين. الثورة تسعى لوضع حد لسوء المعاملة، لا لدمقرطتها.
لم يتح لى الوقت لأقوم بتمرد كان يراودني. فبعد عشرة أيام هناك، راكمت فيها الرعب والضيق، بدأ المخاض. لم تمنع المضادات الحيوية تقدم العدوى؛ كنت أنتفض من الحمى حين سحبونى على الشزلونج.
ودعتنى النساء. أتذكرهن جيدًا. نساء متألمات ومستسلمات، يرفعن أياديهن ويقولن وداعًا و قضيت الليلة فى عنبر الولادة، مع قابلة مثل الصول، أستمع للتأوهات والصراخ من والدات أخريات، وأدرك أن المستشفى العام لا يتمتع بالبنج. فى السابعة صباحًا جاء الطبيب.
ثمة تعثر فى الولادة، يجب أن نلجأ لعملية قيصرية فورًا، قال و كنت أحترق من الحمى. أشعر بأن حالتى سيئة جدًا. الليلة السابقة بوحدتها وخوفها قضت على كل أسلحتي. جاء الممرضون ونقلونى إلى غرفة العمليات ركضًا فى الممرات.
عندما دخلت رأيت اللمبة النيون، وجه الطبيب فوقي؛ وجه طيار، ناضجًا ومحمصًا من الشمس، بعينين زرقاوين. أغمضت عينيّ فيما كنت أناضل لتلمس ركبتاى جبهتى حتى يعطينى حقنة تخدير فوق الجافية. كنت أعرف الإحساس، شعرت بالإبرة بين فقرات ظهري، الحركات الثلاث: بالداخل بالأعلى وبالأعلى قليلًا. «أحسنت فعلًا»، قلت لطبيب التخدير وأنا أشعر بأنى مخضرمة.
بمحاذاة صدرى أنزلوا ستارة خضراء، فانقسم جسدى إلى نصفين كأنى فى عرض الساحر. هودينى يخفى نصفى السفلي. جالسةً إلى جواري، كانت ممرضة، لطيفة وعذبة على غير العادة، تحدثنى بصوت مطمئن. لم يكن شيء يشغلنى إلا الوصول إلى نهاية الانتظار، أن أموت لو كانت.

وهذه هى نهاية الانتظار. كنت مرهقة جدًا ومحمومة. تأتينى أصوات الأطباء من بعيد. يقولون إن الحقنة سيئة جدًا وممتدة. شعرت حين أخرجوا البيبي؛ بطنى صارت خاوية فجأة، قطعوا الحبل السري. وصمت طويل جدًا امتد.
ما من صوت خرج من البيبي. صمت تام. قال الطبيب «إنه ميت» «على الأقل ننقذ الأم». قال ذلك للآخرين كأنى غير موجودة هناك، بنبرة صوت من يعطى درسًا فى التشريح.
الطفل ميت؟ سألت الممرضة. هل كان ولدًا أم بنتًا؟
آسفة، قالت لى وهى تضغط على يدي. لكنه كان صغيرًا جدًا. لم يستطع أن يعيش.
لكن ماذا كان؟ ولداً أم بنتاً؟ كررت.
كان ولدًا، ونظرت إليّ مشفقة. لكنه كان صغيرًا جدًا. هل لديك أطفال آخرون؟
بنتان، أجبتها.
كم أشعر بالأسف، قالت لى وهى تضغط على يدى مرة أخرى.ففكرت أنه لا يهم، لديّ أطفال؛ وانهمرت الدموع على خديّ وجففتها الممرضة وهى تحدق فيّ بكل أسى. فكرت أنى كنت أتمنى إنجاب ولد، وكان لديّ حدس بأن البيبى ولد.
و فجأة حدث صخب على الجانب الآخر من الستارة. استقامت الممرضة. ثمة صوت كان يردد «الطفل حي، الطفل حي»، فيما خرجت واحدة من المساعدات من غرفة العمليات ركضًا بلفافة بين ذراعيها.
والمرأة الجالسة بجوارى ابتسمت. خيّط الطبيب الجرح وشعرت بيديه داخلى كأنى غدوت دمية من القش. تضرعت أن يعيش ابني.
وفى عنبر العناية المركزة، وبألم مروع لم أشعر به بعد ذلك وأتمنى ألا أشعر به أبدًا، سألت طبيبى الخاص عن الطفل.
ونظر إليّ حائرًا، ألم يقولوا لكِ؟ الطفل لم يعش. بجانبى كانت آنا كيروث، مثل «فلورنس نايتينجيل» فى لحظة الألم تلك، تمرر يدها على رأسي.
لا، لا، قلت من تحت ضروسي، باذلة كل جهدى فى الكلام. هذا ما ظنوه ثم حدث أنه حي.
لا يا جيوكوندا. ليس حيًا. لم يعش، قال لى الدكتور مشفقًا. آسف جدًا.
ألم خيبة الأمل ضاعف آلام جسدي. ولا حتى كنت أريد رؤية سيرخيو عندما نقلونى إلى غرفة عفنة بسريرين. وفى السرير الآخر كانت ترقد امرأة لم يستطع طفلها كذلك أن يعيش. أتذكر أنها حاولت أن تسلينى بصوت عذب ومستسلم. ربما كانت الرابعة مساءً عندما وقفت ممرضة مبتسمة عند الباب وقالت لى بحماس:

ورأيت طفلك فى التو. لو رأيتِ كيف يتحرك.
ولم أكن أستطيع تصديق ما يحدث، كأنه كابوس. حي، ميت. طلبت من الممرضة أن من فضلك لا تقولى لى إن ابنى حي، لا تكونى قاسية. أن كفى. قلت لها «ابنى مات»، وكانت الكلمات تضربنى كسوط.
ولكنى أقول لك إنى رأيته، كررتْ. ابنكِ دى كاسترو بيلي، أليس كذلك؟ هو ضعيف جدًا لكنه حي.
طلبت منها أن تتصل برئيسة الممرضات؛ يجب أن ينتهى هذا الهزل الآن. جاءت رئيسة الممرضات بشريطة سوداء فوق قبعة بيضاء.
ابنك حي، أوضحت لي. هو ضعيف جدًا. لا تبنى آمالًا. الأربع والعشرون ساعة القادمة صعبة جدًا. لكنه يعيش فى هذه اللحظة.
يجب أن تبلغوا زوجي، قلت لها.
هذا خطؤنا، آسفة. سنبلغه.
و ظللت فى الفراش ساكنة ومطمئنة، من دون أن أعرف كيف أتصرف. ومن دون أن أعرف ماذا أقول للمرأة الأخرى، جارتى فى الغرفة. ربما يكون ابنها حيًا كذلك. وساد الصمت. ثم هى بدأت تبكى بصوت خفيض. وأنا أيضًا. بكينا لوقت طويل. كنا نسمع نهنهاتنا.
بعد قليل سمعت صوتها متهدجًا تطلب منى ألا أبكي. قالت إن كان ابنى حيًا، يجب أن أحافظ على قوتي. أغمضت عينيّ. فكرت كم قويات نحن النساء. يا للقوة المروعة والملعونة التى نتمتع بها نحن النساء.
وبعد ثلاثة أيام هاجمتنى الحمى. لا الأطباء ولا الممرضات كانوا يجيبون عن أسئلتي. كانوا يقولون أمر طبيعي. لكنى كنت أشعر بأن حالتى تسوأ يومًا وراء يوم. طلبت من أمي، وكانت جاءت من نيكاراجوا لترافقني، أن تخرجنى من هناك. قلت لها لا يهمنى ما يظنه فيّ سيرخيو.
وسأموت لو بقيت فى هذا المستشفى. كانت إجراءات الخروج طقسًا كاملًا. اضطررت لتوقيع لا أعرف كم ورقة. إخلاء مسؤولياتهم من أى شيء. لم يكن سيرخيو موافقًا. كان يعتذر للأطباء. وينظر إليّ بنظرة عتاب، لكنى لم أعبأ بها. لم أكن أريد البقاء هناك يومًا آخر. كنت أريد طبيبي.
وكنت أعرف أن ثمة شيئًا خاطئًا. خاطئًا جدًا. نقلنى حمواي، بالديثير وثيليستي، وأمى إلى عيادة خاصة. كانت رحلة شاقة فى سيارة بالديثير الاستيشن فاجن، بالمحلول معلقًا بإحدى عليقات السيارة، وبشعور أنى أموت مع كل حركة.

وبدأ طبيبى العمل فى الحال. كان التلوث مروعًا. خطيرًا جدًا بالفعل. واضطروا لإجراء عملية لى من جديد فى الأسبوع التالي. قضيت ما يقرب من شهر فى العيادة، أصارع بين الحياة والموت. وكان سيرخيو لا يزال مستاءً مني. يزورنى قليلًا، ومضطرًا.
مر أكثر من شهر قبل أن أستطيع زيارة قسم الأطفال المبتسرين بالمستشفى والتعرف على ابني. شاهدته عبر الزجاج. رضيع هش، شفاف، بخصلة شعر حمراء وجميلة على رأسه. قالت أمى «إنه حي. لا بد أنه خُلِق لمهام كبرى». كان جميلًا رضيعي. قويًا. وحاسمًا فى أن يبقى حيًا.
وشكرت فى صمت كاميلو وأرنولدو، كنت مقتنعة بمساعدتهما، بطاقتيهما غير المرئية، روحاهما الشابتان اللتان استدعتهما رغبتى كانتا السبب الغامض ليتمسك طفلى بالحياة.
معجزة أنه لا يزال حيًا، قالت لى مسئولة قسم الحضّانات. كلنا نسميه هنا المعجزة. أى اسم سيكون اسمه؟
كاميلو أرنولدو، أجبتها. اسم صديقين أحبهما جدًا.
وعن عودتى مع كارلوس إلى نيويورك فى مهمة حزينة،ونيكاراجوا، نيويورك، 1985-1986
وكنت أعتقد أن قضاء نهاية العام فى البحر سيسعده. فى البحر، هل تفهمني؟ على الشاطئ. متى استطعت أنت، ساكن الشتاء والجليد، أن تنام على رمال 31 ديسمبر لترى النجوم.
كانت الحفلة فى بيت أصدقاء على ضفاف المحيط الهادئ، حفلة بسيطة من الرون مع الكوكا كولا فى كئوس كرتون.
والمدعوون يرتدون ملابس جينزًا وقمصانًا، ويرقصون كومبيا وميرينجى على موسيقى منبعثة من كاسيت ستيريو بأعلى صوت. وفى الثانية عشرة صباحًا، تبادلنا وداع عام 1985 بالقبلات والصيحات والشعارات الوطنية مثل «تعيش نيكاراجوا حرة».
ولكن كارلوس راح ليجلس على رمال الشاطئ ليشاهد البحر بوجه نوستالجى وقال لى إنه يشتاق إلى الثلج، إلى نار المدفأة التى لا بد أبوه وأخوه قد أشعلاها فى البيت الريفى بـ فيرجينيا. حيّرتنى نوستالجيته.
وأنا كنت سعيدة أنه قد بقى فى نيكاراجوا ليقضى معى أعياد الميلاد ورأس السنة. كانت بنتاى فى الإجازة مع أبيهما، الذى راح ليعيش فى جواتيمالا. وكان كاميلو نائمًا فى الطابق الأعلى بالبيت.
فى برد الفجر، قلت لـ كارلوس أن يساعدنى أن أقيم سريرًا على الرمال. لم يكن لدينا أجولة لننام عليها، وإنما ملاءات ومخدات.
وفى النهاية تخلى عن نظرته البعيدة، وعن رغبته فى الانتقال إلى الجانب الآخر. نبشنا الرمال، صنعنا حفرة مربعة صغيرة لنضع الملاءة، سرير بمواجهة البحر الذى يصرخ مثل حيوان مبتهج له شعر أبيض، ينقلب بشعره الهائج فوق سلسلة من الصخور القصيرة.
وعلى الرمال الجافة والرطبة استرحنا على مفرشنا. عانق أحدنا الآخر، وسمعنا الصمت فى بيتنا. على شواطئ المحيط الهادئ فى نيكاراجوا، المنتجعات عبارة عن قرى صغيرة، ومنازل ترفيه بدائية ومساكن صيادين متواضعة. ليس ثمة أضواء مدينة تحجب الليالى المشرقة، معظم الليالي.
وكانت نظرات النجوم ملألأة فوق رؤوسنا. ودرب التبانة يشرق لامعًا مثل وجه امرأة يتجلى بعد سقوط النقاب. والكوكبات: صليب الجنوب، المحراث، حزام الجبار، الماعز السبعة الصغيرة، تظهر خطوطها العريضة كأن طفلًا يلعب لترسيم الأشكال المتلألئة.ومنظر رائع للنوم.
وتحت الملاءات خلق جسدانا ليلته ذاتها ككائنات برمائية ودافئة، بحراه من موجات تروح وتجيء، وتأوهات من المحيط. وحين غدت السماء زرقاء رمادية فى النهاية، نمنا.
و كان فبراير قد بدأ حين اكتشفت أنى حامل. رعب كبير لم أكن أنتظره. منذ مولد كاميلو لم أعد شديدة الحيطة، لكن فى بعض الشهور، بسبب الحرب والفقر وقلة الأدوية، لم أكن أستخدم موانع الحمل وكنت أستسلم للحسابات القديمة حول أيام الخصوبة.
وهذه المرة أخطأت الحسابات. ماذا سنفعل، كيف سنتصرف. كنا نعيش معًا فى ماناجوا، لكن المستقبل كان غامضًا. لا هو ولا أنا كنا نريد ترك بلدينا، لم نتفق أصلًا من منا سيتنازل، كيف نصل إلى حل ملزم.
توقع الطبيب حملًا معقدًا. اقترح كارلوس أن نسافر إلى نيويورك ونسمع لآراء أخرى أكثر علمية. هناك سنتمتع بحلول أخرى أيًا كان قرارنا وانتظرنا التأشيرة التى تأخرت أقل من المتوقع لأننا برهنّا أنها لأسباب صحية. كانت نيويورك فى فبراير متاهة من العواصف الثلجية والتيارات الجليدية. غريب كيف تستعرض التجربة الآمال الزائفة.
ولقد تخيلت مستشفيات طبية شبيهة بمستشفيات نيكاراجوا، أو أفضل. مستشفيات واسعة، مشمسة، بنباتات وسكرتيرات لطيفات. لم أكن مستعدة لمغامرة فى بنايات ذات ممرات لا يمكن وصفها، وأبواب خشنة، وصالات انتظار ذابلة أو عقيمة، حيث سكرتيرات مشغولات حتى عن الابتسام، يطلبن منا ملئ استمارات.
ويسألن عن التأمين الطبى الذى لم أكن فى نظامه. فكرة ضرورة تصفية الحسابات المالية قبل أى شيء –فى نيكاراجوا يحدث فى النهاية، بعد الخروج من الكشف الطبي- بدت لى صفاقة غريبة فى بلد ثري. فى مستشفى بالبارك أفينيو، حيث ذهبنا، افترضت موظفة الاستقبال أن بوسعنا أن ندفع لأن الدكتورة استقبلتنا. شابة ولطيفة.
وقالت من دون لف ولا دوران بعد أن فحصتني، إنها لن تستطيع متابعتى أيًا كان قراري. كانت حالتى تحتاج إلى عناية كبيرة نظرًا للانتهاك الذى تعرض له عنق الرحم من قبل. سواء قررت الاحتفاظ بالجنين أو قررت الإجهاض، كان يجب أن ألجأ لمتخصص فى حالات الخطورة القصوى.
وكانت حالتى حرجة ولا تأمين طبى لديّ، والعلاج سيكون غاليًا جدًا. لو لم يحدث إجهاض تلقائي، سيكون الطفل مبتسرًا. هذا يعنى على الأقل تكلفة يومية سبعمئة دولارًا للحضّانة وحدها وحجز البيبى سيكون لمدة طويلة. كنت أعرف ذلك لأن كاميلو ظل فى الحضّانة لمدة شهرين، باستثناء أنه لم يكلفنى بيزو واحدً.
وخلال أسبوعين تقريبًا، استهلك القلق كل دفئى الاستوائى الذى كنت أحتفظ به. كان برد نيويورك وأيامها الرمادية الاستعارة المحددة لما يجرى بداخلي. عرض عليّ المتخصصون فى المخاطر القصوى بانوراما مرعبة: يتحتم عليّ التزام الفراش طوال فترة الحمل وحجز مستشفى متخصصة فى المبتسرين فورًا.
وقال لى الدكتور إن الأطفال المبتسرين فى الولايات المتحدة يعيشون فى أحوال كثيرة بغض النظر عن الضرر الذى عانوه لولادتهم صغيرى الحجم. المسألة أن جودة حيواتهم يمكن أن تكون طارئة، ولها عواقب مثل الشلل العقلي، أو التخلف العقلى الحاد.
وفى العالم الثالث، نسبة البقاء حيًا أقل، لكن من يعيشون يتمكنون فى العموم من التمتع بحياة طبيعية كما حدث فى تجربة ابني والخطورة التى سأواجهها أنا نفسى كانت أيضًا كبيرة. فى أحسن الأحوال، سيتكرر المشهد الذى عرفته من قبل.
ولا أعرف كم مقهى تجولنا أنا وكارلوس. أتذكر ماديسون أفينيو ومقاهيه اليونانية، المتشابهة فيما بينها، كنا نتناول القهوة فيما نتساءل كيف سنتصرف. أين سيكبر ابننا. كيف سأرتب أمورى إن كنت مضطرة لالتزام الفراش. أين سأعيش. وماذا سأفعل مع إخوته الآخرين. من سيعتنى بهم إن اضطررت لانتظار الولادة فى الولايات المتحدة.
وإن وُلِد البيبى بمشكلات. كنا نريد أن نكون مسئولين، أن نتمتع بحكمة سليمان، لكن قبل أى شيء كنا نريد أن يبعدوا كأس المباركة عن قرارنا، أن نستبعد قرار اللعب مع الرب الذى يمرره لنا الطب الحديث. أثناء ذلك، ثمة رباط بدأ ينمو مع المخلوق الصغير الساكن فى رحمي؛ رباط غامض يشبه الحب الذى أرفضه.
وبحسب اليوم، والساعة، ولطلوع الشمس أو غيابها. فى النهاية كان عبئا عليّ أن أعرف ماذا أريد وكنت الوحيدة التى يجب أن تقرر. كان كارلوس غارقًا فى بحر من الحيرة، من القلق، لكن كان لديه سلوى – كل الرجال لديهم سلواهم- أن جسده لا يتعرض للخطر. جسدى وحده ما سيدفع العواقب. كنت مرعوبة من الألم مرة أخرى.
والخوف من كمية المخاطر التى عدّدها لى الأطباء بدقة – كنت أجهل أنهم يطلعوننى لا لأنهم ساديون، كما فكرت، وإنما ليحموا أنفسهم أمام القانون -. كانت الآراء كلها متشائمة وأنا كنت أمًا لأطفال آخرين، ثلاثة أبناء كان يجب أن أحمى بقائى فى عالم الأحياء من أجلهم. فاتخذت قراري.
وأتذكر الفراغ الذى ملأنى فى رحلة العودة إلى نيكاراجوا؛ كنت مثل البيوت المقوضة من الداخل ولا يتبقى منها إلا واجهة تبدو لا يمكن اختراقها،وبكيت لسنوات طويلة على ما كان يمكن أن يحدث. وتمزق قلبى على بنات جنسي.
كل تلك النساء اللاتى رأيتهن يتمزقن بسبب هذا النوع من قرارات الحياة أو الموت، قرارات نأخذها ونحن فى تدريب كامل على حريتنا، لكنها تخلّف وراءها وللأبد منطقة مقصوفة فى القلب، منطقة كوارث يتجول فيها شبح صغير وهو يضحك ضحكة لم يضحكها من قبل، وينظر إلينا للأبد بحنين إلى الحياة التى سلبناها منه.
وحين هبطت الطائرة فى ماناجوا وانزلقت على أرض المطار، بجبهة مسنودة إلى النافذة وغارقةً فى أفكارى الحزينة، كنت أول من شاهد القناديل، الآلاف من لمبات الكيروسين الصغيرة. مرصوصةً فى صفين غير مرئيين من بعيد، كانت هذه اللمبات القديمة الإضاءة الوحيدة التى تنير لنا هبوطنا.
ولقد هبطت الطائرة فوق مذبح مترع بمصابيح نذرية. بعد نيويورك بأضوائها الكثيرة وطرقها المنبسطة، كان ما أراه لا يُصدق. أنا وكارلوس عجزنا عن تصديق ما نراه. انفجرت فى الضحك وارتجفت مشاعري. كان حلًا بدائيًا شديد الرقة.
ولقد غرق المطار فى السيول الأخيرة. وغرقت أضواء مهبط الطائرات وانصهرت. ما من أموال للترميم، قال لنا ضابط الهجرة،وكيف تتصرفون لو أمطرت؟ سأله كارلوس.
ونغلق المطار. ليس أمامنا حل آخر. إنه الحظر الاقتصادى الذى يفرضه علينا بلدك ما جعلنا فى هذه الحال، شرح له الضابط الشاب بابتسامة بين السخرية والاستسلام.
وفى نيويورك، كان الإسراف فى الإضاءة. هذا التضاد كان مثيرًا للبكاء. حين خرجت إلى الشارع، أدركت لماذا قال كارلوس إن ماناجوا معتمة جدًا. نعم! لكن حر الليل الاستوائى كان سلوى عظامى والظلام كان يبدو لى حميميًا جدًا، راحة. حين استسلم الليل لظلامه بدا كما يجب أن يكون. ما من شيء أراحنى مثل العودة وعن كيف تعمم وضع الحرب فى نيكاراجوا وعن المخاطر الكثيرة التى دخلت حياتى بوصول موديستو.
سان خوسيه، 1978
كان الوضع فى نيكاراجوا، يومًا وراء يوم، يزداد انفجارًا. فى الثانى والعشرين من أغسطس، تسللت فرقة من الساندينيين –من التيار الثالث- إلى قبة البرلمان، أثناء انعقاد مؤتمر الجمهورية، وتحفظت على كل النواب كرهائن حتى أطلق نظام سوموثا سراح مئات المساجين السياسيين المحتجزين منذ ديسمبر 1974.
وهكذا أطلقوا سراح خاكوبو ومارتين. كان أعضاء الفرقة صغار السن. رقم 2 فى العملية، والمكلفة بالتفاوض مع سوموثا، كانت فى الثانية والعشرين. شابة نحيفة وضئيلة الجسد، اضطرت، فيما بعد، وخلال الهجوم النهائي، إلى أن تكون المقاتلة الأشد ضراوة.
وقادت دورا ماريا تييث، طالبة بكلية الطب، القوات التى استولت على أول مدينة محررة فى نيكاراجوا عام 1979. وكانت فرقتها العسكرية تتكوّن من أغلبية نسائية.
وفى التاسع من ديسمبر، بعد قليل من اقتحام البرلمان وفى وسط صمت إضراب عام آخر، انطلقت سلسلة من الانتفاضات المتمردة فى عدة مدن رئيسية بـ «نيكاراجوا». لقد تلاشى الخوف والحيطة فجأة.
وخرج الناس لمواجهة دبابات الديكتاتورية وفرق المشاة، حاملين فى أيديهم قنابل المولوتوف والقنابل المنزلية، المسدسات وبنادق الصيد. ومن لا يقوون على الحرب، كانوا يوزعون القهوة والطعام على الفدائيين فى خنادقهم. لقد أقام الناس حواجز من الحجارة ليحتموا بها فى أحيائهم. وشباب كثيرون.
وبوجوه مقنّعة بحجاب، نصبوا الكمائن للجيش وأصابوهم إصابات بالغة. كانت حربًا شعبية بين أفراد قليلى التسليح فى مواجهة جيش مسلح بكل كرم بأسلحة أمريكية شمالية وإسرائيلية جديدة، بدبابات وطائرات. كان سوموثا وابنه، شاب فى العشرين ونيف يقود قوات الديكتاتورية الخاصة.
ويديران معركة الهجوم المضاد. هكذا أمرا بقصف المدن بقنابل 500 رطل، وقنابل الفوسفور الأبيض والنابالم. ثم حاصروها بالدبابات ونيران المدفعية، حتى سحقوا التمرد بمذبحة وحشية. لكن ولا حتى وحشية الديكتاتورية استطاعت إيقاف ينابيع التمرد المستمرة.
كان سوموثا يواجه الحل البديل بأن يضطر لتدمير البلد إن أراد البقاء فى السلطة. رجال أعمال وأحزاب وشعب، وجدوا أنفسهم فى نفس الخندق. هكذا شكّلت المنظمات الشعبية «حركة الشعب المتحد».
وقد انضم إليها الحركات الأخرى لتشكيل «الجبهة الوطنية». ذاع صيت الهمجية السوموثية على النطاق الدولي. وداخل الولايات المتحدة، ازداد الضغط على حكومة الرئيس كارتر لتتخلى عن مساندة سوموثا، وإيقاف المساعدات العسكرية وإدانة الحكومة النيكاراجوية لانتهاكاتها الكبيرة لحقوق الإنسان.
فى سبتمبر، كنت استعدت صحتي. وبعد شهرين فى الحضّانة، أعطوا لـ «كاميلو» تصريحًا بالخروج. عندما حملناه فى الطريق إلى البيت، كان يزن بالكاد خمسة أرطال، وكان رضيعًا هشًا جدًا وصغيرًا. استقلت من عملى بوكالة غارنيير لأرعاه. أعتقد أنى منذ صغرهم وأنا أنقل لأبنائى شعورًا.
وبالثقة فى قدراتهم الخاصة. بهذه الطريقة يمكن أن أشرح تعايش كل منهم من دون أى تروما كبيرة بسبب ظروف طفولتهم المضطربة. لقد كنت متفائلة بأنهم سيرتاحون فى الحياة وسيتعلمون الاستمتاع بها كل على طريقته؛ كنت أحاول أن أكون صريحة، ألا أستهين بذكائهم.
وأن يتمتعوا بحكمة استيعاب تعقيدات حياتي. واعتقدت بيقين أنهم سيخلقون ثوابتهم الضرورية ليكونوا سعداء ولم أفكر أن سعادتهم ستتوقف عليّ. من دون هذا السلوك ما كان بوسعى أبدًا أن أحكم بأن الأمومة تتوافق مع نوع الحياة التى عشتها. ومثل البنات، كان كاميلو طفلًا هادئًا. لم يتأخر فى التعافى وغدا طفلًا سليمًا وقويًا.
ومن ثم عاد موديستو من كوبا بأخبار سعيدة عن اتفاقات تمهيدية بين التيارات الساندينية الثلاثة. أتذكر الاجتماع فى غرفة صغيرة، ذات سقف منخفض، فى بيت لم أزره من قبل أبدًا. حضر كل من باكو ودورا وأنا وهو. فى هذا اليوم تعرفت على باكو.
وكان رجلًا أكبر منا جميعًا، بعينين زرقاوين، وطيبًا وبسيطًا. تحدث موديستو هامسًا، بشغف يتسلل إلى القلوب ينبثق من حمص الغابات النيكاراجوية. أسرّ لنا بكل التفاصيل، بانطباعاته عن القادة الآخرين.
وما ينتظره من كل منا والمعوقات المحتملة. كان ينظر إليّ كاملةً، وليس إلى عينيّ فحسب. نظراته خيط ماء ينسكب من أعلى إلى أسفل، من شعرى المسدول على كتفيّ إلى انحناءة رقبتي. كأنه يلمسني. كنت أريد أن أركز فيما يقول، لكن جلدى كان يقشعر بإرادتى ذاتها، عابسةً أمام المخاطر التى تنتابني. بدأت أشعر بمغص فى معدتي.
وكأن الدم يحتشد فى خصري، كأن بداخلى تصحو امرأة نائمة تسكن سرًا بين أضلعي. لم يكن بوسعى تسمية شعوري، لكن الكثافة كانت كافية لأعرف أن ما بدأ يسيل بينى وبينه بشكل خفى وسحري، يهددنى بمخاطر كبيرة.
يا إلهي! وأنا ضعيفة كما كنت دائمًا، ما زلت أتماثل للشفاء، ما زلت أحاول استيعاب الفراغ الذى فتحه بداخلى سيرخيو بسلوكه وأنا فى المستشفى، ثم فى العيادة الخاصة حيث راعتنى أمي، وليس هو، فيما كنت أتحمّل متاهات ألم لم أعتقد أنى سأخرج منه أبدًا.
والآن، فى هذه الثغرة المفتوحة من الخزي، كانت تتساقط نظرات موديستو مثل عسل لزج،وعدت إلى بيتى كمن تود الاحتماء من الفيضان بمركب ورقى هش. أغرقت نفسى فى رائحة بودرة التلك، والحفاضات النظيفة، وكراسات الألوان الطفولية. فى هذه الفترة، كنت أعطى ورشة فى الشعر للأطفال فى مدرسة بنتيّ.
وتحت أحد أشجار الفناء الكبيرة، كنا نجلس فى دائرة، ونلعب لعبة القبض على الكلمات، وكتابة قصائد جماعية، لنغدو معها مطرًا وهواءً واستعارة. كانت مريم وميليسا فخورتين بى وسعيدتين بأن أمهما هى المدرّسة، أما أنا فكانت فرصة لى أن اكون بالقرب منهما.
ولقد شعرت يوم الاجتماع بـ «موديستو» بخوف قاتم من أن تذهب سدى كل مجهوداتى فى خلق جو عائلى طبيعى حولي، إن أنا لم أهدئ التيارات الهادرة المهاجرة التى تستيقظ فى قلبي.
وغدا إيقاع العمل موترًا منذ وصوله. كان التمرد فى نيكاراجوا يتزايد مثل أعاصير نراها تولد فوق الماء وتراكِم لوالب من السحب والرياح حتى تتساقط كما المقذوفات الهائلة على الأرض. ولهذا السبب، كانت واجباتنا كمؤخرة للجيش تتزايد يومًا وراء يوم. ثم ظهر فى سان خوسيه فرقة تضم عددًا كبيرًا من الرفاق المفرج عنهم فى أغسطس فى العملية الأخيرة.
وكان باكو واحدًا منهم- وسريعًا ما تضاعفت نواتنا الصغيرة بشكل يكفى لتكوين شبكة سرية أقمناها على عجالة. نسيت صعوبات الأشهر الأولى من انضمامى لتيار الحرب الشعبية الممتدة، إذ شعرت بانسجام تام مع الرفاق الجدد.
ومن البداية وثق بى موديستو بعدد من المسئوليات. كنت أنا وباكو معاونيه الأقرب. وكنتُ الوجه الجماهيري. أدير وأنسّق العمليات السياسية مع حركات التضامن والأحزاب والمنظمات الدولية وشبكات التأييد، وأتحمل مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام. أما باكو ورفاق آخرون، من بينهم ألفريدو ودورا، فكانت مهامهما لوجيستية سرية.
وكنت ألتقى بـ «موديستو» كل يوم تقريبًا لأن ثمة مسائل دائمًا تحتاج إلى قرار، واستشارات واجتماعات يجب أن أنظمها. إحدى أهم المهام التى شغلتنا كمؤخرة للجيش كانت جمع الأموال لشراء السلاح من السوق السوداء.
وبالرغم أن باكو من يدير عمليات تهريب السلاح إلى نيكاراجوا فى حافلات بداخل لفافات مزيفة أو بالتعاون مع سائقى حافلات كانوا ينقلون السلع بأمريكا الوسطى، إلا أن موديستو اعتبرنى الشخص المثالى لنقل الأموال والرسائل والوثائق بين كوستاريكا وهندوراس وبنما.
ولقد كان يفكر أن هيتئى كامرأة من طبقة اجتماعية معينة يبعد عنى شبهات السلطة فى المطارات. وهكذا، بالإضافة لمهامى الأخرى، بدأت فى القيام برحلات متكررة وأنا أحمل أوراقًا وخطابات سرية ووثائق بهويات مزيفة.
كانت هذه المواد تختبئ فى حقيبتي. وفن إخفائها كان يسمى «حشو» وأظن أنها مستلهمة من تقنيات التجار فى تهريب المخدرات. كنت أسافر بألعاب أطفال محشوًا بداخلها شرائط كاسيت صغيرة بتعليمات موجهة إلى المحاربين فى نيكاراجوا، أو رسائل يتبادلها أعضاء متنوعون لنفس القيادة.
وأما الخطابات، المكتوبة بحروف صغيرة والملفوفة فى أنبوب، فكنت أمررها فى سيقان الدمى، أو كنت أفتح العرائس وأضعها بداخلها وأعيد تخييطها. كنا نستخدم أيضًا حقيبة بجيوب مزدوجة، وبداخلها حملت إلى هندوراس جوازات سفر مزيفة استخدمها الرفاق المحكوم عليهم بالسجن ليعودوا إلى نيكاراجوا مجددًا وينضموا إلى المعركة.
أتذكر أنهم ذات مرة أعطونى دمية كبيرة برجلين مليئتين بالحشو. عند وصولى إلى باب الكنترول بالمطار انتبهت إلى أنهم لو مرروها على أشعة إكس سيعتقدون أنى أهرّب مخدرات. ومثل شعاع، عانقت الدمية وعبرت بها من جهاز الحقائب، من دون أى مشكلة.
ولقد غدوت خبيرة فى الابتسام فى المطارات، وفى ارتداء الملابس المناسبة حتى لا أثير الشبهات. كانت هذه التحركات تمنحنى دائمًا شعورًا بأنى بطلة فى أحد أفلام الجاسوسية. كنت أتلقى، على سبيل المثال، تعليمات بأن أصل إلى مطار وأجلس فى صالة انتظار رحلة الطيران.
أشرع فى قراءة مجلة وسريعًا ما يظهر شخص ما يجلس بجوارى وعادة رجل أعرفه، لكنه يعلق هوية عمال المطار البلاستكية فوق قميصه - ويترك عند قدمى حقيبة أحملها معى عند رحيلي. لم يخطر ببالى أبدًا أن أتأمل إن كانت قنبلة أو أن الرفاق سيضحون بي، لأن الساندينيين لم يكونوا أبدًا إرهابيين، ولا كنا مع أن يدفع أشخاص أبرياء ثمنًا لما لم يرتكبوه.
وكانت لحظة المرور بالجمرك أخطر لحظة. ورغم أنى كنت أتظاهر بالهدوء المطلق، إلا أن بداخلى لم تكن ترقص الفراشات، وإنما حشرات تعض معدتى منذ نزولى من الطائرة وحتى خروجى من هناك والحقيبة فى يدي.
ومرة واحدة فحسب وجدت نفسى فى مأزق. جاءنى باكو إلى بيتى بلفافة كبيرة فى ورق كرافت، وضعها على المنضدة وقال لى إنه آسف لكن كل الأموال التى يجب أن أسلمها فى اليوم التالى استلمها أوراقًا صغيرة.
ونظرت فى الحقيبة. كان بها ما لا يقل عن مئة ألف دولار. فكرت أنه مستحيل. أين سأخبئ كل هذا المبلغ؟ كانت الخامسة مساءً، لم يكن معنا حقيبة بجيبين، وطائرة إلى بنما ستطير فى السابعة صباحًا.
وجلست إلى مائدة الطعام المستديرة ببيتى الصغير، الذى انتقلت إليه بعد أن دخل اللصوص بيتى السابق، ولم نكن نشعر بالأمان. نظر إليّ باكو منتظرًا أن أخرج من حالة الاضطراب التى سيطرت عليّ. كان الحزن يكسو وجهي. كان يعرف كما أعرف أنا المخاطر التى سأتعرض لها.
ولاأعرف كيف خطر ليّ الحل. خرجت مع سيرخيو لأشترى فستانًا جديدًا، وصندوقًا جديدًا، وشريطًا طويلًا، وورق هدايا برسومات الزفاف. لففت أوراق العملة فى ورق أبيض صغير، ثم لففت الصندوق بورق الهدايا، وطوقته بشريط فضي.
وفى اليوم التالي، ركبت الطائرة وأنا ارتدى الفستان كأنى سأتوجه من المطار إلى حفل زفاف مباشرةً. كان شعرى مبللًا وممشطًا، بكامل مكياجي، جاهزة للحفلة تمامًا. وقلت لأى أحد كم أنا مسرورة لزفاف أعز صديقاتي. ولم يستغرب أحد من الهدية التى أحملها ولا تفارقني.
وكل ثقتى تقوضت عند وصولى إلى بنما. طلب ضابط الهجرة من النيكاراجويين أن نقف فى طابور منفصل. تلفتُ حولى وفكرت سريعًا ما العمل، وتخيلت المشهد وهم يفتحون الهدية. مصيرى سيكون السجن.
وأراد حسن طالعى أن يسير فى الممر فجأة أحد مستشارى الجنرال تروخيّو، وكنت أعرفه لأنه كان متعاطفًا مع الساندينية. خرجت من الصف مهرولةً ورحت للقائه، وابتسمت له كأنه صديق حميم.
أهلًا! كم أنا سعيدة لرؤيتك! قلت بصياح.
وفيما كان يقترب ليقبّلنى فى خدي، همست له فى عجالة: أحتاج مساعدتك لأخرج من هنا من دون أن أمر بالجمرك، من فضلك. معى أموال، فحدق فيّ مدهوشًا، لكنه استرد نفسه سريعًا لأنه ليس صعبًا عليه استيعاب عن ماذا أتكلم.
كم من الأموال تحملين؟ سألنى أيضًا بصوت خفيض، عشرة آلاف دولار، قلت بثقة،وسحبنى من ذراعي. لا أعرف ماذا قال لضابط الهجرة، لكن الأخير ختم على جواز سفرى من دون كلمة تذمر. ثم مررت كشخصية هامة جدًا من الجمرك، وهو لم يطلق ذراعي.
وحين وصلنا إلى الخارج، شكرته بكل حرارة،- خذى حيطتك المرة القادمة، قال وغمز لى بعين. كنتِ محظوظة لأنى هنا، فلن يغض الجميع البصر، سلّمت الأموال إلى موديستو حين التقينا فى البيت الآمن، حيث يقيم فى ضواحى المدينة. كان مضيفه مهندسًا يعيش وحيدًا. البيت كان رحبًا، لكن هيئته مقبضة، كأن ساكنه عزّل إليه فى التو.
فثمة صناديق فى الغرف، والأثاثات تبدو كأثاثات مكتب. كان موديستو يراقبنى باهتمام وأنا جالسة على كرسى من الجلد، فيما لا أتوقف عن الحديث عن حظى السعيد. كنت مسرورة لأنى معه، ولأنى نفذت مهمتى بنجاح. كنت متحمسة من داخلى كزجاجة ملأى بالفقاعات.
وخلعت حذائى وجلست على الكنبة. وجونلة فستانى الجديد، الواسعة والطويلة حتى الكعبين برسومات لزهور صغيرة، كانت مفروشة حولى مثل مروحة. فجأة نهض من مكانه، ومثل نمر يقفز على فريسة، اقترب ناحيتي، وقبّلنى فى فمي.
ووضعت يدى على صدره، لكنى لم أستطع دفعه لأن هذه اللحظة تأتى متراكمة منذ يوم الاجتماع. هكذا تبادلنا القبل شبه مختنقين برغبة مكبوتة كانت تقتلنا، لكن حين حاول التمادى فوقى وإخلاعى ثيابى والاستمرار فى الهجوم، قبضت على يده.
وضممته إلى صدرى وقلت له لنبق هكذا أفضل، فى هدوء، الأفضل ألا نستمر. حدثنى عما كنت أفعل. كان قلبى ينتفض بقوة وحر جحيمى يحرق وجهي. وظل هو يحسس على رأسى لوقت طويل.
حين كنت مراهقة، كان أبى يسخر من السهولة التى أقع بها فى الغرام.
وطبيعتى الرومانسية، الشرهة جدًا للعثور على «الرجل الكامل»، كانت تُفتَن بسهولة أمام سحر العواطف المفاجئة. ودفعت ثمن ذلك، خاصةً فى مناخ كان الاقتراب من الموت والخطر يجعلنا نرمى القوانين المستقرة من النافذة.
فى رحلاتى تلك – سواء إلى هندوراس أو إلى بنما- كان موديستو دائمًا من يرسل الطرود أو يستقبلها. وكان هو من أبقى معه ليوم أو ليومين، فى بيت أشخاص يتعاونون مع النضال. ورغم أننا كنا ننام فى غرف منفصلة، كنا نقضى وقتًا طويلًا معًا. أعتقد أن أكثر ما جذبنى فيه كان إيمانه بقدراتى ومواهبي.
وفى مقابل سيرخيو الذى كان شديد الانتقاد لي، كان موديستو لا يكف عن مديح حاسة شمى السياسية، وتحملى لمسئولياتي، والاعتراف بموهبتى الإبداعية وتحفيزها. لم يكن باستطاعتى أن أخرج سيرخيو من عالم السياسة، فى المقابل كان موديستو يحدثنى عن غرامه بالأوبرا والأدب والفيزياء والرياضيات.
ويحكى لى عن تاريخه الشخصى حين كان طفلًا ويبيع عجة البطاطس أو الجرائد بشوارع خينوتيبي، قريته مسقط رأسه. هكذا كان يساعد أمه، التى كانت مكوجية، فى مصروفات البيت، إذ كان أبوه صورة غائبة يختفى لشهور طويلة.
يبحر فى العالم فى مراكب تجارية. كان يحكى لى أيضًا حكايات عن سنواته الطويلة فى حرب العصابات؛ عن فترة لم يكن يحمل إلا رصاصتين فى بندقيته؛ عن نمر اصطاده ولا يزال يحتفظ بنابه؛ عن جوع المحاربين التاريخى وحزنهم حين تصلهم خطابات من المدينة تتحسر فيها نساؤهن من الوحدة، أو يعترفن لهم بأنهن أحببن رجلًا آخر. وأنا كنت أستمع إليه مذهولة.
هذا الرجل تسلل إليّ من تحت جلدى مثل مرض، ولم أكن أعرف ماذا أفعل لأهرب منه. وبدأت أرى فى سيرخيو عيوبًا أكثر من مزايا. كأن كل الأعمدة التى قام عليها زواجنا امتلأت بالعث وراحت تنهار شيئًا فشيئًا. حدس سيرخيو بالتهديد، وبشكل ساخر، كما اعتاد أن يفعل كلما خشى فقدان شيء، طوّقنى بنقده ومطالبه. وفى محاولتى لاستعادة نفسي، كنت أبتعد عنه أكثر يومًا وراء يوم.
وعن كيف شاهدت سقوط جدار برلين فى فندق بميامي، وموت أمي
ماناجوا، ميامي، 1989
وكانت الحملة المعدة لانتخابات 1990 فى قمتها فى أكتوبر 1989، لكنهم كانوا قد أقالونى من اللجنة المكلفة بتجهيز خطة الدعاية للجبهة الساندينية الوطنية، إذ كنت قد أبديت اعتراضات من البداية على استراتيجية دانييل أورتيجا المقترحة.
ولأنى غدوت مقصية من الحياة السياسية، كرست وقتى للعمل فى روايتى الثانية، «صوفيا صاحبة التنبؤات»، لكنى شعرت بالاكتئاب. اقترح كارلوس أن نقضى الشهور الأخيرة من العام مع أبيه فى فيرجينيا. ورافقنى لطلب التأشيرة من القنصلية الأمريكية بـ ماناجوا.
وكان أمله أن أحصل عليها لأننا متزوجان. أما أنا فلم يكن لديّ أمل. لقد شرحت لنا المحامية أن الزواج لن يغير وضعى غير المرغوب. كانت السفارة، المطوقة بسياج مضاعف متوج بأسلاك شائكة عرضية، حصنًا حقيقيًا. حين اقتربنا من النافذة الصغيرة، تعاملت الموظفة بلطف حتى رأت كود تأشيرتى السابقة. حينئذ تغير وجهها تمامًا.
لكنها زوجتي، قال لها كارلوس وفى حالتها، هى وحيدة، رفضت المرأة بلغة إنجليزية،وكان يجب أن ننتظر التصريح. «شيء فظيع، بلدك الذى ينادى بالحرية يحدد حريتك أنت»، قلت لكارلوس، «هم يتهمون الساندينيين بالشيوعية، لكنك هنا لم تتعرض لمشكلة، فى المقابل، أنا لا أستطيع السفر إلى الولايات المتحدة لأنى لا أفكر مثلهم».
معكرًا جدًا، سافر كارلوس بمفرده، ومن واشنطن كتب خطابات إلى إدارة الدولة وتحدث مع عدة محامين. فى النهاية، بعد أسابيع، أعطونى إعفاءً آخر، تأشيرة بمدة شهر صالحة لدخول واحد.
وصلنا إلى ميامى فى التاسع من نوفمبر عام 1989. حالما نزلنا فى الفندق، فتح كارلوس التلفزيون. بالنسبة إليه، كانت مشاهدة CNN تمنحه الشعور بأنه عاد إلى الحضارة، إلى بلده. لم يكن قد وصل إلى نيكاراجوا خدمة التلفزيون الكبلي.
وظهر على الشاشة باب براندمبيرغ فيما الحشود تقوّض جدار برلين. تأملت فرِحة صور نشوة الشباب الألمان، ودهشة أهل الشرق والغرب، والعناق بين الغرباء، بين هؤلاء الذى فصلتهم مسافة صغيرة وعاشوا فى عالمين بعيدين بعد أن أُجبِروا على تجاهل ضجيج الجانب الآخر أو صمته. كانت لحظة سامية.
وأنا وكارلوس أصابنا الصمت لنتأمل كيف يقفز التاريخ قفزة سحرية ليحدد بداية حقبة جديدة. تذكرت رعشة من الأسلاك الشائكة عندما عبرت لأول مرة نقطة تفتيش تشارلى القاتمة، كنت حينها فى الرابعة عشرة، وزرت برلين المقسومة مع أمي.
وتذكرت الزيارة الرسمية مع موديستو إلى ألمانيا الشرقية: الفيلم الوثائقى المعروض عند باب براندمبيرغ، والملحمة الحزينة فى تشييد هذا الجدار ليلًا. انقبض صدرى وأنا أتخيل اليأس، وما عناه هذا الخط الفاصل.
وفى ذاك اليوم، بالنسبة إلى من وجدوا أنفسهم معزولين بيد سلطة قاطعة. معزولون عن أبنائهم وزوجاتهم وحبيباتهم. «تراجيديا مؤلمة»، هكذا وصفها أحد موظفى الحزب الذى كان يرافقنا.
وامتلأت عيناى بدموع الراحة عندما شاهدت هدم رمز أليم كان عارًا على البشرية من الجانبين. شردت وأنا أتخيل أثر ذلك على نيكاراجوا، على الانتخابات المنتظرة فى فبراير.
ولا بد أن ريجان سيقتنع الآن أن الساندينيين لن يغزوا الولايات المتحدة، أننا لن ندخل تكساس، كما قد حذر بكل جرأة. لا بد سيدرك عبث وصفه لـ نيكاراجوا كتهديد للأمن القومى الأمريكي. بلدى المسكين. يا الله! بلد ليس فيه إلا خمسة مصاعد لا غير.
وفى تلك الليلة فى ميامي، خرجنا لنتنزه وتناولنا عشاءنا فى كوكونوت غروف، وكانت منطقة موضة. لقد زرت المدينة فى سنوات مضت لكنى لم أتعرف إليها أبدًا. وفى الشارع المضاء بلمبات النيون فى البارات والمحلات، كانت الفترينات تعرض ملابس بألوان متوهجة.
وكان الأولاد والفتيات الشباب والرائقون يتنزهون على الأرصفة ويتحدثون بمزيج من الإنجليزية والإسبانية. وفوق الدراجات النارية اللامعة أزواج بملابس أنيقة ومبتسمين يشقون ضجيج المرور. كان ذلك مزيج من الكاريبى والشوبينج مول وكوبا. ميامى أيضًا مكة البرجوازية النيكاراغوية الساخطة على الثورة.
مدينة معمورة بالمهاجرين من بلدانهم، صالة انتظار حتى تنتهى الثورات. كان كارلوس يخمّن ما المنتج الثقافى لهذا المزيج. كانت ظواهر الهجرة فى الولايات المتحدة أحد الموضوعات التى تثير شغفه. فى المقابل، لم أستطع أن أنفض عنى شعور التيه الناتج عن هذا الجو الضجيجى واللامع.
وفيما كانوا يهدمون الجدار فى برلين بأيديهم، كانت الليلة هنا مثل كل الليالي. لم يتزاحم الناس فى البارات حول شاشات التلفزيون. واصلوا تناول زجاجات البيرة كأن هذا الخبر واحد من الأخبار العادية.
واشتد المرض على أمى فى ديسمبر. انتظرت حتى انتهاء أعياد الميلاد لأعود إلى نيكاراجوا، إذ لم تكن التأشيرة تسمح لى بالعودة لرؤيتها ثم العودة إلى الولايات المتحدة. وأمام مجهودات كارلوس لأقضى الكريسماس بجانبه، لم أرغب أن أغادره.
كانت حالة أمى حساسة وأنا من أتولى رعايتها بشكل عام، إذ أن إخوتى وأخواتى يعيشون خارج البلد. لكن بما أن بعضهم كان حينها فى نيكاراجوا، فكرت أنها لن تحتاج إليّ مثل مرات سابقة.
عدت إلى نيكاراجوا فى 27 من ديسمبر عام 1989. وبعد يومين ودعت أمى الحياة. لم نعرف أبدًا سبب الوفاة بوضوح تام. قال الطبيب إن فقدان الشهية الحاد، الذى عانت منه منذ عدة سنوات، سبّب لها أنيميا حادة. أظن أن خليطًا من أخطاء طبية وضعف جسدي، بالإضافة إلى فقدان الرغبة فى الحياة، ما قضى عليها.
وأعتقد أن الثورة التى منحتنى السعادة منحتها هى عددًا كبيرًا من الخسارات. لقد تبعثرت عائلتها. أخواي، لعدم راحتهما مع الساندينية، سافرا خارج نيكاراجوا، وأختى لابينيا كانت تدرس الدراسات العليا فى الولايات المتحدة، ولوثيا تقيم فى إسبانيا. يومًا وراء يوم، زاد مرضها ولامبالاتها، ودخلت أمى فى اكتئاب عميق. كانت تقضى اليوم محبوسة فى غرفتها.
وبرغم ذلك، ترجمتْ «كوميديا الأخطاء» لـ شكسبير وأعدتها للمسرح. وأخرجتْ عدة أعمال مسرحية، لكنها نادرًا ما كانت تأكل ومع الأيام غدت هزيلة. ظلت تقاوم الاعتراف باكتئابها وأرجعت سبب ضعفها لأمراض أخرى، ما شوّش علينا وأخّر معرفتنا السبب الحقيقي.
وقبل سفرى فى نوفمبر، أقنعتها بأن تقبل حزنها وأن تتخلى عن التطلع إلى قوة هى بالفعل بعيدة عن شعورها. جعلتها تعدنى أن تزور الطبيب ليكتب لها مضادات اكتئاب. وحين كشف عليها الطبيب شخّص الحالة بأنيميا حادة، واضطر لعمل نقل دم. آخر مرة رأيتها فيها، فى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.
وكانت الأدوار كأنها تبدلت. وكطفلة تسعى لكسب رضا أمها، حكت لى عن مجهودها لتأكل أكثر. حضنت يدها وهى نائمة، واستيقظت بعد دقائق قليلة، مرتجفةً. لم تعد أمى تحب الحياة، لكن الموت كان يرعبها. لم تكن تقبله. أرادت أن تكون قوية حتى النهاية. قالت لى «أنا ميتة من البرد». غطيتها.
وفركت قدميها بيديّ لأدفئها. وحين نامت، خرجت أنا من الغرفة. وظل معها لوثيا وإدواردو. رحت إلى المطار لأستلم حقيبة تأخرت فى الوصول. وحين عدت إلى المستشفى، كان أبى يبكي. ماتت ماما. عرفتُ أن جهاز المونيتور الموصل بقلبها أعطى إشارة إنذار.
وحينها أمر الأطباء لوثيا وإدواردو بالخروج من الغرفة. أشعر بحسرة لأنهم لم يسمحوا بوجود أحد منا، أنها واجهت وحيدة هذه اللحظة. كنت أتمنى لو قبضت على يدها، لو رافقتها فى هذا العبور الغامض كما رافقتنى هى فى الطرق الصعبة بكل إخلاص وتضامن معى دائمًا وفوق أى شيء.
وفى السنوات حياتها الأخيرة، كانت علاقتى بأمى حربًا صامتة لكلتينا. وفى سبيل رغبتى فى عدم الانصياع لها، حتى لو كنت سأسير فوق النار، خرجت كثيرًا على قوانينها. هى لم تفهم أبدًا المخاطر التى أواجهها. ربما كانت تحدس أنى أناضل لأقطع للأبد الحبل السرى.
وأن النتيجة النهائية ستكون فقد سلطتها التامة عليّ. لم تفهم أنها لو فقدتنى ستستردني. لم تفهم أن الهشاشة التى ترفضها فى نفسها هى بالتحديد المكان الذى أجد فيه قوتي.
وخضت المعركة الأخيرة مع أمى فى عام 1993. لقد فتح زلزال لوس أنجلوس جراحًا داخلية بزغ منها فى وعيى لا أعرف كم سنة من الخوف المدفون، والصراعات المعلقة، والموت المتراكم. استحوذ عليّ هلع فوق السيطرة أصابنى باضطراب النظم القلبي، كنت خلاله أشعر بالموت.
ودفعتنى الرهبة مع شعور دائم بأن مصيبة أو مرضًا سيدمرنى فجأة للبحث عن مساعدة طبية. هكذا اكتشفت أنى لا زلت أبحث عن نقاط تواصل مع أمي، طرق للاقتراب منها، للتطهير من ذنوبى وأنا أجرب الاستياءات التى أتخيل أنها قد عانتها.
وبعد عملية طويلة أعتقد أنى تمكنت فى النهاية من الانفصال عنها والتصالح مع صورتها. وقبلت من دون شعور بالذنب أن أكون سعيدة، أن أتعايش مع الموت، وأن أكرس حياتى للأدب. وتحملت كل عواقب مثاليتى الرومانسية.
وفي ذات اليوم رحت لزيارة قبرها بصحبة صديقتى صوفيا. ربما فى عام 1995. جلسنا على شاهد القبر وبدأنا فى الحديث حول المشاعر التى تعطى لحياتنا معنى وكنا أقسمنا ألا نتخلى عنها أبدًا. امتد الحوار.
وفى ذلك المساء رمت كل واحدة منا للأخرى تفاحة المعرفة، الخير والشر المتراكم. تخيلت الكلمات وهى تسقط على الأرض من دون صخب، هابطة فى قيظ الظهيرة مثل حمامات زاجلة خفيفة وتتلقاها أمى فى بيتها المعتم. أنا وصوفيا دخنّا وضحكنا. هكذا اقتسمنا معها لحظات التعب والمجد التى تعيشها كل من حُكِم عليه أن يكون امرأة. كان ذلك يشبه زيارة صديقة نائمة وعبر ثقب فى الحلم يمكنها أن تصغى إلينا. كان ذلك تكريمى لها. أمى رمز السكينة.
عن كيف وصلت سنوات حياتى
المضطربة إلى مرفأ
ماناجوا، 1990
وفى 25 فبراير من عام 1990، كانت الثورة الساندينية، الملحمة الشعبية التى أسقطت عائلة من الطغاة، القضية التى شغلت سنوات حياتى الأكثر ألمًا وسعادة وقسوة، قد وصلت إلى نهايتها. أتذكر أنها أمطرت فى اليوم السابق. وقبل هطول الأمطار هبت عاصف ترابية غطت المنظر الطبيعى والبحيرة بطبقة بنية كالقهوة.
«لا أحب هذا المطر»، قلت لـ كارلوس. قبل ذلك بثلاثة أيام انتهت الحملة الانتخابية. وخلال هذه الأيام الثلاثة توقفت أى دعاية مؤيدة. ساد الصمت فى جو ملتهب استمر خلال شهور الحملة، وفيما كنت أتجول بـ ماناجوا.
وللأن جلدى أكثر يقظة منى للتغيرات المناخية، انتفضت من الرعشات. لم أتمتع بنفس الثقة التى تمتع بها رفاقى بأن الناس سيصوتون بقوة للجبهة الساندينية الوطنية. لقد أعربت عن قلقى منذ بداية الحملة، حين اتصلوا بى لأنضم للجنة الدعاية الانتخابية الساندينية.
وقلت إن علينا أن نجهّز أنفسنا لأسوأ سيناريو ممكن، لكن دانييل أورتيغا والآخرين لم يتفقوا معي. «كل شيء سيكون أفضل»، كان هذا الشعار الذى اقترحه دانييل، إبداعه الشخصي. اعترضتُ على اقتراحه. كان رأيى أنه يجب الاعتراف بتعب الناس، واحترام شعورهم بالهزيمة، وموتاهم، وأن نتمتع بالنقد الذاتي. لكنهم أصروا على حملة حماسية، ومبتهجة. بعد قليل أخبرونى بأن الكوماندة أورتيغا يقيلنى من اللجنة لأنى صعبة ومثيرة للمشاكل.
وعندما عدت من الولايات المتحدة فى ديسمبر ورأيت الدعاية فى التلفزيون، همست لنفسى بارتياباتى أمام نقص الإحساس الذى دفعهم لتجهيز حملة صاخبة بموسيقى الروك أند رول. مع الناس الذين مات أبناؤهم فى الحرب، مع الجوع وشح المواد الغذائية الفظيع فى البلد، هم يصنعون دعاية احتفالية أبطالها أولاد وفتيات مبتهجين فى الميادين، كأن الثورة لا تزال حفلة.
وتمنيت ألا يكون إحساسى صائبًا. حاولت تفحص وجوه المارة فى الشارع لأعثر، لا أعرف كيف، على أسباب للأمل، لكنهم منحونى رغبة فى الفرار، فى الاختباء، فى ألا أعيش أيامًا قادمة نحوى بلا توقف.
وكان رفاقي، حتى أكثرهم حصافة وأيقظهم ضميرًا، النقاد فيهم، ينظرون إليّ باستياء عندما أتجرأ وألمّح لامكانية وقوع هزيمة. «توقفى عن الجنون، بالطبع سنفوز». كلهم مؤمنون، حتى اللحظة الأخيرة وبرغم كل شيء. أعتقد أنه كان صعبًا علينا قبول أن رجلًا أو اثنين أو ثلاثة بوسعهم تقويض عملية صنعت بحياة الكثيرين.
وبيقين قلبى كانوا يراهنون على أن الحرب الأهلية وريغان، لن يلويا عنقنا، على أن الشعب سيؤيدنا. من دون حرب، سنرمم الخسائر، سنمحو المذاقات المرة، ونعالج التوجهات السلطوية، سنطالب بديمقراطية داخلية، باتساق.
ولن نسمح بمزيد من الترنح. كانت الانتخابات الأمل فى فتح أفق للتقدم من دون ذرائع. لن يُطلب من الناس مزيد من التضحيات المستحيلة، لن تضطر بنتاى لحضور جنازات أصدقائهما.
بنتاى لهما أصدقاء موتى! وأنا من فكرت أنهما لن يعيشا ذلك، مع ذلك، اضطررت لمرافقتهما فى عدة جنازات.
وكنت أتمنى أن يكون رفاقى على حق. صديقتى صوفيا، بعنادها وإيماءاتها المتحدية، لا يمكن أن تخطئ. لا بد أنى أنا المخطئة،ولكن فى يوم الأحد، يوم الانتخابات، كان الناس يصطفون فى صمت أمام اللجان الانتخابية. لا ضحك، لا مزح، على طبيعتهم كنيكاراغويين. صمت تام. عند عودتى إلى البيت،
وقد عاد صحفيان أجنبيان أو ثلاثة، كانوا فى استضافتنا، بوجوه مغتمة بعد أن أنهوا جولاتهم، إذ كانت نتيجة استطلاعات الرأى التى عملوها فى أماكن التصويت مقلقة. قالوا مطرقين إنه طبقًا لتوقعاتهم، ستفوز بيوليتا تشامورو.
ولا حتى هم كانوا يريدون الخسارة للساندينية. كانوا يشعرون بأنهم مسؤولون عن الشكل الذى يعاقب به بلدهم بلدنا. لم تكن الثورة كاملة، لكنهم تعاطفوا معها.
«كأنهم يصوتون والمسدس على أصداغهم»، أتذكر هذه العبارة التى قالها أحد الصحفيين. إن صوّتوا للجبهة الساندينية، ستستمر الحرب. هذا ما يقوله الناس، إنهم لا يريدون مزيدًا من الحرب.
أظن أنها كانت العاشرة مساءً حينما اتصلت أختى لابينيا.
يا جيوكوندا، خسرت الجبهة. اتصلوا بـ أومبيرتو (أخونا) على بيت السيدة بيوليتا. الرئيس كارتر سيتوجه إلى هناك ليخبرها بأن الجبهة انهزمت وأنها فازت.
تجمدت يداى من البرد، هيا بنا، هيا بنا إلى صوفيا، قلت لـ كارلوس،وكانت صوفيا مونتنيغرو رفيقتى فى اجتماعات النساء والبكاء المشترك، النسوية، الشجاعة، الموهوبة فى البلاغة فلا يوقفها أحد، وقد استقبلتنا بشبشب على باب بيتها. وجلسنا فى الصالة.
الجبهة خسرت، قلت وحكيت لها مكالمة لابينيا.
ليس حقيقة، كررت لي. لماذا تصدقين هذه الشائعات؟ إنها مجرد مناورات لإحباطنا. ليست حقيقية وكان مستحيلًا إقناعها، فعدت مع كارلوس إلى البيت. كانت المدينة، بجوها ومرورها، تبدو لى منفرة.
ولم ننم طوال الليل فى انتظار المعلومات الواردة من اللجنة العليا للانتخابات. كان الراديو يبث من مقر الحملة الساندينية، حيث قد أعدوا احتفالًا كبيرًا بالنصر. كانت الأوركسترا تعزف، لكن بهجة الساعات الأولى انطفأت.
لم نعد نسمع الشعارات المنطلقة من حناجر مئات المتجمعين، ثم جاء خطيب ميليسا ليحكى لنا أنهم فى مقر الحملة الساندينية يبكون. بنتاى كانتا معي. وكانت مريم عضوة فى الشباب السانديني. كلتاهما كبرتا فى الثورة، وطوقتهما حكاياتها.
وشعرتا بأنهما جزء منها منذ نعومة أظافرهما. وتسرب إليهما حبها مثلي. كان خطيب ميليسا يسمى دابيد، ولد مهذب وعذب، كان أول حبيب لها، وأتم حديثًا الخدمة العسكرية. كان كاميلو يقضى عدة أيام فى كوستاريكا برفقة أخيه إدواردو. عرفت فيما بعد أنه، فى الحادية عشرة، قد بكى أيضًا فيما كان أخواله يحتفلون بهزيمة الجبهة الساندينية.
فى السادسة صباحا ألقى دانييل أورتيغا أفضل خطبة قالها فى حياته عندما قبِل الهزيمة الانتخابية. لأول مرة يتعامل كرجل دولة. تحدث بكل صراحة، متألمًا لكنه التزم بالهدوء، ودعا الشعب إلى النظام، إلى تجنب الشغب، وطلب من الساندينيين قبول قرار الشعب النيكاراغوي. سيكون انتصارنا الجديد أن نمنح لنيكاراجوا، لأول مرة فى تاريخها كله، الفرصة لتداول السلطة بين الأحزاب فى سلام، من دون أى حرب.
وفى صالة البيت، حيث نشاهد شروق الصباح وارتفاع الضباب والعصافير، كنا كأن عمودنا الفقرى قد انكسر مثل عمود أكله العث. استحالت ظهورنا محدبة. وفى عيوننا نظرات منطفئة وحزينة ومصعوقة. دوائر عميقة فى وجوه رمادية. لمّا رفعت النظر لأتأمل المدينة البعيدة.
فصدمنى أن أشعر فى خضرة الجبال انبثاقًا كريهًا يرتفع من مسقط رأسي. الشعب يرفضنا. لم أعتقد أبدًا أنى سأعيش هذا اليوم. لقد امتلأ الخراب بداخلى بالموتى، لكنه هذه المرة أشد فظاعة. آسفنى أنهم سيموتون من جديد، وأن موتاهم الآن راحوا سدى، بلا فائدة.
حيوات ضائعة. حيوات كثيرة ضائعة. والآن حيوات أكثر. لقد فقدنا فى حرب الثورة المضادة 50 ألف روح. وفى نهاية المطاف وصلنا إلى هذه النتيجة،ولم يحتفل الناس فى الشارع بانتصار «تحالف الأحزاب» المؤيد لـ بيوليتا تشامورّو. على العكس، فى الأيام التالية ليوم الأحد الانتخابى ساد جو من الحداد فوق أرجاء المدينة. كان يبدو كأسبوع الآلام.
كأن كل سكان المدينة قد رحلوا عنها. لقد خشى الناس أن يرد الساندينيون بموجة عنف. أعتقد أن الشعب بمنحه النصر إلى بيوليتا، كان قد قايض سلطة الشعور البطولي، بالحياة الهادئة، حتى لو كانت الحياة الهادئة آتية من البرجوازية.
ولكنهم لا بد حدسوا أن مصيرهم سيكون الإقصاء مرة أخرى ليكونوا ببساطة «الفقراء»، وليسوا «الحشود الشعبية» التى مجدتها الساندينية فيهم. من أقام احتفالات فى تلك الأيام كانوا أناسًا من طبقتى استعادوا بالفعل امتيازاتهم، بالإضافة إلى المنفيين فى ميامي، كانت احتفالات خاصة، لا علاقة لها بالشوارع والميادين.
ففكرت أن أمى كان يمكن أن يسعدها ذلك، وحزنت لأجلها لأنها ماتت قبل شهر تقريبًا من انتصار صديقتها بيوليتا. صديقة أخرى من صديقات المسرح، غلاديس راميريث، عيّنوها مديرة لمعهد الثقافة. آه يا أمي، كم كانت السعادة ستغمرك، فكرتُ فى ذلك.
وأما أنا، فى المقابل، فكنت أموت من الحزن. كساندينيين، لقد تركتنا الضربة مترنحين. لا أحد أعرفه كان قد عانى من الشكوك التى مزقتني، لكنها، بطريقة ما، خففت صدمتي. لم يستطع أصدقاء، مثل صوفيا، أن يدركوا ما حدث. الحسرة والارتباك أمام مستقبل ظننا ذات مرة أنه سيكون ثوريًا لقرون وقرون.
وأوقعنا جميعًا فى الأسر. مع ذلك، لا أحد من داخل الساندينية اعترض على انتصار بيوليتا تشامورو أو هاجمه بأعمال شغب أو مظاهرات. لم تشهد نيكاراجوا مدنية مثل هذه أبدًا، ففى هذا البلد لم يكن القوى يقبل أبدًا إرادة الضعيف إلا بضرب النار.
وما من نيكاراغوى واحد كان يتمتع بخبرة انتقال السلطة عبر الانتخابات، وكان هذا حقًا أحد انتصارات الساندينية. فبعد أن اتهموا الجبهة الساندينية بالشيوعية والسلطوية والاستبدادية، ها هى تسلم السلطة، رغم أنها مدعومة من الجيش والمنظومة الشعبية و42% من الأصوات الانتخابية، وكان ذلك حدث مفصلى ذو أهمية قصوى من أجل الحياة الديمقراطية للبلد.
ولكنى لم أكن أرغب فى رؤية الثورة التى أثارت مشاعرى وهى تذوب. لذلك، حين اقترح عليّ كارلوس أن نرحل إلى الولايات المتحدة، وأن أنفذ اتفاقى لأنه ظل ستة أعوام فى نيكاراجوا، وافقت.
غريزتى الأساسية كانت تشير إلى الهرب، إلى إغماض عينيّ، حتى لا أرى ما سيحدث فى بلدي.
وكانت بيوليتا صورة أمومية تهدهد وتمنح السلوى، بكلمات بسيطة، لبلد صغير مجروح ومقسوم. عاتبت البعض والبعض الآخر بحكمة أشد تعقيدًا وإدراكًا مما ظنه البعض فيها، وهكذا منحت لنيكاراجوا، على حساب حتى حلفاءها، دفئ بيت يسع الجميع من دون إقصاء لأحد.
وهكذا عاد أعداء قدامى للقاء والجلوس على نفس المائدة، ومشاركة الآلام المشتركة فيما بينهم. كان غريبًا، لكنه باعث للأمل، رؤية شعب محارب وقد صار قادرًا على تبادل الاحترام.
من كتاب سيرة بنفس العنوان
يصدر عن دار المدى
اقرأ أيضًا | بلدي تحت جلدي.. مذكرات الحب والحرب













