كتب : أحمد الشهاوي
يأخذ الصُّوفى بالحقائقِ التى سعى ويسعى إليها، وبالوارداتِ التى تتنزَّلُ عليه، بوصفه من أهل الحقِّ. لا يعادى أحدًا، ولا يبحثُ عن جاهٍ أو منصبٍ أو منزلةٍ وقدْرٍ أو مكانةٍ يتبوَّأها، فالوجاهة تأتيه من حيثُ لا يطلبُ ولا يبتغى. فالصوفى لا يزاحمُ أحدًا فى مكانٍ، قلبهُ مفتوحٌ على الناس والدُّنيا، ولذا كنتُ حريصًا أن أقدِّمَ بعضًا من أهل الحقِّ، الذين رأيتهم سلاطينَ للوجْد، والحُب الصُّوفى الذى هو حياةٌ روحيةٌ للعاشق المُصطفى أو المُختار المُنتقى (استصفى الشَّخصَ: اختاره وفَضَّله، عدَّه صفيًّا وصديقًا، اصطفاهُ).
التصوفُ رحلةٌ يسلكُها الصوفى باحثًا عن الله أو بمعنى آخر ذاهبًا إليه، بُغية الفناءِ فى الحقِّ عبر مقاماته وأحواله التى يخوضُها، ولعلَّ أبرزَها المُشاهدة والشَّوق والقُرب والمحبَّة.
وقد أكونُ تأخرتُ طويلًا فى أن أقدِّمَ حياتى فى ومع الصُّوفية منذ كنتُ صبيًّا فى قريتى كفر المياسرة، التى تنامُ فى حِضْن النيل بالدلتا، شمال مصر، ولكن من سيقرأ ما كتبتُ من شِعْرٍ ونثرٍ سيلحظ أنَّ التصوفَ موجودٌ ومُتحقِّقٌ فى كلِّ جُملةٍ، ومحمُولٌ فى كل نصٍّ، ومع توالى التجارب وتراكمها، أردتُ أن أشيرَ إلى خواص الناس من المتصوفة الذين أحببتُهُم، وعشتُ مع نتاجهم الشِّعْرى والنثرى وسيَرِهم طويلا.
وأثَّروا فىَّ، وأثْرُوا تجربتى الرُّوحية، وغيَّروا نظرتى إلى العالم، وعلاقتى بنفسى وبالآخر القريب أو الغريب، واستمسكتُ أكثرَ بالزهد (ازْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِى أَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوكَ) «حديث»، وصرتُ مُستغنيًا وحفظتُ قلبى عن «طَوَارِق الغفلة»، وطرحتُ متعَ الحياةِ بعيدًا، وأصبحت القراءةُ والكتابةُ ومعهما السَّفر والترحال هى ما أريدُ وأبتغى وأملكُ، ولا أدرى هل وصلتُ إلى مأمُولى أو إلى مطلوبى أم لا؟ لكنَّنى أسعى وأمنِّى الرُّوحَ بالوصُول.
وهذا لا يعنِى أنَّنى هربتُ من الدُّنيا، أنا فقط طرحتُ هوامشَها جانبًا، وصرتُ لا أنتبهُ إلَّا إلى اللبِّ أو المتْنِ، لأنه متى كان للهامش مكانٌ أو ذِكْرٌ فى اللوح، أو التاريخ، الخلاصُ لى – كما للمتصوفة – فى الإشراق (انبعاث نور من العالم غير المحسُوس إلى الذهن، تتم به الْمَعْرِفَةَ التى هى فَيْضٌ مِنَ اللَّهِ بالحِسِّ أو العَقْلِ) والتجلِّى (مَا يَنْكَشِفُ فِى قَلْبِ الصُّوفِى مِنْ أَسْرَارِ الغُيُوبِ، إِشْرَاقُ ذَاتِ اللهِ وَصِفَاتِهِ)، وهما عندى صنْوان أو نظِيرَان للكتابة.

المتصوف مشغولٌ بأحواله (ما يرد على القلب بمحض الموهبة من غير تعمُّلٍ كحزن، أو خوف، أو بسط، أو قبض، أو شوق، أو ذوق يزول بظهور صفات النفس) كما يذكر عماد الدين الواسطى (657 - 711 هـجرية = 1259 - 1311 ميلادية): «ما قام بالقلوب من المواهب الإلهية والجذبات القدسية فيُقال حال الخوف، حال الشَّوق، حال الرجاء.. وأمثال ذلك، ويسمى فى عُرف أهل الزمان خوارق العادات حالاَ أيضًا» كما يذكر عبد الرزاق القاشانى (توفى نحو 730 هـجرية/ نحو 1330 ميلادية)، ومُجاهداته (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)، مُنكِرٌ لذاته.
والمتصوفُ مُتجرِّدٌ من المادَّة والظُّلمة، من الشواغلِ الدنيا، من المنافعِ والمصالحِ والملذَّات، ترك الزُّخرفَ وطرحه بعيدًا عنه، نزيهٌ مترفِّعٌ، وغير مُتحيِّز إلا إلى ما يؤمنُ به ويعتقدُه
ومن ثم لا يتشدَّدُ أو يتطرَّف، ولو أننا لم نهمل التصوف لعقُودٍ مضت، ونغلق الطريقَ أمام ممارسات الذِّكْر فى الموالد، ونضيِّق الخناقَ على نشر الكتب الصوفية انتصارًا أو ممالأةً أو رياءً أو نفاقًا لمذهبٍ من المذاهب لا يعرفه المسلمون، وتعرفه دولةٌ واحدةٌ، وكذا إجراء الدراسات العلمية «الماجستير والدكتوراه» فى الجامعات، لما وجدنا بيننا أحدًا من أهل المحو والإقصاء والإلغاء من المتشدِّدين الذين صاروا يعدُّون الأنفاسَ على البَشر، ويحرِّمُون التصوف، ويكفِّرون المتصوفةَ، ويحاربون أهله.
ويقتلون رموزَه فى المساجد أو فى الطرقات، ويهدمُون مقامات وقبور الأولياء، والأمثلة أكثر من أن تُحْصى أو تُحْصر، وأنا لا أذيع سرًّا عندما أقولُ إنَّ الغربَ يدعمُ التشدُّدَ ويُخصِّص ميزانياتٍ ماليةً ضخمةً، كى يثبِّتَ فى أذهان العالم أن الإسلامَ دينُ قتلٍ وتشدُّدٍ، بينما نادرًا ما نجدُ هيئةً أو جامعةً أو مؤسسةً غربيةً تدعمُ التصوفَ، فى حين أنَّ حكوماتٍ ودولًا هى من صنعت طالبان، وبوكو حرام، وداعش، والإخوان المسلمين، والتوحيد والجهاد، والقاعدة، وجبهة النصرة، وأنصار الله، والأسماء كثيرة، وكلها من صُنْع الغرب، وهو من أسَّسها وموَّلها ومازال يمدُّ اليدَ المالية والمسلَّحة لها.
المتصوفةُ زُهَّاد ومتقشِّفُون، لكنَّهُم لم يكتبوا الرهبانيةَ عليهم، يخشوْنَ الله، ويحفظونَ الحدودَ أسوةً بالنبى محمد (ص). وحياتهم رحبةٌ، ولا يظنُّ أحدٌ ما أنها ضيقة أو محدُودة، لأنَّ التصوفَ يسهمُ ويوسِّع ويمنحُ الإنسان آفاقًا أخرى يمكن أن نسمِّيَها فتوحاتٍ (الْكَائِنُ فِى الْكَوْنِ وَلَمْ تُفْتَحْ لَهُ مَيَادِينُ الْغُيُوبِ مَسْجُونٌ بِمُحِيطَاتِهِ وَمَحْصُورٌ فِى هَيْكَلِ ذَاتِهِ. أَنْتَ مَعَ الأَكْوَانِ مَا لَمْ تَشْهَدْ الْمُكَوِّنَ، فَإِذَا شَهِدْتَهُ كَانَتِ الأَكْوَانُ مَعَكَ – ابن عطاء الله السكندرى (658 هـجرية/ 1260 ميلادية - 709 هـجرية / 1309 ميلادية)، «الحكم العطائية»، وتجلياتٍ (ما ينكشفُ للقلوبِ من أنوارِ الغيوب) تملأ قلبَ صاحبها بالنُّور، حيثُ تنفتحُ عينُ بصيرته، وتنامُ عينُ بصرِه، ويصيرُ من أهل المعرفةِ التى هى «إلى السُّكوت أقرب منها إلى الكلام».
فالصُّوفى المُتأمِّل يحلُّ عرشُ الله فى قلبه، إذْ ملكَهُ الحُبُّ، وصار إنسانًا كاملًا «إنَّ النَّفسَ النَّاطِقَة، كمالُها الخاصُّ بها أنْ تصير عالَما عقليَّا، مُرْتَسِمًا فيها صورة الكلِّ، والنظام المعقول فى الكلِّ، والخير الفائِض فى الكُلِّ.. فتَنقلِب عالَماً معقولاً، مُوازياً للوجود كلِّه، مشاهِداً لما هو الحُسْن المُطلق، والخير المطلق، والجمال الحق، ومتَّحِدا به، ومُنْتَقِشًا بمثاله وهيئته، ومُنْخَرِطا فى سِلكه، وصائِرا من جوهره (ابن سينا، كتاب الشِّفاء).
بلغ حدَّ الكمال الرُّوحى «أهل الكمال الذين تحقَّقُوا بالمقامات والأحوال، وجاوزوها إلى المقام الذى فوق الجمال والجلال، فلا صفة لهم ولا نعت» (ابن عربى، الفتوحات المكية، طبعة 1911ميلادية)، كما رأيتُ مع ذى النون المصرى (179 هجرية - 796 ميلادية/ 245 هـجرية -859 ميلادية» صاحب القدم الأولى على سطحِ قمرِ الصوفيةِ، لِمَا اتسم به من فلسفةٍ ومعرفةٍ وتجربةٍ مع الكيمياء وعلم الباطن، وما تركهُ الأوائلُ من المصريين القدماء، حيث عاش حياته باحثًا عن اسم الله الأعظم، واتهم بالزندقةِ والهرطقةِ والكُفر.
والمتصوفُ مُتجرِّدٌ من المادَّة والظُّلمة، من الشواغلِ الدنيا، من المنافعِ والمصالحِ والملذَّات، ترك الزُّخرفَ وطرحه بعيدًا عنه، نزيهٌ مترفِّعٌ، وغير مُتحيِّز إلا إلى ما يؤمنُ به ويعتقدُ، متحرِّر من الأَهْوَاءِ، لا يخضعُ للميولِ والعواطفِ أو لأى تأثيرٍ، مَوْضُوعِى فِى أَحْكَامِهِ، يَنْظُرُ إِلَى الأَشْياءِ نَظْرَةً مَوْضُوعِيَّةً دُونَ اعْتِبَارٍ لِنَزَعَاتِهِ، لا حجابَ أمامه، كشفَ ظنونَهُ، ولم يعُد سجينَ جسمه، سرُّهُ فى سراجه الوهَّاج، صفَّت النارُ معدِنه وشطَفتْهُ، فصار نقيًّا، بعدما ثارَ على المُتع، وفطمَ نفسه عمَّا غرَفَ وألِفَ، فإبراهيم بن أدهم مثلا كان أميرًا لبلخ (مدينة صغيرة فى ولاية بلخ، أفغانستان، تبعد عن عاصمة الولاية مزار شريف بنحو عشرين كيلومترًا، وتقع شمال غربها، ومن الجنُوب تبعدُ عن نهر آمودريا (جيحون) بنحو أربعة وسبعين كيلومترًا، ومنه يتدفَّقُ عبر المدينةِ أحد الروافد.

ويُطلقُ عليها قبَّةُ الإسلام، جنَّةُ الأرض، أمُّ البلاد، خيرُ التراب، ويقع فيها تل حمران الذى يعتقدُ الأفغانيون بأنَّ (على بن أبى طالب قد دُفن سرًّا فيه)، وتخلَّى إبراهيم بن أدهم (توفى 161 هـجرية /778 ميلادية) عن عرشهِ، وصار درويشًا جوَّالا، وقد «أعرَضَ عن ثروة أبيه الواسعة، وعمَّا كان يصيبُه من غنائم الحرب وآثر العيشَ من كسب يده»، وهو القائل: «قلة الحرصِ والطَّمع تورِّث الصدقَ والورعَ، وكثرة الحرصِ والطَّمع تكثرُ الهمَّ والجزع».
وقال: «اعلم أنَّك لا تنالُ درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات: أولاها: تغلقُ بابَ النعمة، وتفتح باب الشدَّة. والثانية: تغلق باب العزِّ، وتفتح باب الذلِّ. والثالثة: تغلقُ بابَ الراحة، وتفتحُ باب الجهد. والرابعة: تغلق باب النوم، وتفتح باب السَّهر. والخامسة: تغلق باب الغنى، وتفتح بابَ الفقر. والسادسة: تغلقُ بابَ الأمل، وتفتحُ بابَ الاستعداد للموت».
وسئل إبراهيم بن أدهم لِمَ لا تخالطُ الناس؟ فقال: «إنْ صحبتُ من هو دونى آذانى بجهلهِ، وإنْ صحبتُ من هو فوقى تكبَّر على، وإن صحبتُ من هو مثلى حسدَنى، فاشتغلتُ بمن ليس فى صحبته مللٌ ولا وصلة انقطاع ولا فى الأنس به وحشة».
والأمر نفسه مع أبى بكر الشبلى (247 هـجرية/ 861 ميلادية - 334 هـجرية/ 946 ميلادية) الذى تركَ الجاهَ والسُّلطانَ بعدما كان حاجبًا وحاكمًا وأميرًا لبعض الأقاليم، حيثُ عُيِّن أميرًا على (دوماند) من توابع طبرستان، وسارَ فى الطَّريق الصُّوفى، يعبِّر عمَّا تحسُّه نفسه، يراقبُ أحوالَهُ وقلبَهُ، لا يملكُ شيئًا، ولا يملكُهُ شيءٌ، بعدما خرج من كُلِّ ما هو أدنى، وقد سُئِل الجُنيْد (215 - 298 هـجرية / 830 – 910 ميلادية) يومًا عن الزُّهد فقال: «تخَلِّى الأيدى من الأملاك، وتخَلِّى القلوبِ من الطَّمع»، وذلك هو المثَل الأجلَى عن عُزُوف النفسِ عن الدنيا.
وكذا أبو على شقيق بن إبراهيم بن على البلخى وكان من أثرياءِ قومه، ويُقال إنه كان له ثلاثمائة قرية، ثم تزَّهدَ، ومات فقيرًا لا يجدُ كفنَهُ، ومات سنة 153 هجرية.
التصوفُ رحلةٌ يسلكُها الصوفى باحثًا عن الله أو بمعنى آخر ذاهبًا إليه، بُغية الفناءِ فى الحقِّ عبر مقاماته وأحواله التى يخوضُها، ولعلَّ أبرزَها المُشاهدة والشَّوق والقُرب والمحبَّة، والمتصوفُ يذهبُ نحو النُّور، غيرُ مرتجٍ من أحدٍ طلباً، أو مُبتغٍ مصلحةً، يذكر الله باللسان، وبالقلب، ولا يشغلهُ أحدٌ عن سواه «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ» [آل عمران:191].

والنبى محمد يقول فى الحديث: «الإحسانُ أن تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تراه، فإن لم تكُن تراه فإنه يَراك».
يقول أبو محمد الجريرى وهو من أهل القرن الرابع الهجرى، ومن كبار أصحاب الجنيد (توفى 311 هجرية): «كان بين أصحابنا رجلٌ يكثرُ أن يقولَ: الله، الله، فوقعَ يومًا على رأسه جذعٌ، فشجَّ رأسه، وسال الدمُ - سقط - فاكتتب على الأرض: الله، الله».
تعلو الحاسَّةُ الرُّوحيةُ للصُّوفى على من سواه، لأنه يبصرُ بعينِ البصيرةِ «قوة الإدراك والفطنة، العلم والخِبْرة، ونظر نافِذ إلى خفايا الأشياء»، لا بعينِ البصَرِ، وهى المُسمَّاة رؤية القلب، ولذا تزدادُ لديهم قوة الفِرَاسَةُ: المهارة فى تعرُّف بواطن الأمور من ظواهرها وفى الحديث: حديث شريف «اتَّقوا فِراسةَ المؤمن فإنَّه ينظر بنور الله»، والفِرَاسَةُ هى أيضًا الرأى المبنى على التَّفَرُّس، الناتجة عن التبصُّر والتأمُّل والمعرفة ونور اليقين وكشف الحُجب، لأنَّ الحجاب ذلٌّ وعذابٌ. وتعلُو درجة الإلهام، ومن ثم يقعُ التجلِّى، مصداقًا لقوله تعالى (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى [الحجر:29])، كما أنَّ اللهَ خصَّ أهل الوقت بالبصائر والأنوار والمعارف.
المتصوفُ يعيشُ حياته مُستَغْرقًا فى الحُبِّ، فهو مأسورٌ ومجذوبٌ دائمًا، وليس لديه وقتٌ ينفقُه فى غير النشوة والسُّكْر، وعيناه مفتوحتان أبدًا، ولا تغيبان عن المحبُوب الأسمَى بُرهةً، لأنه يعيشُ حياة الإشراق، بالنورِ الربَّانى، الذى يجعلهُ فى مقام الفناء، بحيث إنه لو ضُرب وجهُه بالسَّيف لا يحسُّ.
يقول معروف الكرخى (توفى فى بغداد سنة 200 هـجرية/ 815 ميلادية): «إذا انفتحت عين بصيرة العارف، نامت عين بصره، فلا يرى إلا الله»، ويقول الحلَّاج (858 – 922 ميلادية/ 244 -309 هـجرية): «من أسكرته أنوار التوحيد، حجبته عن عبارة التجريد، بل من أسكرته أنوار التجريد، نطق عن حقائق التوحيد، لأن السكران هو الذى ينطق بكل مكتومٍ»، والفناء كما يذكر عبد القاهر الجُرْجَانِى (400 – 471 هـجرية/ 1009- 1078 ميلادية): «فناءان، أحدهما ذوقى، والآخر خلقى، فالذوقى هو عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت، بالاستغراق فى عظمة البارى ومشاهدة الحق. والخلقى هو سقوط أوصافه المذمومة، واستبدالها بالأوصاف المحمودة».
ويقول الهجويرى (1009 - 1072 ميلادية): «هو درجة كمالٍ يبلغها العارفون، الذين انتهى بهم الطلب إلى الكشف، فرأوا كلَّ مرئى، وسمعوا كلَّ مسموعٍ، وأدركوا كلَّ أسرار القلب، وأعرضوا عن كلِّ شىءٍ، وفنوا فى مقصدهم، وفنيت فى هذا المقصد كلُّ مقاصدهم».
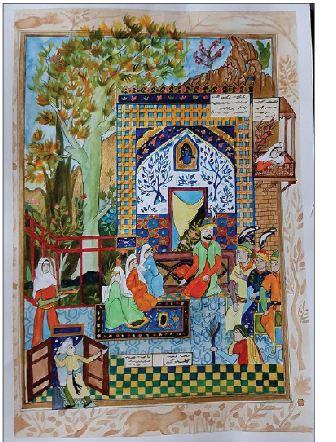
يقول ابن سبعين (614 - 669 هـجرية / 1217 – 1269 ميلادية): «إن الفلاسفة الأقدمين رأوا أنَّ الغاية المُثلى هى التشبُّه بالله، بينما الصوفية يدأبون على الفناء فى الله، وذلك بأن يكون الصوفى قابلًا لأن يدع السنن الإلهية تغمره وتفيض عليه، وأن يمحو انفعالات الحواس، ويظهر مشاعر الروح».
وكان أبو الخير الأقطع التيناتى (مات سنة نيف وأربعين وثلاثمئة) وهو من أعلام التصوف فى القرن الرابع الهجرى، قال عنه أبو عبد الرحمن السلمى بأن: «له آيَات وكرامات، وَكَانَ أوحد فِى طَرِيقَته فِى التَّوَكُّل وكان ينسج الخوص بإحدى يديه لا يدرى كيف ينسجه»، وهو مغربى الأصل حاد الفِراسة، كان يأنسُ إليه السباعُ والهوامُ، مُصابًا بغنغرين فى قدمهِ فرأى الأطباء ألَّا مناصَ من قطعها، ولكنه أبى أن يكون ذلك، فقال مريدُوه: «بل اقطعوها وهو يصلِّى، فإنه لا يشعرُ حينئذٍ»، فعمل الأطباء بنصيحتهم، فلما أتمَّ أبو الخير صلاتَهُ، وجد أنَّ الأمرَ قد انقضى.
إذن، فالمتصوف مُنح الإدراكُ الروحى بتأمُّله الأسرار، وبقلبه الذى يزنُ الأشياءَ ويراها فى مرآته صورةً على غير مثالٍ: (وَتَحْسَبُ أنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ/ وفيك إنطَوَى العالمُ الأكبرَ).
شِهابُ الدين السُّهروردى.. شهيد الإشراق الذى قتله صلاح الدين الأيوبى
هل الله قادرٌ على خلق نبى آخر بعد مُحمَّد؟
لو أجبتَ بلا فقد كفرتَ.
ولو قلتَ نعم، فسيقولُ لك الفقهاء وعلماء الظَّاهر: إنَّ محمد هو خاتم الأنبياء.
ولو التزمتَ الصمتَ فأنت لستَ شيخًا، ولا صاحب علمٍ
لكنَّ السُّهروردى الذى آمن بأنَّ «المحبَّة من لوازم المعرفة» أجاب عن أسئلة الفُقهاء الذين كانوا يناظرونه فى مسجد حلب: إنَّ الله «لا حدَّ لقدرته»، وفهموا من إجابته أنه يجيزُ خلقَ نبى بعد محمَّد، مع أنه لم يقُل بذلك، فكتب الفقهاء محضرًا بمُروقه وكُفره، وأُرسل أولاً إلى الملك الظاهر ابن صلاح الدين الأيوبى، فرفضه غير مقتنعٍ بما جاء فيه، ودافع عن السُّهروردى، لكنهم لم يسكتوا فأرسلوا المحضر إلى أبيه إلى صلاح الدين الأيوبى فى القاهرة، فأصدر أمرًا إلى ابنه الملك الظاهر فى حلب بقتله، وكان كثير التعلُّق بالصوفية على العكس من أبيه، الذى خضع لفتوى الفقهاء - الذين أثار حفيظتهم قرب السُّهروردى من ابن صلاح، فصاحبَهُ وقرَّبَهُ من نفسه ودعاه إلى ترك أصفهان والإقامة فى حلب، التى كانت بداية النهاية لحياته القصيرة - من دون أن يرى أو يعلم شيئًا، ويعدُّ أمر الإعدام هذا من النقاط السوداء التى لا تغتفر فى رحلة حُكمِه، وكانت حلب وقتذاك التى انتقل إليها السُّهروردى محجّ الفلاسفة وقِبلة الباحثين عن العلوم العقلية وعلم الكلام.
هذا صوفى قتلته الشَّائعاتُ - وهو فى السادسة والثلاثين من عُمره – التى أطلقها حُسَّادُه ومعادُوه من وعَّاظ وفُقهاء زمانه، الذين وشوا به، وأوقعوه فى شِراكهم الخبيثة، لأنَّ سُطوعَ نجمه هدَّد مصالحهم الدنيوية، وهزَّ أشجارَ مكانتهم التى جذُورها واهنة، بعدما ناظرهم وأفحمهم بنوره، فحقدُوا عليه، ودبَّروا له المكائد، وثأروا لهزيمتهم أمامه بالتخلُّص منه قتلاً.
وكانت التهمة جاهزةً مُمثَّلةً فى: تعطيل الشَّرائع، والمرُوق عن العقائد الصحيحة للسَّلف، والاتهام بالزندقة، وإفساد الدين، وانحلال وتذبذُب العقيدة، وتلك تهمٌ ما زال يطلقها الفقهاءُ ومشايخ السلطان فى كل زمان ومكان من بلداننا العربية والإسلامية، دون وجلٍ، أو خَشية من الله.
وقد ألَّبُوا عليه السلطان صلاح الدين الأيوبى (532 - 589 هـجرية/ 1138 - 1193 ميلادية)، وكان بطبيعته يكرهُ التصوف وأقطابه، مثلما كان يكرهُ الفلاسفة وكتبهم، ويبغضُ أربابَ المنطق، وأهلَ الوقت فى زمانه، وصار عدوًّا لهم، مع أنَّ الإنسان فيلسوف بالطبع، ولم أصادف على هذه الأرض إنسانًا لا يتفلسفُ، أو يتأمَّلُ فى نفسه وفى الملكوت، مادام له عقلٌ وقلبٌ، فأمر بقتله جوعًا فى قلعة حلب.

وأرسل صلاح الدين الأيوبى إلى ولده الملك الظاهر والى حلب كتابًا بخط مستشاره ووزيره القاضى الفاضل (526 – 596 هـجرية) لبلاغته وفصاحته، وعلى الرغم من حبِّى له، فلا أغفرُ له سقطته هذه التى تتنافى مع مقولته الشهيرة الخالدة: «إنِّى رأيتُ أنَّه لا يكتُبُ إنسانٌ كتابًا فى يومِه، إلاَّ قالَ فى غَدِهِ: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسنَ، ولو زِيدَ كذا لكان يُستَحسَنُ، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضلَ، ولو تُرِكَ هذا لكان أجملَ. هذا مِنْ أعظَمِ العِبَرِ، وهو دليلٌ علَى استيلاءِ النَّقصِ علَى جُملةِ البَشَر»، وقال فيه صلاح الدين الأيوبى: (لا تظنوا أننى فتحتُ البلادَ بالعساكر، إنما فتحتها بقلم القاضى الفاضل)، وفى روايةٍ أخرى: «لا تظنّوا أنى ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضى الفاضل».
وقد جاء فى الكتاب الذى كتبه، ووصل إلى ابن صلاح الدين، وكان صديقًا للسُّهروردى، حيثُ قرَّبه منه، وكان معجبًا بأفكاره كفيلسوف للإشراق: «إن هذا الشاب السُّهروردى لا بد من قتله، ولا سبيل أنه يُطلَقُ، ولا يبقى بوجهٍ من الوجُوه»، حيث طلب منه اختيار طريقة مقتله، فاختار الهلاك جوعًا وعطشًا، وأحرق كتبه سنة (588 هجرية - 1193 ميلادية)، ولهذا سمِّى بـ«المقتول»، تمييزًا له عن آخرين يحملون الاسمَ نفسه، كما أنَّ الفقهاء المُتشدِّدين قد استكثروا عليه لقب «الشهيد»، وكى يثبتوا أنه مات كافرًا مُدانًا من قِبَل المؤسَّسة الدينية الرسمية، الجالسة فى حِجْر السُّلطة والسُّلطان.
لكنَّ أنصارُهُ لقبُّوه بـ« الشهيد»، شهيد الفكر والعقيدة الإشراقية، وبـ«شهاب المِلَّة والدين»، وبـ«المؤيد بالملكوت»، و«خالق البرايا»، وبـ«شيخ الإشراق» نسبة لكتابه الأهم فى مسيرته، ومسيرة التصوف الإشراقى: (حكمة الإشراق).
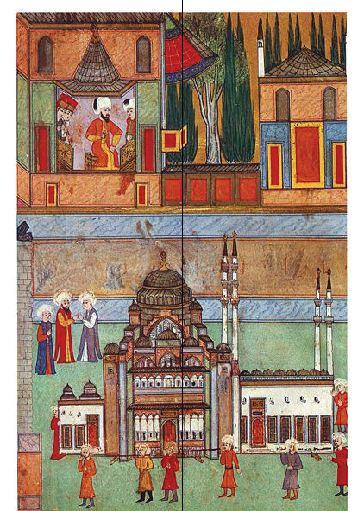
كيف يُقْتل من قال: «لا تتعجّب بشيء من حالاتك، لأنّ الواهبَ غير متناهى القوة، وعليك بقراءة القرآن كأنّه ما أنزل إلا فى شأنك فقط، واجمع هذه الخصال فى نفسك فتكون من المفلحين».
عاش فى حياتهِ القصيرة باحثًا وطالبَ معرفةٍ، وكان نابغًا بارعًا، مُحاججًا مناظرًا رائيًا شاهدًا عارفًا، «ذهنه يتوقد ذكاءً وفطنة»، فصيح اللسان، قوى الحجة، ناصع النية، نقى السريرة.
كان يسعى فى رحلته إلى تنقية الروح، ونخْل النفس مما علق بها من شوائب وأكدار الحياة اليومية، يتعمَّق فى التفسير والتعليل والوقوف على حقائق الأشياء، والعلم بالأسباب القصوى بحسب أرسطو، أو «التشبُّه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة» كما ذكر الجرجانى، حتى أشرقت نفسه بأنوار المكاشفات.
وهو ابنٌ شرعى لحكمة ابن سينا المشرقية، مثلما هو ابنٌ لفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وسواهم من فلاسفة اليونان وبلاد فارس، وعرف الديانات الشرقية، وتعاليم قدماء فارس خُصوصًا بزرجمهر.
فهو ابن بلدة جبلية تسمَّى (سُهْرَوَرْد)، أى الصخرة الحمراء باللغة الكُردية، القريبة من همدان وزنجان فى الشمال الغربى من بلاد فارس، وكانت وقتذاك موطن الفلسفة، وتَحقَّقَ له من العلوم الإلهية والأسرار الربانية الكثير، كما أنه ابنُ تجاربه ومُجاهداته الصوفية: «ولى فى نفسى تجاربُ صحيحةٌ، تدلُّ على أنَّ العوالم أربعة: أنوار قاهرة، وأنوار مدبرة وبرزخان»، وابنٌ لأبى يزيد البسطامى، سلطان العارفين (188 - 261 هجرية/ 804- 874 ميلادية)، وسهل التسترى (283 هجرية - 896 ميلادية) حيث يراهما أستاذيه، وهما من أهل القرن الثالث الهجرى، والحلاج (858 - 26 من مارس، 922 ميلادية /244 - 309 هـجرية) الذى يدعوه باسم أخيه، وصاحَبَ عبد القادر الجيلانى (470 - 561 هـجرية).
وقد زامل فى دراسته فخر الدين الرازى (544 – 606 هـجرية/ 1149- 1210 ميلادية)، وجرت بينهما نقاشاتٌ ومُساجلاتٌ وجدالٌ كثيرٌ، والذى سينقلب على نفسه، ويعيش حياته كارهًا للفلسفة ومعارضًا لأهلها، وسنقرأ له بعد تشكُّكه فى قدرة العقل:
«نهاية إقدام العقول عقالُ
وأكثر سعى العالمين ضلالُ
وأرواحنا فى وحشةٍ من جسومنا
وحاصل دنيانا أذىً ووبالُ
ولم نستفد من سعينا طول عمرنا
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا».
وقد جمع السُّهروردى حكمته الإشراقية من مصادر عدة فى مقدمتها ابن سينا الذى يتقاطعُ معه ويتشابه خُصوصًا فى «كتاب الشِّفاء»، و«كتاب النجاة» و«هرمس وزرادشت» و«إمام أهل الحكمة رئيسنا أفلاطون» كما يسمِّيه السُّهروردى، والذى يرى أن الفلاسفة المسلمين لم يصلوا «إلى جزء من ألف جزءٍ من رتبته»، كان «يأخذ ما يعينه ويتغاضى عمَّا لا يفيده ولا يتواءمُ مع رؤاه».
وكان السُّهروردى – الذى كان معاصرًا لابن رشد، ولم ينل مثله حظ الترجمة إلى اللغات الأوربية - رحَّالة يجوبُ الأرض، كثير السفر والتجوال متنقِّلا فى البلدان بحثًا عن العلم والعلماء، خصوصًا فى بلاد الشام، وبلاد الروم: «قد بلغ سنى قريب من ثلاثين سنة، وأكثر عمرى فى الأسفار والاستخبار والتفحُّص عن مشاركٍ مطِّلع على العلوم، ولم أجد من عنده خبر عن العلوم الشريفة ولا من يؤمن بها»، كان متوهجًا متقدًا ذكيًّا، أنجز الكثير، وأنتج أعماله الأساسية التى صارت متنًا من متُون التصوف، والفلسفة الإشراقية التى وضع أصولها «شرب ماء البحر كله». وانتقل من رُتبة العقل إلى رُتبة الرُّوح، كان «محبًّا للوحدة التى هيأت لحياته الروحية التأملية السلوك فى معارج أهل الطَّريق» كما يذكر عبد الرحمن بدوى (4 من فبراير 1917 - 25 من يوليو 2002 ميلادية)، ومن المحتمل أنه قد التقى الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى فى حلب، الذى كان أحد رموز المدرسة الإشراقية التى بدأت فى الأندلس عند ابن مسرة.

نحا شهاب الدين السهروردى (549 هـجرية/ 1155 ميلادية – 588 هجرية/ 1191 ميلادية) منْحىً إشراقيًّا عبر الذَّوْق والحدْس والمشاهدة، كى يبنى فلسفة كونية تضم المعتقدات المعروفة فى زمانه، بوحى من قلبه وضميره، إذ كان يميل بطبيعته إلى التفلسف، أخذ عن غيره، وأبدع لما استوت روحه وأشرقت، إذ نزع الحجب عنه، وكشفت بصيرته، أسكره عشق علم النور، وجلال نور الأنوار، حيث تتم المعرفة التى تختلف من شخصٍ إلى آخر.
ولا يمكن لها أن تكون واحدة «المعرفة لا تقوم على تجريد الصور بل تقوم على الحَدْس الذى يربط الذات العارفة بالجواهر النورانية صعوداً كان أو نزولاً»، يجرِّد معانى الأشياء ومدلولاتها، تحرر من عبودية المادة عبر الرؤيا والتأويل، وكان فى فلسفته يتبع مبدأ أفلوطين «نحو 205 - 270 ميلادية»: «إننى ربما خلوت بنفسى وخلعت بدنى جانباً». كما استعار من إشراق قدماء المصريين «الغرب أرض الرقدة والظلمة الكثيفة، بل إنه المكان الذى فيه من فيه يرقدون بأشكالهم المحنطة».
ومن مؤلفاته التى عددها تسعة وأربعون مؤلفاً بالعربية والفارسية، وهناك مصادر تقول إنها خمسون (حكمة الإشراق، والمشارع والمطارحات، والمقاومات، وبستان القلوب، والألواح العمادية، والواردات والتقديسات، وهياكل النور، وكتاب البصر، واللمحات فى الحقائق، والتلويحات ، والتلميحات، والمناجاة، ومقامات الصوفية ومعانى مصطلحاتهم، والتعرّف للتصوّف، وكشف الغطا لإخوان الصفا، ورسالة المعراج، واعتقاد الحكماء، والغربة الغربية، ورسالة جناح جبريل، وصفير سيمورغ)، إضافةً إلى ديوانٍ شعرى صغير الحجم عظيم الشِّعر، إذ تكفى قصيدته الحائية التى تعدُّ من القصائد الكبرى فى الشِّعر العربى، وهو من الذين يعملون فى أكثر من كتاب فى وقت واحد، فمثلاً خلال كتابة كتابه الأبرز بين كتبه «حكمة الإشراق» كان يحرِّر رسالة أو يكتبُ كتابًا آخر، ثم يعود إلى مواصلة «حكمة الإشراق» الذى قال فيه «إنّ قاعدة الإشراق هى طريق النور والظلمة التى كانت طريقة حكماء الفرس..».
«أَبَدًا تَحِنُّ إِلَيكُمُ الْأَرْوَاحُ
وَوصَالُكُمْ رَيْحَانُهَا وَالرَّاحُ
وَقُلُوبُ أهْلِ وِدَادِكُمْ تَشْتَاقُكُمْ
وَإِلَى لَذِيذِ لِقَائِكُمْ تَرْتَاحُ
وَارحمة لِلْعَاشِقِينَ تَكَلَّفُوا
سُرُّ الْمَحَبَّةِ وَالْهَوَى فضَّاحُ
أُهِلَّ الْهَوَى قَسَمَانِ: قَسَمٌ منهمو
كَتَمُوا، وَقِسَمٌ بِالْمُحِبَّةِ بَاحُوا
فالبائحون بِسُرِّهِمْ شَرِبُوا الْهَوَى
صَرَفَا فهزهموا بِالْغِرَامِ فَبَاحُوا
وَالْكَاتِمُونَ لِسُرِّهِمْ شَرِبُوا الْهَوَى
مَمْزُوجَةً فحَمتْهمو الْأَقْدَاحُ
بِالسُّرِّ إِنْ بَاحُوا تُبَاحُ دِمَاؤُهُمْ
وَكَذَا دِمَاء الْعَاشِقِينَ تُبَاحُ
وَإِذا هُم كَتَموا تَحَدَّثَ عَنهُم
عِنْدَ الْوُشَاةِ الْمَدْمَعُ السّفَاحُ
أَحَبَابُنَا مَاذَا الَّذِى أَفْسَدْتُم
بِجَفَائِكُمْ غَيْرِ الْفسَادِ صَلَاَحُ
خَفَضَ الْجنَاحُ لَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيكُمْ
لِلصَّبِّ فِى خَفضِ الْجنَاحَ جنَاحُ
وَبَدَتْ شوَاهِدُ لِلسَّقَامِ عَلَيهمُ
فِيهَا لِمُشْكِلِ أُمِّهِمْ إِيضاحُ
فَإِلَى لِقَاكُمْ نَفْسهُ مُرْتَاحَةٌ
وَإِلَى رِضَاِكُمْ طَرَفِهِ طمَاح
عَوَّدُوا بِنَوَرِ الْوَصْلِ مِنْ غَسَقِ الدُّجَى
فَالْهَجْرُ لَيْلٌ وَالْوصَالُ صَبَاحُ
صافاهُمُ فَصَفَوَا لَهُ فَقُلُوبُهُمْ
فِى نُورِهَا الْمِشْكَاةُ وَالْمِصْبَاحُ
وَتَمَتّعوا فَالْوَقْت طَابَ لِقُرُبِكُمْ
رَاقَ الشُّرَّابُ وَرَّقْتِ الْأَقْدَاحُ
يا صاحِ لَيْسَ عَلَى الْمُحِبِّ مَلَاَمَة
إِنْ لَاحَ فِى أُفُقِ الْوصَالِ صَبَاحُ
لَا ذَنْب لِلْعُشَّاقِ إِنْ غَلَبَ الْهَوَى
كِتْمَانَهُمْ.. فَنَمَا الْغَرَامُ فَبَاحُوا
سَمَحُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا بَخِلُوا بِهَا
لَمَّا دَرَوْا أَنَّ السَّمَاحَ ربَاحُ
وَدعاهُمُ دَاعِى الْحَقَائِقِ دَعْوَةَ
فَغَدَوَا بِهَا مُستَأنسين وَرَاحُوا
رَكِبُوا عَلَى سَنَن الْوَفا وَدُموعَهُمْ
بَحْرٌ وَشِدَّةُ شَوْقِهِمْ ملَاحُ
وَاللَّه مَا طَلَبُوا الْوُقُوفَ بِبَابِهِ
حَتَّى دَعَوَا فَأَتَاهُمْ الْمِفْتَاحُ
لَا يَطربونَ بِغَيْرِ ذِكْر حَبيبِهِمْ
أَبَدًا فَكُلُّ زَمَانهمْ أَفَرَاحُ
حَضَرُوا وَقَدْ غَابَتْ شوَاهِدُ ذاتِهم
فَتَهَتّكوا لَمَّا رَأوه وَصَاحُوا
أَفَنَّاهُمْ عَنهُمْ وَقَدْ كَشَفَتْ لَهُم
حُجُبُ اِلْبَقَا فَتَلاشتِ الْأَرْوَاحُ
فَتَشَبَّهوا إِن لَم تَكُونوا مِثلَهُم
إِنَّ التَّشَبّهَ بِالكِرامِ فَلاحُ
قُمْ يا نَدِيمَ إِلَى الْمُدَامِ فَهاتِهَا
فِى كَأْسِهَا قَدْ دارَتِ الْأَقْدَاحُ
مِنْ كَرمِ أَكرَام بُدْن دِيَانَة
لَا خَمِرَةُ قَدْ دَاسَهَا الْفَلَاَحُ
هِى خَمِرَةُ الْحُبِّ الْقَدِيمِ وَمُنْتَهَى
غَرِضَ النَّدِيمُ فَنِعْمَ ذَاكَ الرَّاحُ
وَكَذَاكَ نَوْحٌ فِى السَّفِينَةِ أَسَكَرَتْ
وَلَهُ بِذَلِكَ رَنَّةٌ وَنِياحُ
وَصَبَّتْ إِلَى مَلَكُوتِهِ الْأَرْوَاحُ
وَإِلَى لِقَاءِ سِواه مَا يَرْتَاحُ
وَكَأَنَّمَا أَجسَامَهُمْ وَقُلُوبَهُ
فِى ضَوْئِهَا الْمِشْكَاةُ وَالْمِصْبَاحُ
مَنْ بَاحَ بَيْنهُمْ بِذِكْرِ حَبيبِهِ
دَمُهُ حُلَاَلٌ لِلسُّيوفِ مُبَاحُ».
لم يتحمَّل الفقهاء السُّهروردى الذى اعتاد أن يمزج ويؤاخى بين العقل وعلم الظاهر والغيبيات، وكان رائداً فى ميدانه هذا، لذا كُفِّر واتهم بالزندقة، وهو الحوار ذاته الذى جرى مع مقتل الحلاج، الذى اعتبره السُّهروردى أخاه منذ شبابه، فقد وصف ابن تيمية السُّهروردى: «بالمقتول على الزّندقة»، وقال فى قتله ابن حجر العسقلاني: «مقتولٌ لسوء مُعتقده». وقال فى قتله شمس الدين الذّهبى: «أحسنوا وأصابوا»، وسار فى ركابهم الكثيرون من أهل التشدُّد والسَّلف، مثلما فعلوا مع الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى الذى قال فى ديوانه «تُرجمانُ الأشواق» فيما يشبه قول السُّهروردى:
« لقد كنتُ قبل اليوم أنكرُ صاحبى
إذا لم يكُن دينى إلى دينهِ دانِ
لقد صارَ قلـبى قابلاً كلَ صُـورةٍ
فـمرعىً لغـزلانٍ ودَيرٌ لرُهبـَـانِ
وبيتٌ لأوثانٍ وكعـــبةُ طـائـــفٍ
وألـواحُ تـوراةٍ ومصـحفُ قــرآن
أدينُ بدينِ الحُبِّ أنَّى توجَّهتْ
رَكائِبُهُ فالحُبُّ دينى وإيمانى».
ابن العربى صاحب
«تُرْجُمَانُ الأشواق»
«يا رُبَّ جَوهَرِ عِلمٍ لَو أَبوحُ بِهِ
لِقيلَ لى أَنتَ مِمَّن يَعبدُ الوَثَنا
وَلَاِسَتَحَلَّ رِجالٌ مُسلِمونَ دَمى
يَرَونَ أَقبَحَ ما يَأتونَهُ حَسَناً»
أندلسيان تركَا لنا كتابيْن مُهمَّيْن فى العِشق، أحدهما نثرى، وهو «طوقُ الحمامة فى الأُلفة والألَّاف» لابن حزم الأندلسى (30 من رمضان 384 هـجرية/ 7 من نوفمبر 994 ميلادية. قرطبة - 28 من شعبان 456 هـجرية/ 15 من أغسطس 1064 ميلادية).
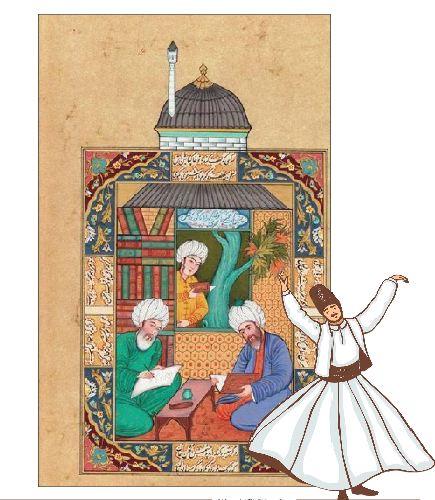
وثانيهما شِعرى، وهو «تُرجمان الأشواق» لابن العربى (ولد فى مرسية جنوب شرق الأندلس فى شهر رمضان عام 558 هـجرية الموافق 1164 ميلادية. وتوفى فى دمشق عام 638 هـجرية الموافق 1240 ميلادية. ودُفِنَ فى سفح جبل قاسيون)، لكنَّه عاش نحو ثلاثين سنةً فى إشبيلية، التى جاءها فى سن الثامنة من مسقط رأسه «مُرسية»، حيث درَس الحديث والفقه وعلوم القرآن، وكانت «إشبيلية» وقتذاك من أكبر مراكز التصوف فى الأندلس فى عهده، ومكث بها حتى عام 598 هجرية، وفى هذه الفترة زار قُرطبة، حيث درَس الفقه على تلاميذ الفقيه الشهير ابن حزم الأندلسى، والتقى بابن رشد «شيخ الفلسفة»، (1126 ميلادية - 520 هـجرية/ 1198 ميلادية - 595 هـجرية): «دخلتُ يومًا بقرطبةَ على قاضيها أبى الوليد بن رشد، وكان يرغبُ فى لقائى لما سمع وبلغه ما فتح الله به على فى خلوتى، فكان يُظهرُ التعجُّبَ ممَّا سمع. فبعثنى والدى إليه فى حاجةٍ، قصدًا منه حتى يجتمعَ بى، فإنَّه كان من أصدقائه، وأنا صبى ما بقل وجهى ولا طرَّ شاربى. فعندما دخلتُ عليه، قام من مكانه إلى مَحبَّةً وإعظامًا، فعانقنى وقال لى: نعم، قلتُ له: نعم، فزاد فرحه بى لفهمى عنه، ثم استشعرتُ بما أفرحه، فقلتُ: لا، فانقبض وتغيَّر لونُه وشكَّ فيما عنده. وقال لى: كيف وجدتم الأمرَ فى الكشف والفيض الإلهى، هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلتُ: نعم ولا، وبين نعم ولا تطيرُ الأرواحُ من موادِّها والأعناق من أجسادها، فاصفرَّ لونُهُ، وأخذه الأفكل وقعد يحوقلُ، وعرف ما أشرتُ به إليه».
يرجع تاريخ لقاء ابن العربى وابن رشد بين سنتى ٥٧٦ و578 هجرية، وكان ابن العربى وقتها فى سن السابعة عشرة من عمره، بينما كان ابن رشد فى السابعة والخمسين من عمره.
وقد وصف ابن رشد هذا اللقاء بأنه لقاء فتح فشكر الله تعالى الذى كان فى زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا، وخرج مثل هذا الخروج، من غير درسٍ ولا بحثٍ ولا مطالعةٍ ولا قراءةٍ. كما جاء فى «الفتوحات المكية» لابن العربى الذى يثق بالذوق والمشاهدة، والذى يعتبر ابن رشد - الذى يعتمد على النظر والمنطق - من «أكابر العقلاء» من دُون أن يذكرَ اسمه يقول: «ولقد سمعتُ واحدًا من أكابرهم، وقد رأى مما فتح الله به على من العلم به، سبحانه - من غير نظرٍ ولا قراءةٍ، بل من خلوة خلوتُ بها مع الله، ولم أكن من أهل الطلب – فقال: الحمد لله الذى أنا فى زمانٍ رأيتُ فيه، من أتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علمًا».
ابن العربى هنا يؤمنُ بأنَّ «الخلاف حق حيث كان»، وأنه من أهل المشاهدة، وفى الوقت نفسه لا ينكرُ من هم من أهل النظر، لكنه لا يحبُّ الخلطَ بينهم وبين من هم من أهل الكشف، بين الكشف والبرهان. وبين موقف نعم، وموقف لا، يقف ابن العربى كأنه فى برزخ بينهما، أليس هو القائل فى رسالته «الذى لا يُعوَّلُ عليه»: «التجلِّى المُتكرِّر فى الصُورة الواحدة لا يُعوَّل عليه»، وأنَّ «الإقامة على حالٍ واحدٍ نفسين فصاعدًا لا يُعوَّلُ عليه عند أكابر الرجال». كما أنه كان مؤمنا بقول أبى يزيد البسطامى (188 هـجرية - 804 ميلادية/ 261 هـجرية - 874 ميلادية) حين خاطب علماء الشريعة: «أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت، حدثنى قلبى عن ربى، وأنتم تقولون: حدثنى فلان، وأين هو؟ قالوا: مات، عن فلان وأين هو؟ قالوا: مات»، وقوله أيضًا: « ليس العالِم الذى يحفظ من كتاب، فإذا نسى ما حفظه صار جاهلًا، إنما العالِم الذى يأخذ علمَهُ من ربِّه أى وقتٍ، شاء بلا حفظٍ، ولا درسٍ».
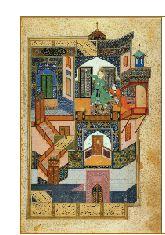
كما التقى – وهو الحادسُ المبصرُ الحائرُ العارف، المتعدِّد الأسئلة، الباحثُ عن الحقيقة واليقين - فى إشبيلية الوليَّة الشيخة فاطمة بنت المثنى القرطبية، التى ستكونُ فاتحةَ الحُبِّ الرُّوحى فى حياته، منذ أن قالت له: «أنا أمك الإلهية»، وهو ابنُ الخيال العرفانى. ويذكرُها فى كتابه «الفتوحات المكية»، فيقول: «وخدمتُ أنا بنفسى امرأةً من المخبَّآت العارفات بإشبيلية، يُقَالُ لها: فاطمة بنت المثنَّى القرطبى، خدمتُها سنين، وهى تزيد وقت خدمتى إياها على خمس وتسعين سنة، وكنتُ أستحى أن أنظرَ إلى وجهها فى هذه السن من حُمْرَة خدَّيْها، وحسن نعمتها وجمالها، تحسبُها بنت أربع عشرة سنة من نعومتها ولطافتها. وكان لها حال مع الله، وكانت تؤثرنى على كلِّ مَنْ يخدمها من أمثالى. وتقول: ما رأيتُ مثل فلان، إذا دخل عَلَى دخل بكُلِّه لا يتركُ منه خارجًا عنى شيئًا، وإذا خرج من عندى خرج بكُلِّه لا يترك عندى منه شيئًا. وسمعتُها تقول: عجبتُ لِمَنْ يقول: إنه يحبُّ الله ولا يفرحُ به، وهو مشهودٌ، عينه إليه ناظرة فى كل عينٍ، ولا يغيبُ عنه طرفة عينٍ، فهؤلاء البكَّاءون كيف يدَّعون محبَّته ويبكون، أما يستحُون؟ إذا كان قربه مضاعفًا من قرب المتقرِّبين إليه، والمُحب أعظم الناس قربة إليه فهو مشهودُه، فعلى مَنْ يبكى؟ إنَّ هذه لأعجوبة.
ثم تقولُ لى: يا ولدى، ما تقولُ فيما أقول؟ فأقولُ لها: يا أمِّى، القولُ قولُك. قالت: إنِّى والله لمتعجِّبة، لقد أعطانى حبيبى فاتحة الكتاب تخدمُنى، فوالله ما شغلتْنى عنه. فمن ذلك اليوم عرفتُ مقام هذه المرأة لما قالت: إنَّ فاتحةَ الكتاب تخدمُها، فبينما نحنُ قعودٌ إذ دخلتِ امرأة، فقالت لى: يا أخى، إنَّ زوجى فى «شريش» وأريدُه، فماذا ترى؟ قلتُ لها: وتريدين أن يصل؟ قالت: نعم. فرددت وجهى إلى العجُوز، وقلتُ لها: يا أُمِّ، ألا تسمعين ما تقولُ هذه المرأة؟ قالت: وما تريد يا ولدى؟ قلت: قضاء حاجتها فى هذا الوقت. فقالت: السَّمع والطاعة، إنِّى أبعثُ إليه بفاتحة الكتاب وأوصيها أن تجىء به. وأنشأت فاتحة الكتاب تقرأها وقرأتُ معها، فعلمتُ مقامها عند قراءتها الفاتحة، وذلك أنها تنشيها بقراءتها صورة مُجسَّدة هوائية، هى سرٌّ من أسرار عطايا القرآن، فلما أنشأتْها صورة سمعتُها تقولُ لها: يا فاتحة الكتاب، أطلبُ كذا. فلم يلبثْ حتى وصل إلى أهله.
وكانت تضربُ بالدُّفِّ وتفرح، فكنتُ أقول لها فى ذلك، فتقول لى: والله، إنِّى أفرح، حيث اعتنى بى وجعلنى من أوليائه واصطفانى لنفسه، مَنْ أنا حتى يختارنى على أبناء جنسى، وعزة ربى، إنه يغار على غَيْرة ما أصعبَها، ما التفتُّ إلى شيءٍ باعتمادى عليه عن عالة إلا أصابنى ببلاء فى ذلك الذى التفتُّ إليه، ثم أرتْنى عجائب من ذلك، فما زلتُ أخدمها بنفسى، وبنيتُ لها بيتًا من قصب بيدى على قدر قامتها، فما زالتْ فيه حتى دُرجت، وكانت تقول لى: أنا أمُّك الإلهية، ونور أمك الترابية، وإذا جاءتْ والدتى إلى زيارتها تقول لها: يا نور، هذا ولدى فبِرِّيه ولا تَعُقِّيه».
«إنها كانت من المجتهدات. لم أرَ فى الرجال ولا فى النساء أشد ورعاً ولا اجتهادًا منها. ما ذكرت لها مقاماً إلا كان المقام لها حالاً. ذات شوق وكشوف».
«تزوجت برجل صالح، فابتلاه الله بالجذام، فخدمته أربعا وعشرين سنة، مسرورة بذلك إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى».
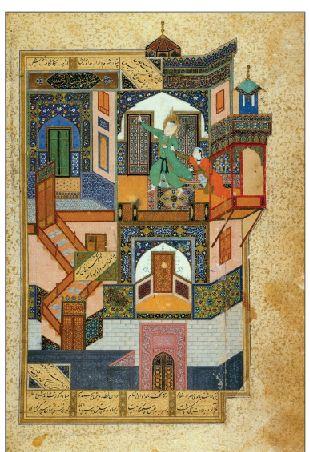
«لها فى التوكل قدم راسخة، وكان عيشها فى بدايتها من مغزلها، فخطر لها يومًا أن تعيش من غزل يدها فقرض الله إصبعها التى كانت تغزل بها من وقتها، ورأيته مقروضاً، فسألتها عن شأنه فأخبرتنى بما ذكرته، وصار عيشها مما ينبذه الناس من الأطعمة خلف بيوتهم».
«كانت إذا جاعت ولم يُفتح عليها بشىء، وضيّق عليها فى رزقها، تفرح وتسر به، وتشكر الله على هذه النعمة، حيث فعل معها ما يفعله مع أنبيائه وأوليائه. تقول: يارب، بماذا استوجبت عندك هذه المنزلة العظمى حيث عاملتنى بما تعامل به أحباءك».
بنيت لها بيتًا من خوص، كانت تتعبد فيه، فلما كانت ذات ليلة، فرغ الزيت الذى كانت توقد به السراج، وطفى السراج ولم يكن ينطفى لها سراج قط، وما عرفت قط سر ذلك منها، فقامت لتفتح باب الخص لتطلب منى أن أجىء لها بزيت، فغرقت يدها فى مائع فى الدف الذى كان تحتها، فشمته فإذا به زيت فأخذت الكوز وملأته بالزيت، فلما امتلأ الكوز، أسرجت الفتيلة، وجاءت تنظر موضع الزيت، فلم تر له أثرًا رأسًا، فعلمت أن ذلك رزق آتاه الله.
كانت طائفة من مؤمنى الجن يجلسون إليها، ويرغبون فى صحبتها، وكانت تأبى عليهم وتسألهم أن يحتجبوا عنها، وتذكر ما ذكره رسول الله، ليلة قبْضه على الجنى: «تذكرت دعوة أخى سليمان فأرسلته».
وكانت قد فتح لها فى فاتحة الكتاب، ووجهتها فى أى شأن فينقضى ولابد. جربنا ذلك عليها مراراً.
ابن حزم وابن العربى كلاهما وُلدَ فى رمضان، لكن بين الثانى والأول مئةٌ وسبعٌ وأربعون سنة، لكن بقى ابن حزم فى الأندلس، بينما ابن العربى - الذى أراه الرحمة الخالصة بالعالم - قد غادر بلاده، ولم يعُد إليها ثانيةً، وأنجز كلَّ تراثه الذى وصل إلينا بعضٌ منه فى الشرق، خُصُوصًا فى مكة ودمشق.
ويعتقد البعض أن ابن العربى صاحب «الفتوحات المكية» و«فصُوص الحِكَم»، وهو آخر ما كتب ابن العربى، وقد ظهر سنة 627 هـجرية، أى قبل وفاته بنحو عشر سنوات، ويذكر عمر بن الوردى (691 هـجرية / 1292 ميلادية - 749 هـجرية / 1349 ميلادية) فى (تتمة المختصر فى أخبار البشر ويعرف بـ(تاريخ ابن الوردى): «فى هذه السنة - أى سنة 744 هـجرية - مزقنا كتاب (فصوص الحكم) بالمدرسة العصرونية بحلب عقيب الدرس وغسلناه، وهو من تصانيف ابن العربى، تنبيهًا على تحريم قنيته ومطالعته».
وهما المتنان الأساسيان بين مؤلفاته، وأراهما أكثر شعرية من كتابيه الشعريين «ترجمان الأشواق»، و«الديوان الكبير»، كان ينتمى إلى المذهب الظاهرى، مثله مثل ابن حزم الأندلسى.
يذكر المقرى فى (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب) أن ابن العربى كان «ظاهرى المذهب فى العبادات، باطنى النظر فى الاعتقادات».

ومن المُؤكَّد لنا أنَّ ابن العربى قد قرأ كتاب ابن حزم «طوق الحمامة...» وهو فى الأصل رسالة ألَّفها ابن حزم وهو مقيمٌ بمدينة «شاطبة»، وهى مدينة إسبانية تقع فى مقاطعة بلنسية، وصارت تسمَّى جاتيفا (Játiva)، لأنه كان أوحد وأشهر الكُتب فى زمانه، ولذا جاء «ترجمان الأشواق» الذى يتألف من إحدى وستين قصيدة ومقطوعة (والشعر فى أكثره ضعيف إذا ما قورن بالشعر العربى وأيضا شعر الحلاج وابن الفارض، لكن أهميته تأتى من أهمية ابن العربى وجرأته فى الكشف عن ملهمته الشعرية)، وكتبه على مدى حوالى خمس عشر سنة - كاسرًا لتوقُّع مُريديه وقُرَّائه ومُحبِّيه، لأنه ديوانٌ فى عشقِ امرأةٍ من لحمٍ ودم، اسمها النظام ابنة شيخِهِ فى مكة بنت الشيخ أبى شجاع بن رستم الأصفهانى:
«نُظِّمَت نِظامَ الشَملِ فَهِى نِظامُنا
عَرَبِيَّةٌ عَجماءُ تُلهى العارِفا»
(وهى غير مريم بنت محمد بن عبدون البجائى التى تزوجها فى إشبيلية)، أنجبتْ له ولديْن، وابنة اسمها زينب، توفيت وهى صغيرة، وقد ساعدته على أن يتفرَّغ ويهب نفسه إلى التصوف، وقد توفيت فى حياته.
كما تزوَّج فى قونية بتركيا من أرملة صاحبه مجد الدين إسحق القونوى (توفى 617 هجرية/ 1220 ميلادية) والدة صدر الدين القونوى أحد أهم تلاميذه، وتزوَّج أيضًا فى دمشق من إحدى بنات القاضى محيى الدين بن الزكى، الذى احتفى واحتفل كثيرًا بابن العربى، وكان كريمًا سخيًّا معه.
والنظام عرفها فى مكة سنة 598 هجرية عندما قدم إليها أول مرَّة من المغرب، كما تزوَّج من فاطمة بنت أمير الحرمين يونس بن يوسف، التى أنجبت له أكبر أولاده الذى سمَّاه مُحمَّدا ولقَّبه عماد الدين، وهو الذى أهدى إليه النسخة الأولى من الفتوحات المكية، ومكة هى المكان الذى كتب فيه الديوان، مثلما بدأ فيها كتابة أهم كُتبه وأكبرها «الفتوحات المكية» التى استمر فى كتابتها سبعةً وثلاثين عامًا، والذى يذكر فى مفتتحه: «لو علمتَه لَمْ يَكُن هُو، وَلو جَهلَك لَمْ تكن أنت: فبعلمه أوجدَك، وبعجزك عبدتَه، فهو هو لِهُوَ، لا لَكَ. وأنت أنت، لأنت وَلَهُ، فأنت مرتبطٌ به، ما هو مرتبطٌ بك. الدائرةُ – مطلقةٌ – مرتبطةٌ بالنقطة. النقطةُ – مطلقةٌ - ليست مرتبطةً بالدائرة. نقطةُ الدائرة مرتبطةٌ بالدائرة».
«اعلم أن ترتيب الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا نظر فكر، وإنما الحق تعالى يملى علينا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره. وقد تذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده».
و«ترجمان الأشواق» ترجمه إلى الإنجليزية أول مرة سنة 1911 ميلادية المستشرق البريطانى رينولد نيكلسون وهو ليس ديوانًا فى العِشق الإلهى كما اعتاد الناس من المتصوفة، إذ لم يأت الشِّعر عرفانيًّا صوفيًّا، لذا هاجمه فقهاء الظاهر، الغلاظ المتزمتون فى حلب ومكة وغيرهما من الأماكن، لأنهم يروْن الحُبَّ منقصةً فى حقِّ ابن عربى، وتُهمة كُبرى لا تُمحى ولا تُغتفر، كأنهم لم يروا ما كتبه نجم الدين كبرى (540 - 618 هـجرية) فى «فوائح الجمال وفواتح الجلال»: «عشقت جاريةً بقريةٍ على ساحل نيل مصر، فبقيتُ أيامًا لا آكلُ ولا أشربُ إلا ما شاء الله حتى كثرت نار العشق، فكنتُ أتنفس نيرانًا.. وكلما تنفستُ نارًا، تنفَّسوا من السماء بحذاء نَفَسى نارًا، فتلتقى الناران ما بينى وبين السَّماء، فما كنتُ أدرى من ثَمَّة أين تلتحقان، فعلمتُ أن ذلك شاهدى فى السماء».
ولمَّا اشتد الهجومُ كتب عام 611 هجرية فى حلب كتابه «ذخائر الأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق»، ليبرِّئ ساحته من امرأةٍ أحبَّها، ورآها «رمزًا للأنوثة السارية فى العالم»، كأنَّ التغزُّل بامرأةٍ عشقها شيء يشينه، وهو ما نأخذُهُ عليه، خصوصا أن شرحه أو بيانه التوضيحى، جاء فى أغلبه متكلفاً، حيث كان يلوى عنق النصوص ليًّا، ولعله يكون الشَّاعرُ الوحيد فى الدنيا الذى أراه يشرحُ ديوانه بنفسه، كى يتقِّى غضبةَ الفقهاء المتربِّصِين له، ولأى صُوفى سواه، وهذا حدثٌ لم يقع من قبل، وكان فراغه من الشرح فى شهر ربيع الآخر، سنة 612 هجرية، اثنتى عشرة وستمائة، بمدينة آق سراى التى تقع فى وسط تركيا.
وهو الذى كان قد ترك الأندلس بعدما أدرك أنَّ الفقهاء المالكيين المتشدِّدين قد سيطروا على الأجواء، وطاردُوا الفلاسفةَ والصُّوفيين، وكان ما حدث لابن رُشد وسواه من هؤلاء مثالاً للتتشدُّد والنفى والسجن وحرق الكُتب، والإقصاء من المشهد، ورأى أنَّ الأفق يضيقُ، ولم يعد له مكانٌ فى الأندلس.
ومما جاء فى تبريره فى مقدمة «ذخائر الأعلاق...»: (ولم أزل فيما نظمته فى هذا الجزء على الإِيماء إلى الواردات الإلهية والتنزُّلات الروحانية والمناسبات العلوية، ولعِلمها رضى الله عنها بما إليه أشير، ولا ينبؤك مثل خبير، والله يعصم قارئ هذا الديوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية والهمم العليّة المتعلقة بالأمور السماوية، آمين بعزّة من لا ربّ غيره، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل).
وفى سنه 1214 ميلادية زار مكة بعد تجوال وسفر فى عدد من البلدان ومن بينها مصر التى رحل إليها سنة 1206 ميلادية، لكنه لم يمكث إلا عاماً واحداً، ثم رجع إلى مكة، فوجد عددًا من فقهائها، قد شوَّهُوا سيرته بسبب ديوانه «ترجمان الأشواق»، الذى كتبه وهو فى السادسة أو الثامنة والثلاثين من عمره، وإن كانت هناك مصادر تشير إلى أنه كان فى سن الخمسين، وكان قد مرت ثلاثة عشر عامًا على كتابته، فرحل إلى دمشق، وظل بها قرابة العشرين عاماً (فى الفترة 1223 1240 ميلادية)، وبقى بها حتى وفاته، وفيها التقاه جلال الدين الرومى، وممن عاصروا ابن عربى: ابن رشد، فخر الدين الرازى، العز بن عبد السلام، فريد الدين العطار، أبو الحسن الشاذلى، توما الأكوينى: «نحن قوم يحرم النظر فى كتبنا، وذلك أن الصوفية تواطأوا على ألفاظ اصطلحوا عليها، وأرادوا بها معانى غير المعانى المتعارفة منها، فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفَر وكفَّرهم»، كأنَّ ابن العربى كان يعرفُ أنه سيُقْرَأ قراءةً خاطئة ومتجنية ومتربِّصة به فى زمانه وفى الأزمنة التالية، فحذَّر قصيرى الرؤية والنظر من القراءة المغلوطة وغير المدركة لأسرار ورموز ومفاتيح النص.
وتعد فاتحة أو توطئة «ترجمان الأشواق» - الذى يجمع بين الإشارة والعبارة - ترجمة ذاتية لحبه النظام، إذ يسرد فى العلن دون خشية أو ريبة قصة عشقه لابنة شيخه:
«طالَ شَوْقى لِطَفْلَة ٍ ذاتِ نَثْرٍ
«ونِظـــامٍ» ومِنْبَرٍ وَبَيانِ
من بناتِ المُلوكِ من دارِ فرسٍ
من أجلّ البلادِ من أصْبَهَانِ
هى بنتُ العِرَاقِ بنتُ إمامى
وأنا ضِدّها سَلِيلُ يمانى
هلْ رأيتمْ، يا سادتى، أو سمعتمْ
أنّ ضِدّينِ قَطُّ يَجتمِعَانِ
لو تَرَانَا برامة ٍ نَتَعَاطَى
أكؤسًا للهوى بغيرِ بنانِ
والهوى بيننا يسُوقُ حديثًاً
طيبًا مطربًا بغيرِ لسانِ
لرأيتم ما يذهبُ العقلُ فيهِ
يمنٌ والعراقُ معتنقانِ
كذبَ الشَّاعرُ الذى قال قبلى
وبأحجارِ عقلهِ قدْ رمانى
أيها المُنكِحُ الثريَّا سُهيلاً
عَمرَكَ الله كيْفَ يَلْتقِيَانِ
هى شاميَّة، إذا ما استقلتْ
وسُهَيْلٌ، إذا استهَلّ يَمَانِى»
ولذا حرصت على إثبات مقاطع منها هنا، لتكون درسًا فى البوح والكشف عن مخبوء النفس: «فإنى لما نزلتُ مكة سنة خمسمائة وثمان وتسعين (1201 م)، ألفيت بها جماعة من الفضلاء، وعصابة من الأكابر الأدباء والصلحاء بين رجال ونساء، ولم أر فيهم مع فضلهم مشغولاً بنفسه، مشغوفاً فيما بين يومه وأمسه، مثل الشيخ العالم الإمام، بمقام إبراهيم عليه السلام، نزيل مكة البلد الأمين مكين الدين أبى شجاع زاهر بن رستم بن أبى الرجا الأصفهانى، رحمه الله تعالى، وأخته المسنة العالمة شيخة الحجاز فخر النساء بنت رستم».
«وكان لهذا الشيخ، بنت عذراء، طفيلة هيفاء، تقيد النظر، وتزين المَحَاضِرَ والمُحاضِر، وتحير المناظر، تسمى بالنظام وتلقب بعين الشمس والبها، من العابدات العالمات السابحات الزاهدات شيخة الحرمين، وتربية البلد الأمين الأعظم بلا مَيْن، ساحرة الطرف، عراقية الظرف، إن أسهبت أتعبت، وإن أوجزت أعجزت، وإن أفصحت أوضحت. إنْ نطقت خرس قس بن ساعدة، وإن كرمت خنس معن بن زائدة، وإن وفَّت قصَّر السموأل خطاه، وأغرى ورأى بظهر الغرر وامتطاه. ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض، السيئة الأغراض، لأخذت فى شرح ما أودع الله تعالى فى خَلْقِها من الحُسن، وفى خُلُقها الذى هو روضة المزن. شمس بين العلماء، بستان بين الأدباء، حقة مختومة، واسطة عقد منظومة. يتيمة دهرها، كريمة عصرها، سابغة الكرم، عالية الهمم، سيدة والديها، شريفة ناديها، مسكنها جياد، وبيتها من العين السواد، ومن الصدر الفؤاد. أشرقت بها تهامة، وفتح الروض لمجاورتها أكمامه، فنمت أعراف المعارف، بما تحمله من الرقائق واللطائف.
علمها عملها، عليها مسحة ملَك وهمَّة ملِك، فراعينا فى صحبتها كريم ذاتها مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة العمة والوالد، فقلدناها من نظمنا فى هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق، وعبارات الغزل اللائق.
ولم أبلغ فى ذلك بعض ما تجده النفسُ، ويثيره الأنس، من كريم ودها، وقديم عهدها، ولطافة معناها، وطهارة مغناها. إذ هى السؤال والمأمول، والعذراء البتول، ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق، من الذخائر والأعلاق. فأعربتُ عن نفسٍ توّاقة، ونبهتُ على ما عندنا من العلاقة، اهتماماً بالأمر القديم، وإيثاراً لمجلسها الكريم، فكل اسم أذكره فى هذا الجزء فعنها أكنِّى، وكل دارٍ أندبها فدارها أعنى، ولم أزل فيما نظمته فى هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية، والنزلات الروحانية، والمناسبات العلوية، جرياً على طريقتنا المثلى، فإن الآخرة خير لنا من الأولى، ولعلمها، رضى الله عنها، بما إليه أشير، ولا ينبئك مثل خبير، والله يعصم قارئ هذا الديوان من من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية، والهمم العلية، المتعلقة بالأمور السماوية..».
«وكان سبب شرحى لهذه الأبيات أن الولد بدرًا الحبشى
والولد إسماعيل ابن سودكين سألانى فى ذلك وهو أنهما سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب ينكران هذا من الأسرار الربانية والتنزلات الإلهية، وأن الشيخ يتستر لكونه منسوبًا إلى الدِّين والصلاح، فشرعت فى شرح ذلك وقرأ على بعضَه القاضى ابن العديم بحضرة جماعة من الفقراء، فلما سمعه ذلك المنكر الذى أنكرَهُ تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع عن الإنكار على الفقراء وما يأتون به فى أقاويلِهِم من الغزلِ والتشبيبِ، ويقصدون بذلك أسرارًا إلهية، فاستخرت الله تعالى تقييد هذه الأوراق وشرحت ما نظمته من الأبيات بمكة المشرفة من الأبيات الغزلية فى حال اعتمارى فى رجب وشعبان ورمضان أشير بها إلى معارف ربانية، وأسرار روحانية، وعلوم عقلية، وتنبيهات شرعية، وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب، لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوفر الدواعى على الإصغاء إليها، وهو لسان كل أديب ظريف، روحانى لطيف..».
«كنتُ أطوفُ ذات ليلة بالبيت فطاب وقتى، وهزّنى حال كنت أعرفه، فخرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل، فحضرتنى أبيات فأنشدتها أسمع بها نفسى ومن يلينى، لو كان هناك أحد:
ليتَ شعرى هلْ دَرَوْا
أى قلب ملكوا
وفؤادى لو دَرَى
أى شِعْب سلكوا
أتراهم سَلِموا
أم تراهم هلكوا
حار أربابُ الهوى
فى الهوى وارتَبَكُوا
فلم أشعر إلا بضربةٍ بين كتفى بكفٍّ ألين من الخزّ، فالتفت فإذا بجارية من بنات الروم لم أر أحسن وجها، ولا أعذب منطقاً، ولا أرق حاشية، ولا ألطف معنى، ولا أدق إشارة، ولا أظرف محاورة منها، قد فاقت أهل زمانها ظرفاً وأدباً وجمالاً ومعرفة، فقالت: يا سيدى كيف قلت؟ فقلت:
ليتَ شِعرى هلْ دَرَوْا
أى قلبٍ ملكُوا
فقالت: عجباً منك، وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا! أليس كل مملوك معروفا؟ وهل يصح الملك إلا بعد المعرفة وتمنى الشعور يؤذن بعدمها والطريق لسان صدق فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا؟ قل يا سيدى: ماذا قلت بعده؟ فقلت:
وفؤادى لـــــــو درى
أى شــــــعبٍ سلكوا
فقالت: يا سيدى الشعب الذى بين الشغاف والفؤاد هو المانع له من المعرفة، فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المعرفة، والطريق لسان صدق فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ياسيدى؟ فماذا قلت بعده؟ فقلت:
أتراهم سلـــــــــــموا
أم تــــــــراهم هلكوا
فقالت: أما هم فسلموا، ولكن أسأل عنك فينبغى أن تسأل نفسك: هل سلمت أم هلكت ياسيدى؟ فما قلت بعده؟ فقلت:
حار أرباب الــــهوى
فى الهوى وارتبكوا
فصاحت وقالت: يا عجباً كيف يبقى للمشغوف فضلة يحار بها، والهوى شأنه التعميم يخدِّر الحواس ويُذهب العقول ويدهش الخواطر ويذهب بصاحبه فى الذاهبين فأين الحيرة وما هنا باقٍ فيحار والطريق لسان صدق والتجوز من مثلك غير لائق؟. فقلت: يا بنت الخالة ما اسمك؟ قالت: قرة العين. فقلتُ: لى. ثم سلمت وانصرفت. ثم إنى عرفتها بعد ذلك، وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف المعارف الأربع ما لا يصفه واصف».
ديوان ترجمان الأشواق لابن العربى، مثله مثل ديوان عمر بن الفارض (576 هـجرية – 1181 ميلادية/ 632 هـجرية – 1235 ميلادية)، الذى كان مُعاصرًا له فى القرن السابع الهجرى وكانا من أعلامه البارزين فى التصوف، وتوفى قبله بست سنواتٍ، عملان فريدان ليسا عابرين فى مُدوَّنة الإرث الشِّعرى الصُّوفى، استطاعا أن يعبُرا الزمان والمكان، ويصلا إلى المتلقِّى أينما كان، وتلك طبيعة الكتب الكبرى التى يُقدَّر لها أن تبقى، خُصُوصًا تلك التى تعتمدُ الإضمار والإخفاء والإبطـان والإيماء والحذف والكناية والتلويح فى التعبير، بـدلاً عن الكشـف (فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ - سورة ق - الآية 22) والإعـلان والتصريح المباشر، إذ يكفى المتصوف أن يرمِز ويلمِّح، ويمكن أن نضم إليهما كتباً أخرى فى التصوف، وفى مقدمتها «المواقف» و«المخاطبات» للنفَّرى، ومن المؤكد أنه اطلع على هاتين الرسالتين الفريدتين فى لغتهما وشكلهما، و«الطَّواسين» للحلاج، حيث يختصر أصحابها فى الّلفظ ويكثِّفون فى المعانى، يقول ابن العربى:
«ألا إنّ الرموزَ دليل صدقٍ
على المعنى المغيب فى الفؤادِ
وإنّ العالمـــين له رموزٌ
وألغاز ليدعى بالعبـــــادِ
ولولا اللغز كان القول كُفرًا
وأدّى العالمين إلى العنـــادِ
فهم بالرمز قد حسبوا فقالوا
بإهراق الدّماءِ وبالفســــادِ».
ابن العربى - الغزير الإنتاج والمتنوع والمتعدد فى أشكال كتابته - يُظْهِر مكنونه فى الـ«ترجمان»، بعيدًا عن الشّرح والتّوضيح، حيثُ يكشف القناع، ويهتك الحُجب، التى تشتمل على الخفى والباطن، فى إشارات «تدلُّ على بعد المرمى وفرط المقدرة وليس يأتى بها إلَّا الشَّاعر المبرز والحاذق الماهر، وهى فى كل نوع من الكلام لمحة دالّة واختصار وتلويح يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه» حسبما يعرف ابن رشيق القيروانى «الإشارة»:
«إذا أهْــــلُ العِـــــبَارة سـَـــــاءلـوُنَا
أجَبْــنَــــاهم بأعْــلام الإشَـــــــارَة
نُشِــــــيُر بها فَنَـــجْعَلها غُمُـوضا
تُقَـــــصِّر عَنـْــــــهُ تَرْجَمَةُ العِبَارَة
وَنَشْــــــــهَدُهَا وَتَشْـــهَدُنَا سُرُوَرَا
لهُ فى كلِ جَــــــارِحَة إشَـــــــارَة
تَرى الأقْـــوَالَ فى الأحـوَال أسْرَىَ
كأسْـــرٍ العَارفِينَ ذَوْى الخِسَـــارة»
يقول ابن العربى، صاحب المصادرالمتعددة فى فلسفته، والذى لا يحب الكلام الزائد «... إنى كنت شديد القهر لنفسى فى الكلام»، ومثله تكفيه الإشارات والتلويحات والرموز والاستعارات الكثيفة، بعدما تصفو النفس، إذ الصمت حقيقته. وقد أدخل ابن العربى ألفاظاً ومصطلحات وأبجديات فيما ألَّف من رسائل وكتبٍ، لم يعرفها سواه، كشف بها عن معانيه ومعاناته.
ويرى ابن العربى – الذى سبقه إلى ذلك ابن سينا والحلاج - أن «الرّموز والألغاز ليست مرادة لنفسها، وإنَّما هى مرادة لما رمزت له ولما ألغزت إليه، وكذلك شأن الإشارة والإيماء. قال تعالى لنبيّه زكريا: قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا، أى بالإشارة...».
فابن سينا يعلنها صراحةً «... من أحبَّ أن يتعرَّفها فليتدرَّج إلى أن يصيرَ من أهل المشاهدة دون المشافهة، ومن الواصلين للعين دون السّامعين للأثر»، وابن العربى - الذى ينتمى تاريخيا إلى نهايات العصر العباسى، حيث تتراجع الحسية فى شعر الغزل - مهجوس بالتفسير الحسِّى للظواهر والأشياء، كما أنه مختلفٌ عن أقرانه ومجايليه ومن سبقوه فى الطريق الصوفى، حيث لا يخجل أو يتردَّد فى ذكر النساء اللواتى تعلم منهن، ودرس على أيديهن.
وقد خصَّص بابًا فى «الفتوحات المكية» سماه: «النكاح السَّارى فى الأرواح والذرارى»، وكذلك تأويله لقوله تعالى: «الَّذِى جَعَل لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاشًا والسَّمَاءَ بِنَاءً وأَنْزَلَ منَ السَّمَاءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ منَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ…».
ويروى لنا فى حلمٍ رآه: «رأيت ليلة أنى نكحت نجوم السماء كلها فما بقى منها نجم إلا نكحته بلذَّةٍ عظيمة روحانية، ثم لما أكملت نكاح النجوم أُعْطِيتُ الحروف فنكحتها، وعرضتُ رؤياى هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا بصير بها، فقال: صاحب هذه الرؤيا يُفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص الكواكب ما لا يكون لأحدٍ من أهل زمانه».
يقول ابن عربى: «كنت من أكره خلق االله تعالى فى النّساء وفى الجماع فى أوّل دخولى إلى هذا الطّريـق، وبقيت على هذا نحواً من ثمانى عشرة سنة إلى أن شهدت هذا المقام. وكان قد تقدّم عندى المقت لذلك. فلمّا وقفت على الخبر النّبوي، وأنّ الله حبّب النّساء لنبيّه، وهو أحبّهنّ بتحبيب الله إليه، زال عنّى ذلك المقت. وما يعلم قدر النّساء إلا من علم وفهم عن الله ما قاله فـى حقّ زوجتى رسول الله عندما تعاونتا عليه. ومذاك وأنا أكثر خلق الله رأفة بهـنّ ومحبّـة لهن».
«لأنّ المرأة جزء مـن الرّجل فى أصل ظهور عينها».
«يذهب ابن عربى إلى أن شرف التأنيث يتمثل فى إطلاق كل من (الذات) و(الصفة) على الله تعالى. وكلاهما لفظ تأنيث: جبرا لقلب المرأة الذى يكسره من لا علم من الرجال بالأمر».
إنه لا يعرف قيمة المرأة ومكانتها إلا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأمر الإلهى. فإن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهى. لأن المرأة محل وجود الأبناء، كما أن الطبيعة للأمر الإلهى محل ظهور أعيان الأجسام. فيها تكونت وعنها ظهرت. فأمر بلا طبيعة لا يكون، وطبيعة بلا أمر لا يكون. فالكون متوقف على الأمرين.
فمن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة. ومن عرف الأمر الإلهى فقد عرف مرتبة الرجل. وأن الموجودات - مما سوى الله - متوقف وجودها على هاتين الحقيقتين. والنتيجة أن المرأة بدون الرجل لا شىء، كما أن الرجل بدون المرأة.. لا شىء».
«جعل الله النساء زهرة حيث كن، فإذا كنّ فى الدنيا كنّ زهرة الحياة الدنيا، فوقع النعيم بهن حيث كن. وأحكام الأماكن تختلف. فهن وإن خلقن للنعيم فى الدنيا فهن فتنة يستخرج الحق بهن ما خفى عنا فينا مما هو عالم ولا نعلمه من نفوسنا فيقيم به الحجة علينا.
وهذا مقام أعطانيه الحق بمدينة فاس سنة 593 هجرية، قبل ذلك ما كان لى فيه ذوق.. ولما كانت الزهرة دليلة على الثمرة، ومتنزهاً للبصر، ومعطية الرائحة الطيبة، فإن صاحب الزهرة (= الزوج) إذا لم يدرك رائحتها، ولا شهدها زهرة وإنما شهدها امرأة، ولا علم دلالتها التى سبقت له على الخصوص، وزوجت به، وتنعم بها، ونال منها ما نال بحيوانيته، لا بروحه وعقله، فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان، بل الحيوان خير منه».
وابن العربى الذى خصَّهُ الله بالأنوار وزوَّده بالكرامات، وعلو الكشف، يدرك ما «أودعه الله فى المرأة من جمال ومن جلال»، ويكفى أن نعرف تلميذاته اللاتى تربين فى حجره المعرفى مثل: أم محمد، دنيا، بنت زكى الدين، زينب، زمرد، ست العابدين، شرف، فاطمة، ست العيش:
«إنَّـا إنَــاثٌ لِمـا فِيـنَا يُولِّـدُه
فلنحمدِ الله مَا فِى الكونِ من رَجُلِ
إنَّ الرجَـالَ الَّذِين العرفُ عَيَّـنَهُم
هُمُ الإنَاثُ وَهُم سُؤلِى وَهُم أمَلى»
يحتفل ابن العربى - الذى هو عندى شيخ المعرفة التى هى غايته الأسمى والقصوى، وكنز الحكمة والذوق والكشف - بالأنوثة، مُتجاوزًا البُعد المادى، معبِّرًا عن ذلك بلغة جديدة هو من استولدها، حيث يعطى أهمية كبيرة للحس والخيال والقلب والذوق والحدس، بدلاً عن سيطرة العقل واستبداده.
فمن «فصوص الحِكَم» أثبت هذا المقطع، كى أوضِّح أنَّ المرأة عند ابن العربى هى رمزٌ للعلاقة مع الله، الدَّالّ على المطلق، بوصفها أنصع تجليَّات الخالق:
«فإذا الرجل مدرَج بين ذاتٍ ظَهَرَ عنها وبين امرأةٍ ظهرتْ عنه. فهو بين مؤنَّثين: تأنيث ذات وتأنيث حقيقى [...]، كآدم مذكَّر بين الذات الموجود عنها وبين حواء الموجودة عنه. [...] فكن على أى مذهب شئت، فإنك لا تجد إلا التأنيث يتقدَّم، حتى عند أصحاب العلَّة الذين جعلوا الحقَّ علَّة فى وجود العالم - والعلَّة مؤنثة».
عشق المرأة عند ابن العربى علو وارتقاءٌ، واتحادٌ بالمخلوق الأسمى، وذوبانٌ وفناءٌ فى ذات المحبوب، حيث القُرب الشديد والحُب الحارق، الذى هو تجلِّى الخالق على الأرض فى أحسن صورةٍ، وأكمل تكوينٍ.
وما الاتصال بجسد الأنثى إلا الذهاب نحو سر الألوهة، والعاشق الحق يرى جسد المرأة عبادة تُجدِّد العلاقة بالله، والحب عند ابن العربى مقامٌ إلهى، يقول ابن العربى فى الجزء الثانى من «الفتوحات المكية»:
«وليس فى العالم مخلوق أعظم قوة من المرأة لسر لا يعرفه إلا من عرف فيم وجد العالم وبأى حركة أوجده الحق تعالى».
إن «مباشرة ابن العربى للتجربة الصوفية وإدراكه أن الله حبب النساء إلى النبى محمد شكل حافزًا قويًّا لصياغة تصوُّر جديد حول المرأة، فأصبح أكثر الناس حبًّا وعطفًا على المرأة، لأنه يعتقد أن الله هو مصدر حبه للنساء».
وكم من شعوب رأيناها فى الماضى وما تزال تعبد المرأة المخلوقة بوصفها خالقة عليا:
«الحب يُنسب للإنسان والله
بنسبة ليس يدرى علمنا ما هى
الحب ذوقٌ ولا تُدرى حقيقته
أليس ذا عجب والله والله
لوازم الحب تكسونى هويتها
ثوب النقيضيْن مثل الحاضر الساهى».
يقولُ ابن العربى الذى ينصتُ دومًا إلى المرأة داخله، معتمدًا على عناصر أساسية يمكن تأويل دلالاتها على ألف وجهٍ مثل الرُّوح والنفْس والحدْس و الإلهام: «شهود الحق فى المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل، فلهذا أحب النبى عليه الصلاة والسلام النساء لكمال شهود الحق فيهن، إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد أبداً، فإن الله بالذات غنى عن العالمين، فشهود الحق فى النساء أعظم الشهود وأكمله».
إن ابن العربى هو المجلى الأكبر فى حال الوجد والاتحاد مع ذات الخالق، الذى منحه ما لم يمنح سواه من الفيض والذوق والمجاهدة والكشف والزّهد، والصمت، والحرية، والصدق، والسعى الدائم نحو الوصول إلى الحقيقة المطلقة، وغيرها من الأحوال والمقامات، بحيث صار فى مقدمة سلاطين الوجد. والوجد كما جاء فى المعجم هو «ما يصادف القلب ويَرِد عليه دون تكلُّف وتصنّع من فزع أو غمّ أو رؤية معنى من أحوال الآخرة، أو هو لهب يتأجّج من شهود عارض القلق وللوجد مراتب هي: التواجد، والوجد، والوجود وهو المرتبة العليا والأخيرة»، والوجد هو «الحُب الذى يتبعه الحُزن بسبب ما».
و«الوَاجِد» اسم من أسماء الله الحُسنى، ومعناه: الغنى المستغنى عن كلّ شىء، العالِم الذى لا يضلّ عنه شىء ولا يفوته شىء، ولا يعوزه شىء، يقول البحترى (205 - 284 هجرى / 820 - 897 ميلادية):
«يَتَخَلّى السّالى مِنَ الحُبّ بالشّغْـلِ
وَيَغلو بصَاحبِ الوَجدِ وَجدُهْ».
لقد صار الحب عند ابن عربى مذهباً وديناً:
«أديـنُ بدينِ الحــــبِ أنّى توجّـهـتْ
ركـائـبهُ، فالحبُّ ديـنى وإيـمَانى».
ولعل هذا البيت صار من أشهر أبيات ابن العربى، وكذا الشعر الصوفى والشعر العربى كله. وهو يتواشج مع بيت عمر بن الفارض الذى يرى الحبَّ ملَّتَهُ:
«وَعَنْ مَذْهَبى فى الحُبِّ مَا لى مَذهَبٌ
وَإنْ ملتُ يَومًا عَنْه فَارقتُ ملَّتى».
وقد رأى ابن العربى خوفاً وخشية من البطش به كتابه الشعرى «ترجمان الأشواق» ترجمانًا للأشواق والمواجيد الروحية.
اقرأ أيضا | بقلم مصرية يونانية : عن الصوم














