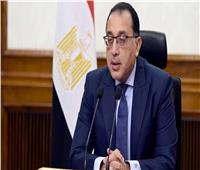يقول الحق فى سورة لقمان: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ»، خطاب الحق سبحانه لعباده بـ "يأيها الناس" يدل على أنه تعالى يريد أنْ يُسعدهم جميعاً فى الآخرة، وسبق أنْ ذكرنا الحديث القدسى الذى تقول فيه الأرض: يا رب ائذن لى أنْ أخسف بابن آدم، وقالت البحار: نغرقه... إلخ، فكان الرد من الخالق عز وجل: «دعونى وخلقي، فلو خلقتموهم لرحمتموهم، إنْ تابوا إليَّ فأنا حبيبهم، وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم».
وقوله تعالى: «اتقوا رَبَّكُمْ..» التقوى أنْ تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية تقيك وتحميك؛ فالخطاب هنا عام للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم، فالله تعالى يريد أن يُدخلهم جميعاً حيِّز الإيمان والطاعة، ويريد أنْ يعطيهم ويمنّ عليهم ويعينهم، وكأنه سبحانه يقول لهم: لا أريد لكم نِعَم الدنيا فحسب، إنما أريد أنْ أعطيكم أيضاً نعيم الآخرة.
وكذلك النبى صلى الله عليه وسلم، كان رحيماً حتى بالكافرين والمعاندين له، كما ذكرنا فى قصة اليهودى الذى اتهموه ظلماً بسرقة درع أحد المسلمين، وقد عزَّ على المسلمين أنْ يُرمى واحد منهم بالسرقة، فجعلوها عند اليهودى، وعرضوا الأمر على سيدنا رسول الله، فأداره فى رأسه: كيف يتصرف فيه؟ فأسعفه الله، وأنزل عليه: «إِنَّآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بِمَآ أَرَاكَ الله...» «النساء: 105» لا بين المؤمنين فحسب «وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً» أى: لا تخاصم لصالح الخائن، وإن كان مسلماً، فالناس جميعاً سواء أمام مسئولية الإيمان.
وفَرْق بين: اتقوا ربكم واتقوا الله؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء الألوهية، عطاء الربوبية إيجاد من عَدَم، وإمداد من عُدْم، وتربية للمؤمن وللكافر، أما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ للأوامر، فاختار هنا الرب الذى خلق وربَّى، وكأنه سبحانه يقول للناس جميعاً: من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكراً لنعمته عليكم، وإنْ كنتم قد كفرتُم بها.
ولا تنتهى المسألة عند تقوى الرب فى الدنيا، إنما «واخشوا يَوْماً لاَّ يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ..» أى: خافوا يوماً تُرجعون فيه إلى ربكم، فالمعنى هنا أن اليوم نفسه مخيف بصرف النظر عن الجزاء فيه، وفى هذا اليوم «لاَّ يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ..» خصَّ هنا الوالد والولد؛ لأنه سبحانه نصح الجميع، ثم خصَّ الوالدين فى الوصية المعروفة: «وَوَصَّيْنَا الإنسان بِوَالِدَيْهِ...».
ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال: «أَنِ اشكر لِى وَلِوَالِدَيْكَ...» فجعل لهما فضلاً ومَيْزة ومنزلة عند الله، حتى أصبحا مظنة النفع حتى يوم القيامة، فأراد سبحانه أنْ يُبينَّ لنا أن نفع الوالد لولده ينقطع فى الآخرة، فكلٌّ منهما مشغول بنفسه، فلا ينفع الإنسان حتى أقرب الناس إليه.
وهنا «لاَّ يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ..» لأن الوالد مظنّة الحنان على الولد، وحين يرى الوالد ولده يُعذَّب يريد أنْ يفديه، فقدَّم هنا (الوالد) ثم قال: «وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً..» فقدم المولود، وكان مقتضى الكلام أنْ نقول: ولا يجزى ولده عن والده، فلماذا عدل عن ولد إلى مولود؟
الكلام هنا كلام رب، وفرْق كبير بين ولد ومولود؛ لأن المسلمين الأوائل كان لهم آباء ماتوا على الكفر، فظنوا أن وصية الله بالوالدين تبيح لهم أنْ يجزوا عنهم يوم القيامة، فأنزل الله هذه الآية تبين لهؤلاء ألاَّ يطمعوا فى أنْ يدفعوا شيئاً عن آبائهم الذين ماتوا على الكفر.
لذلك لم يقل هنا ولد، إنما مولود، لأن المولود هو المباشر للوالد، والولد يقال للجد وإنْ علا فهو ولده، والجد وإنْ علا والده، فإذا كانت الشفاعة لا تُقبل من المولود لوالده المباشر له، فهى من باب أَوْلَى لا تُقبل للجدِّ؛ لذلك عَدل عن ولد إلى مولود، فالمسألة كلام رب حكيم، لا مجرد رَصْف كلام.