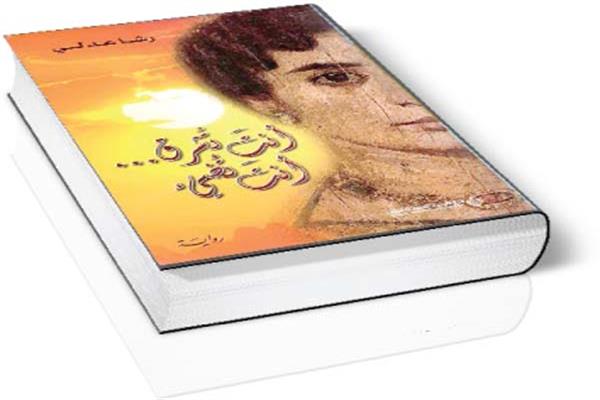بإنجازها لروايتها الأخيرة «أنت تشرق.. أنت تضيء»، والصادرة هذا العام عن الدار العربية للعلوم ناشرون، والطبعة المصرية عن دار الشروق، نستطيع أن نقول بكل ثقة إن رشا عدلى تتربع بجدارة واستحقاق تام على عرش الرواية التاريخية فى مصر فى وقتنا الراهن.
لقد تفوقت رشا على نفسها وقدمت رواية من أجمل ما تكون الروايات، فبرغم تاريخيتها التى تُحتِّم عليها تقديم وجبة دسمة من المعلومات ولغة خاصة تليق بتلك الحقبة، إلا أنها كانت من السلاسة بحيث كان التنقل بين الماضى والحاضر، بسهولة فتح باب وغلقه.
بداية، وقبل الدخول إلى المتن، أبدعت رشا فى عتبات النص مثل العنوان والغلاف، فجاءا متماشيين مع تحتويه دفتا الكتاب. فالإشراق كحالة نفسية وعضوية هى ما انتهت إليه البطلة رنيم مع آخر كلمات الرواية حينما تخففت من أثقالها التى أرهقت كاهلها بطول سنوات عمرها الثلاثين. أما الغلاف فيمثل إحدى لوحات وجوه الفيوم»، وهو للبطلة الثانية الموزاية «سيرينا»، وهى نصف لوحة لنصف وجه عثرت عليها البطلة الأولى، وطفقت فى البحث عن بقيتها، وما وراءها من حكاية.
الموضوع التاريخى الذى تجد البطلة نفسها أمامه، أو بمعنى أدق، بداخله، ثم بحثها المُضنى فى ما يُخَبىء وراءه من أسرار وحكايات مخفيَّة، هى التيمة العامة التى تنطلق منها روايات رشا عدلي، مثال هذه الرواية التى نحن بصددها، و» قطار الليل إلى تل أبيب».
و«آخر أيام الباشا»، وغيرها. وهناك كذلك القبو الذى يغرى البطلة بالنزول إليه بدافع قوة خفية ما، وهناك فى الأسفل، ومن خلال فجوة زمنية أو إسقاط نجمى أو ما شابه، تقابِل شخصيات بادت منذ مئات وآلاف السنين، وتطلع من خلالها على الكثير مما خفى واستَتَر.
بطلتنا هنا هى «رنيم» الشابة المصرية الثلاثينية التى هربت هى وأسرتها المكونة من أب وأم إلى إيطاليا بعد تقديم الأب الذى يعمل بالصحافة طلب لجوء سياسي، إثر تعرضه لتهديدات بالتصفية الجسدية فى مصر. حضرت «رنيم» إلى بلد الفنون وقد تخطت عامها الأول، فوق قارب يحمل من البشر أضعاف حمولته.
هرب الأبوان من موت لآخر، إذ عانيا فى إيطاليا الذل والفاقة والتعاسة وكل أنواع المرارات النفسية. استسلم الأبوان لظروفهما، لكنها لم تكن حالة رنيم التى أصرت على النجاح، وإن لم تنجح فى التخلص من عقدها النفسية -برغم كل ما حصلت عليه لاحقًا من تقدير معنوى ومادى وعلمي- إلا بنهاية الرواية وحينما نجحت فى القصاص لأبيها من الرجل الذى كان وراء كل ما حدث لهم.
الرواية عبارة عن قصتين: واحدة تاريخية تدور فى القرن الأول الميلادى فى الإسكندرية والفيوم، والأخرى حديثة، تدور منذ عام 1990 وحتى 2018 فى إيطاليا (نابولى وروما وفلورنسا)، ومصر (القاهرة والفيوم). وهى مكتوبة بصوت الراوى العليم وبحس سينمائى ونظرة مخرج محترف شديدة التميز والذكاء، فالفصول كُتِبَت بتقنية المونتاج المتوازي؛ فصل من القصة التاريخية، يليه آخر من القصة الحديثة.
فى القصة الحديثة، تنطلق رنيم، أمينة متحف «أوفيزي» بإيطاليا فى البحث وراء ست لوحات لوجوه الفيوم تمتاز جميعها بانحراف فى بؤبؤ العين، وهو ما تراه مقصودًا لذاته، ولتأكيد شيء ما، وليس اعتباطيًّا أو عائدًا لعدم احترافية الرسام، كما أنها تلاحظ أن من ضمنها لوحة نصفية لوجه امرأة عشرينية، فتشكُّ أيضًا فى أن هناك شخصًا ما قد قام بشقها طوليًّا.
ولكن لم؟! هذا هو السؤال الذى أثارها وقضَّ مضجعها. وبعد أن تُقابَل شكوكها باستخفاف من قِبَل لجنة الفحص، وبسبب ضخ تمويل لهذا المشروع من قِبَل شخص تعرفه، يبدأ العمل على كشف غموض تلك اللوحات. وبالفعل يُكتَشَف جزء من الحقيقة.
وعلى الأقل حتى نهاية الرواية المفتوحة على مزيد من الحقائق التى ستُكتَشَف، وكأنه وعد من الراوى بأن يزيل كل ما علق من غموض لقرون طويلة ويكشفها للعلن، كى تستريح تلك الشخصيات وتهدأ أخيرًا.
تصف لنا الرواية علاقة رنيم بأبيها مصطفى عبد المولى، والتى تحمل من الحب والتقدير والشجن والتعاطف والحزن الكثير. علاقة وطيدة وحميمة، تجعلها تلهث وراء ذلك الأمان والحنان والونس الذى افتقدته بوفاته، فترتبط عاطفيًّا بأول من تراه كفئًا لاحتلال هذا المكان الشاغر، وتكون عاطفتها موجهة لرجل يبلغ من السنوات ضعف عمرها.
يوم وفاته، يحصل الأب على الجنسية الإيطالية التى طالما سعى لها لتنقلهم من وصمة اللاجئ إلى تميُّز المواطن! تلك المفارقة تأكيد على الحظ السيئ الذى يأبى أن يفارق الأب منذ قُبيل مغادرته مصر، وحتى إقامته لآخر يوم فى عمره فى إحدى القرى النائية بإيطاليا.
من الشخصيات التى يحتفظ أمامها المتلقى بحياديته التامة وبمشاعر حذرة، تفتقد للتدفق والحرارة: شخصية والدة رنيم، وكذلك حبيب رنيم، رجل الأعمال اللبنانى يَزَن. فبرودة الشخصيتين قد لا تولِّد أى عاطفة نحوهما، برغم أن الأولى قد ضَحَّت بشكل ما فى سبيل ابنتها.
وأن الثانى قد دعَّم المشروع الذى تعمل به رنيم. لكن يظل بداخل القارىء شكوك تحوم حول دوافعهما الحقيقية، مثل أن الأم لم تضحِ بالمعنى الحرفى للكلمة، بل تعايشت مع ما فُرِضَ عليها، وكان التذمر المكتوم هو رد فعلها الذى لم تتخل عنه طيلة حياتها، بجانب كراهيتها وازدرائها الواضح للأب، وفشلها التام فى احتواء ابنتها، أما يَزَن فتبرعه للمشروع لم يكن بدافع عاطفة ما تجاه رنيم، ولكن لأنه يعلم جيدًا بحكم عمله وخبرته فى المجال، أن ما فعله سوف يدر عليه أضعاف ما دفعه.
وكما برعت رشا عدلى فى رسم باقى شخصيات الرواية، فقد وُفِّقَت تمامًا فى رسمهما؛ إذ إن الشخصيات التى نحمل باتجاهها عاطفة الحب أو الكره، تكون الكتابة عنها أكثر سهولة ويسر نظرًا لوضوحها، أكثر من تلك الشخصيات المُلتَبِسة فى كل شيء: عاطفتها، مشاعرها، مقصدها، والتى من الصعب الوقوف على حقيقة كينونتها، وما تحب وتكره، بل ما تشعر به من الأساس!
أما عن القصة الثانية، فهى تحكى عن سيرينا المنحدرة من أب إغريقي، وأم مصرية، والتى تتزوج من نائب الإمبراطور وحاكم الإسكندرية الروماني، والتى رغم إعجابها به قبل زواجهما، إلا أنها تكتشف لاحقًا شخصيته الظالمة، المتسلطة، الشرهه للسلطة والتى تفتقر معها للاحتواء والحنان، فتقرر الثورة عليه، وحينها يقرر الانتقام منها بوضع سم لها هى وزملائها فى الطعام، يكون من شأنه التأثير على بؤبؤ العين وانحرافه، ثم الجنون والموت.
الحكاية التاريخية أتت لتؤكد على الثقافة السينمائية للكاتبة، إذ تستحيل الحروف والعبارات أمام القارىء لمشاهد سينمائية لفيلم باذخ التكاليف، باذخ الدقة فيما يخص الملابس والديكور والأكسسوار والمجاميع.
كانت رؤية ما هو مجهول بالنسبة إلينا الآن، والذى كان حاضرًا واقعًا فى زمن مضى عليه عشرون قرنًا بمثابة من يكتشف مخبأ أو دفينة تاريخية تحوى كنوزًا لا حصر لها. فرأينا فى حقبة ومكان واحد تزاوُج ثلاثة من أهم الحضارات دفعة واحدة: المصرية والإغريقية والرومانية، وكذلك فروق الملبس، وفروق الدين لكل من ينتمى لإحداها.
وأولئك الذين ينحدرون من تزاوج الحضارة المصرية والإغريقية، والذى يُطلَق عليهم المتأغرقين، وهم ينتمون عاطفيًّا وتاريخيًّا ودينيًّا للمصريين والإغريق، ويكنون كراهية للمحتلين الجدد من الرومان.
تصور الرواية مصر على أنها -فى ذاك الوقت البعيد- كانت سلة الغلال للإمبراطورية الرومانية، واستبداد ودموية تلك الإمبراطورية التى فرضت الضرائب الباهظة على الشعب المصري. وكيف كانت هناك حرية دينية ملحوظة فى ذلك الوقت تحديدًا.
وقبل فرض الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية على كل أراضيها، فكانت الوثنية بآلهتها المختلفة والمتعددة والمنتمية للحضارات الثلاثة هى السائدة؛ من إيزيس وحورس وآمون ورع وسوبك وديونيسوس وسين، ..الخ.
فى جانب ما، نجد أن «سيرينا» هى رنيم، فالاثنتان ارتبطتا برجلين عمليين من الطراز الأول، غامضين أقصى درجات الغموض، أيضًا الأولى تستعيد ذاتها الأصيلة حينما تقرر الثورة على زوجها وحكمه الجائر وتقف فى صف من تنتمى إليهم، حتى لو كان الثمن المسفوح روحها، والثانية تتخلص مما علق بها من عار حملِها للقب «لاجئة»، وأب هارب من شيء لا تعلمه، وَصَمَات لا ذنب لها فيها تُكبِّل روحها وسعادتها.
ويحسب للروائية عدم وقوعها فى فخ نهايات أفلام الأبيض والأسود السعيدة، وما يطلبه القراء، إذ لم تجعل بطلتها تتوجه بمشاعرها فى نهاية الرواية نحو منتصر، وذلك بعد أن تخلصت مشاعرها من حب «يَزَن» المرهِق وعلاقتهما الملتبسة، على الرغم من شباب وحيوية وروعة شخصية منتصر ومشاعره الواضحة تجاهها، فمكسبها كان رنيم ذاتها، رنيم القوية التى تخلصت من كل مشاكلها ومخاوفها وعقدها دفعة واحدة، والتى تستطيع مواجهة العالم منفردة، مكتملة، لا تشعر بنقص أو حاجة للاكتمال.
وأخيرًا أقول، إن لم تقدم رشا عدلى فى مشوارها الأدبى كله سوى هذه الرواية، فتكفيها وتفيض، لأنها بحق رواية ستُخَلِّد اسمها فى سجل الأدب الحقيقى الجاد والعابر للأزمان.
اقرأ ايضا | مدير مكتبة الإسكندرية يكتب: المنظومة الثقافية فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر