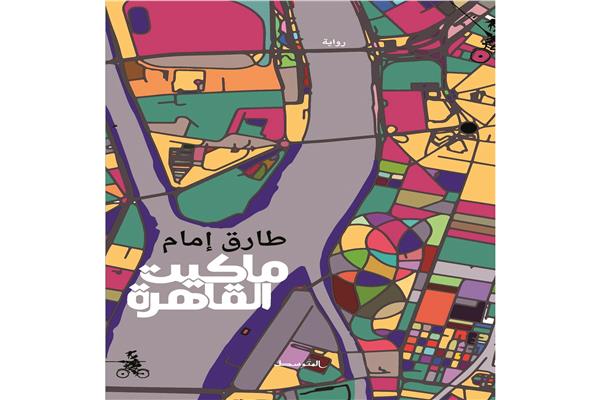«ماذا تعنى النجاة إذا اختفى ما ننجو منه!» لا أبشركم بنهاية صادمة أو نهاية سعيدة. أصلاً لم تعد النهاية مهمة. هذا ما بنى عليه الكاتب فلسفته فى هذا العمل، نعم لم تعد النهاية مهمة بقدر تلك التفاصيل التى تختلف فى كل مرة تحكى فيها نُود بطلة الرواية الحدوتة لطفلها أوريجا درجة أنه لم يعد يهتم بالقفلة أو النهاية، صار مولعاً بالتفاصيل حتى يغلبه النوم. أصبحت الرواية هى تكرار وإعادة إنتاج الحكاية دون الوصول إلى النهاية.
وهذا بالضبط ما رسمه قسطنطين كفافيس فى قصيدته (إيثاكا) التى تنادى بقيمة الرحلة فى حد ذاتها بعيداً عن الوصول إلى إيثاكا أو الكنز، لأن الرحلة نفسها وما يمر به من تفاصيل ومغامرات هى الكنز الحقيقى أو هى إيثاكا الحقيقية، والمحصلة الحكمة والخبرة والشقاء والسعادة.
يصنع طارق إمام كتاباً يحاصر فيه القارىء؛ ليجعل من روايته المصدر والشلال، المنبع والرافد فى وقت واحد، فلا شخوص حقيقية بأسمائها بيننا، ولا خبرة بحياة أخرى، الشخوص كلها هنا والحياة وجدت منذ أول كلمة فى الكتاب كأنه أول الخلق، لا مرجعية سوى تلك الكلمات التى بين يديك؛ فلا يستشهد بأى كلمة مأثورة أو حكمة لكاتب آخر، هو يصنع فى روايته الكلمة المأثورة والحكمة الخاصة به ويصنع أيضاً الكاتب الآخر، يصنع النموذج والمثال المقتدَى به، ويضيف من عنده أسماء لم تولد بعد: خورخى خالد، كارلوس عبدالسميع، ليونيل مرسى، هيلارى خميس وهكذا... الكتاب مغلق على قارئه أو بمعنى أصح نجح طارق إمام فى فصل القارىء عن العالم الخارجي؛ من يدخل حقاً - أقصد بـ (حقاً) التركيز الشديد- من يدخل حقاً كتاب ماكيت القاهرة لن يخرج إلا بجرح أو على الأقل بسؤال وجودى مهم؛ كل فرد حسب ما قرأ، لأن القارى هنا أصبح شخصية فاعلة فى الكتاب نفسه، أصبح داخل الماكيت سواء شاء أم لم يشأ. محور العمل فى الرواية يرتكز على صناعة ماكيت مصغر للقاهرة الجديدة، وأثناء صناعة الماكيت يتم سرد الأحداث بزوايا مختلفة كل مرة بزاوية تضيف بُعداً آخر حتى تكتمل الضفيرة المثلى التى تعبّر عن مهارة الكاتب وتقنيته فى بنية السرد الروائى، زوايا مختلفة لمشهد واحد إلى أن تكتمل الصورة النهائية،
وهذا يشبه ما فعله إمبرتو إيكو أحياناً فى كتابه المهم (اسم الوردة) مع فارق أن إمبرتو إيكو كان يستخدم روايتين متناقضتين لمشهد واحد، بمعنى أن كل رواية ترى بشكل مختلف تماماً بل متناقض، أو بالأحرى كل رواية تكذّب الرواية الأخرى.
وعلى القارئ أن يختار أو يقع فى حيرة بينهما أيهما يصدق؟ بينما عند طارق إمام الوضع مختلف لا أحد يكذب، المشهد واحد لكن من زوايا مختلفة حتى تكتمل آخر لبنة فى البناء السردى، وفى كل إعادة إضافة لقطعة من البازل حتى تكتمل اللوحة تماماً ويصل إلى البيت الذى بالطبع لم يعد موجوداً: «اختفت القاهرة».
التقنية التى استخدمها الكاتب مروراً بالقفز إلى سنة 2045 ثم العودة إلى 2020 ثم العودة إلى 2011 ثم القفز إلى 2045 وهكذا دواليك على حسب البنية السردية ومن خلال الفانتازيا التى استمرت من أول كلمة فى الكتاب إلى آخر كلمة طوال 400 صفحة، لم ينزل إلى أرض الواقع مرة واحدة، كان خيالاً محضاً بدءاً من إطلاق رصاصة من الإصبع حتى آخر مشهد عندما تنظر البطلة فى المرآة ولا ترى وجهها وإنما وجه شخص آخر، إلا أنه فى نهاية هذا الميتا-سرد، أو فى نهاية ما وراء الحكاية يشعر القارئ بالواقع أقوى من صفعة قوية على وجهه مما يضطره أن يسأل فى حيرة: أين نحن! وفى أى عام الآن! ما أوقفنى حقاً هو المجهود والمشقة التى بذلها الكاتب ليخرج هذا العمل بهذه الطريقة، كأنه أعاد الترتيب والشطب عشرات المرات حتى لا تسقط منه تفصيلة واحدة، أو كأنه صنع الماكيت على الحقيقة أولاً فى بيته وعلى سريره وأجرى قناة صغيرة من الماء فى أرضية حجرته كى يجسم النيل، صنع الماكيت فى نومه ويقظته قطعة قطعة ومع كل قطعة كان يعيد النظر إلى البناء العام مرة أخرى، هذه التقنية المفرطة والحرص الشديد أفقدته بُعداً إنسانياً مهماً وضرورياً؛ فقد اهتم بالماكيت أكثر من اهتمامه بمن يعيش داخل الماكيت، اهتم طارق بالنظام أكثر من اهتمامه بالإنسان، ولا أعرف ربما كان هذا مقصوداً فى هذه المدينة الكافرة، حيث لا يشعر أحد بأحد، وحيث أصبح كل شىء ملوثاً وتافهاً وصولاً إلى محاكمة الخيال وحبس الأمل، حتى وصل الأمر إلى إدانتهما، والحكم عليهما بالعقوبة، ربما! كل تفصيلة ولو صغيرة فى الكتاب لها ما يبررها من خلال السياق، سيظهر ذلك -إن آجلاً أو عاجلاً- من خلال الزوايا الأخرى التى تشير إلى ما سبق أو إلى ما هو آتٍ.
أما الشخصيات فهى محدودة جداً؛ الطفل أوريجا، الأم نود، والأب بلياردو، والمسز المسيطرة، ومانجا فنانة الكاريكاتير، ثم الراوى الذى لا يشعر به القارئ مطلقاً كأنه لم يكن هناك من يسرد الأحداث أو كأنها تسير بشكل طبيعى وسلس دون حاجة لمن ينقل الكلام، أو كأن الراوى خفى وغير مرئى، وهذا نجاح للكاتب بالطبع فى بنية الجملة وانتقال الخطاب دون حجرعثرة يقبع وسط الحوار.
يتبقى من الشخصيات شخصية فريدة فى نوعها، وهى لا تقول كلمة واحدة، لا تنطق ولا تتحرك وليس لها وجود حسى داخل العمل، ألا وهى القارئ؛ القارئ الفرد الذات -لا أقصد جمهور القراء- هو أحد شخوص الكتاب المهمة بما سيخرج به من أسئلة أو ما سيضيفه من دلالة حتى وإن لم يكن يقصدها المؤلف؛ لأن النص فى هذا العمل مفتوح على مصراعيه.
وقابل للتأويل وقابل حتى لسوء الفهم، وحينما يستخدم الكاتب الحوار الجدلى المتصاعد بين هذه الشخصيات يضع فيه كل ما يملكه من وعى وثقافة متنوعة دون الاتكاء على شىء من خارج الرواية، بمعنى أصح عزَلَ القارىء تماماً وأغلق عليه الكتاب «حتى تلك الأشياء الأكثر زيفاً تُصنع من مادة الحقيقة».
تُظهر اللغة طبعاً فى جانب كبير منها شعرية وليست شاعرية، أقصد ليست لغة رومانسية أو حالمة؛ وإنما هى لغة شعرية تعتمد على التصوير وتستخدم تقنيات قصيدة النثر من استغراق الصورة والتعامل الرأسى معها غوصاً فى عمق دلالتها؛ لذا يظهر النص مفتوحاً بالكامل، قابلاً للقراءة الفردية المتنوعة والمختلفة من شخص لآخر، أو إن صح التعبير أشبه ما تكون بقصيدة نثر ضخمة تبدو كناطحة سحاب عملاقة، تستطيع أن تفهم ما تريده أو أن تكتشف شيئاً مهماً حتى الكاتب نفسه لم يكن يدركه. «ظلّا يكبران معاً، هى فى الواقع، وهو فى الزجاج».
كل شىء هامشى خارج عالم الرواية رغم وجوده، فهناك تلميحات سياسية فى اختيار عام 2011 وثورة يناير، فقء العيون، السور الحجرى فى شارع محمد محمود، رسوم الجرافيك الثورية، المطاردات، وصولاً إلى المعادل الموضوعى لماكيت القاهرة وهو العاصمة الجديدة، حتى الدين -كما نعرفه- لم يكن موجوداً طوال الوقت، لم يكن هناك جنة ولا نار ولا إله ولا خوف من عقاب سماوى، ربما كان هناك إيمان بديلاً عن الدين، وإن كان إيمانا بالحرية أو اللاسلطة -إن أمكن- كذلك الجنس لم تكن هناك علاقة حقيقية متبادلة بقدر ما كانت رغبة ساذجة، مختلسة وخاطفة مع المانيكان أو مع رجل الزجاج، صحيح لقد كان الجنس موجوداً بشكل هامشى بينما -وهو الأهم- اختفى الحب تماماً، السياسة والدين والجنس كلهم هنا هامشيون إلا شيئا واحدا هو النظام ومقاومة النظام، أو المسز ومحاولة التخلص منها، وأيضاً الفشل الذريع فى النجاة، لكن كل هذا لا يتوقف عنده الكاتب بشكل مباشر ولا حتى يتخذ منه موقفاً سياسياً أو فكرياً مع أو ضد، ولكنه يعرض به، يمر عليه مرور الكرام كعابر فى قطار وعلى القارىء أن يشارك بما استطاع أن يخرج به من هذا العالم الغرائبى.
أما كتاب منسى عجرم أو كما سميته أنا كتاب الأقدار أو الكتاب المقدس الذى يتحكم فى مصائر الناس، يميت ويحيى، هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن -إن أردت- أو حتى الزبور ومزامير داوود، أو -إن شئت- هو الدستور مصنع القوانين، أو حتى هو كتابك الأدبى المفضل الذى ترى فيه نفسك، وتعرف مصيرك إن اتبعت تعاليمه أو -بمعنى أدق- تعليماته، والذى دائماً تستخدمه السلطة أو الإدارة أو النظام للتحكم فى مصائر الناس.
وبث الخوف فى قلوبهم كمضاد حيوى يستخدم ضد الحرية وإجهاض كل فكرة مقاومة للخنوع. لذا يظل هاجس طارق إمام وسعيه الدؤوب هو الحرية والبحث عن اللاسلطة، التخلص من التعاليم والتعليمات على حد سواء، حتى التخلص من شكل الرواية المعترف به التقليدى والنمطى، التخلص من النهاية التقليدية أيضاً والعقدة والحل والشكل المتفق عليه للرواية، التخلص حتى من الأسماء التى ورثناها وحمّلتنا إرثها بلا ذنب اقترفناه أو فضيلة اكتسبناها، لا مدح ولا ذم.
من هنا جاءت أسماء لا علاقة لها بالمنطق الآنى: هيلارى خميس، كارلوس عبدالسميع، خورخى خالد، منسى عجرم، زيد الدين زيدان، أوريجا، أو حتى بلياردو الذى كان حراً فقط فى اللحظة التى اختار فيها هو اسمه: «لقد اختفت القاهرة وأصبحت مدينة تتنزه فيها الريح.»
يتبقى أخيراً السؤال الوجودى الأهم والأعظم -فى نظري- على الإطلاق والذى وضعه طارق إمام فيما وراء القص أو خلف باب الحكاية: أين نحن؟ فى الداخل أم فى الخارج؟ هل نحن داخل ماكيت مصنوع بدقة ومهارة عالية جداً حيث لا نستطيع سوى ما هو مقدر لنا، ولا يمكن أن نكتشف ذلك فنعيش حياتنا مخدوعين كأننا الوحيدون على الأرض.
بينما فى الحقيقة هناك عمالقة يتحكمون فى حيواتنا، وبإصبعين فقط يمكن التقاطنا مثل حبات عنب سهلة الدهس والدعس، بلا حول منا ولا قوة؟ أم أننا نحن العماليق وتحت أرجلنا ماكيت مصغر جداً لا نشعر به ولا نراه كما فى بيوت ومستعمرات النمل؟ أين نحن؟! أو من نحن؟!
اقرأ ايضا | «ماذا تعنى النجاة إذا اختفى ما ننجو منه!»